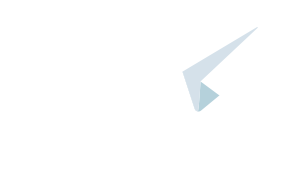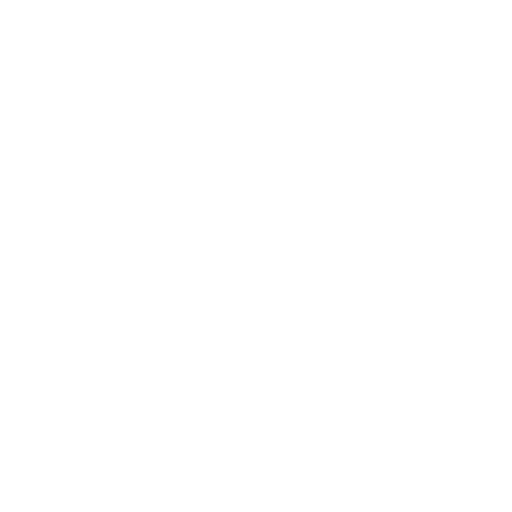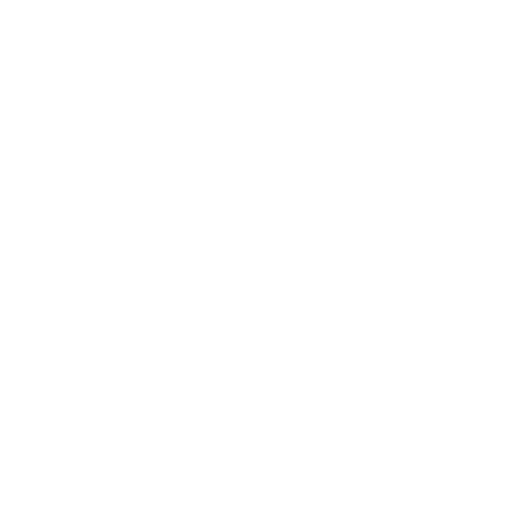الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
الورع.
المؤلف:
محمد حسن بن معصوم القزويني.
المصدر:
كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء.
الجزء والصفحة:
ص 254 ـ 266.
2024-02-22
2402
للورع معنيان:
أحدهما: الكفّ عن المعاصي بأسرها، وهو من فضائل القوتين معاً، ولا حاجة إلى ذكره على حدة، إذ بعد الاطلّاع على ذمّ كلّ معصية ومدح تركها يعلم كونه من أعظم المنجيات والفضائل، بل هو المقصود في علم الأخلاق بالنسبة إلى العامة.
وثانيهما: ملكة الاجتناب عن المال الحرام، وما يمكن أن يؤدى إليه، وهو من فضائل القوّة الشهويّة، وهو المقصود بالذكر هنا، ولما كان لطبّ النفوس تأسّ بطبّ الأبدان كما أشير إليه مراراً، فكما أنّ الطبيب يحكم على الحلو كلياً بالحرارة، ثم يجعل للحارّ أنواعاً على درجاتها في الشدّة والضعف، فكذا نحكم على كل حلال بالطيب، وكلّ حرام بالخباثة، الا أنّهما على درجات فيهما.
ولما كان حصر مراتب الحرارة من الطبيب في أربع على سبيل التقريب، فكذا نقتدي به في حصر درجات الورع في أربع تقريباً؛ لأنّ في أفراد كل منها تفاوتاً لا ينحصر.
فنقول:
أوّل درجة ورع العدول، أي: الاجتناب عمّا ينافي العدالة ويوجب الفسق في ظاهر الشريعة، ممّا هي مبسوطة في الكتب الفقهيّة فروعاً وشقوقاً وأدلّة، وفيها تفاوت عظيم، فإنّ المغصوب قهراً أغلظ من المكتسب بالمعاملة الفاسدة تراضياً، ثم المغصوب من اليتيم قهراً أغلظ من غيره ومن الفقير أغلظ من الغني، ومن العالم أغلظ من غيره وهكذا، ولولا اختلاف درجات المعاصي لما كان لاختلاف دركات النيران معنى.
وثانيها: ورع الصلحاء، أعني التوقّي عن الشبهات التي يأتي فيها الاحتمالات بحيث لا يجب اجتنابها، وسيجيئ ما يجب اجتنابه منها، فتلحق بالحرام.
قال صلى الله عليه وآله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1).
وقال صلى الله عليه وآله: «خذ بالحائطة لدينك» (2).
ومرجعه إلى الورع عن الحرام أيضاً؛ لأنّ من الحرام حراماً بيّناً وحراماً مشتبهاً بالحلال ، ولكلّ منهما مراتب شدّة وضعفاً ، وقد أشرنا إلى الأول وكذا الثاني ، فإنّ الشبهة في النكاح سيّما إذا دارت المرأة بين الزوجة والبنت أو الأخت مثلاً أشدّ من غيرها ، فكلّما قوي احتمال الحرمة فيها كان أشدّ ، لكن لا مجرد الاحتمال غير المستند إلى دلالة فإنّه كالعدم ، والورع فيه وسواس كالممتنع من أكل الصيد لاحتمال أن تزلق من يد الصيّاد بعد وقوعه في يده (3) ، أو مستعير دار غاب المعير عنها فيخرج المستعير عنها ويقول لعلّه مات وانتقلت إلى الوارث ، فإنّ الشبهة المحذورة إنما تنشأ من الشكّ ، أعني تقابل اعتقادين ناشئين من سببين ، فما لا سبب له لا ينعقد في النفس حتّى يساوي الآخر ، فلا عبرة به كما أنّ من سئل عن صلاة الظهر التي صلاّها قبل هذا بعدّة سنين كانت ثلاثاً، لم يتحقق قطعاً أنّها أربع، فلعلها كانت ثلاثاً، لكنّه لا يكون شكاً بين الثلاث والأربع لعدم استناده إلى سبب، فمثل هذا النمط لا يعد من الشبهات (4)، بل الشبهة ما اشتبه على المكلف أمره بتعارض اعتقادين صدرا من سببين مقتضيين ومنشأه أربعة:
أحدها: الشك في سبب الحلّ والحرمة سواء كانت الحرمة معلومة قبل ثم وقع الشكّ في المحلّل ، كمن رمى صيداً فجرحه ثم وقع في الماء ثم صادفه ميتاً ، فلا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح ، فيجب الاجتناب عنه في ظاهر الشرع ، عملاً بالاستصحاب ، أو بالعكس ، كالماء الطاهر المشكوك في وقوع نجاسة فيه وإن جاز التهجّم فيه في ظاهر الشرع ، لكن تركه من الورع ، أو يظنّ بالمحلّل ظنّاً مستنداً إلى دليل شرعي كحلية صيد رماه فغاب ثم أدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى سهمه فهو كحلّية الجنين بذبح أمّه ، ولعلّه مات قبل الذبح أو لم ينفخ فيه الروح ، أو بالعكس فيجب الاجتناب ، وإن استند إلى القرائن (5) تأكّد فيه الورع ، وإن لم يوجب تركه الفسق.
الثاني : اختلاط الحلال بالحرام بحيث لا يتميّز عن الآخر ، وقد ذهب بعض المحقّقين إلى التفصيل بين المحصور ، فأوجب فيه الاجتناب نظراً إلى وجوب المقدمة ، وأنّ الحكم بحلية المجموع يستلزم الحكم بحلّية الحرام اليقيني ، وغير ذلك من الأصول المفصّلة في محلّها ، وغير المحصور فلم يوجب بل جعل الاحتياط فيه مهما أمكن من الورع نظراً إلى لزوم العسر والحرج وغير ذلك ممّا فصّل في محلّه ، والنصوص في الإناءين والثوبين المشتبهين يعضده ، ولكنّ الأخبار في خصوص موارد المحصور متّفقة المقالة واضحة الدلالة على حلّية المجموع ، وتفصيل الكلام يطلب من محلّه ، فالورع في المحصور آكد (6).
الثالث: اتّصال السبب الموجب للحلّ بمحرّم لا يقتضي فساد العقد ولا إبطاله.
إمّا في مقارناته كالبيع وقت النداء في يوم الجمعة والمذبوح بالسكّين المغصوب وفي تسميته شبهة نوع تسامح لكون الحلّ والعصيان معلومين، فلا شبهة ولعلّه لكراهته، والمكروه يشبه المحرّم.
أو لواحقه كبيع العنب من الخمّار وغيره ممّا يفضي إلى المعصية وفيه خلاف بين الأصحاب، والأخبار مختلفة، والتفصيل يطلب من محلّه فالورع على القول بالحلّ والجواز آكد.
أو مقدّماته كالأكل من شاة معلوفة بالحرام أو مرعيّة في مرعى حرام، وقد اهتمّ السلف في مراعاة الورع في هذا النمط ويظهر من الأخبار شدّة الاهتمام بشأنه أيضاً.
وفيه مراتب أشدّها ما بقي أثره في المتناول أو في عوضه كالمبتاع في الذمّة المؤدّى ثمنها من غصب أو حرام وله أيضاً درجات يشتدّ في بعضها، والورع في كلّها مهمّ.
الرابع: تعارض الأدلّة المقتضية للحلّ أو الحرمة من الأدلة الشرعية، كتعارض نصّين أو عمومين وغيرهما، فإن لم يتمكّن من الاجتهاد أو من الترجيح كان الورع واجباً، وإن رجّح ما يخالفه تأكّد فيه الورع.
وله أيضاً درجات شتّى مثل ما يقوى فيه دليل المخالف وفي الترجيح دقّة وغموض، وما يتاخم الوسواس كالزبيب المطبوخ في الطعام خوفاً من كونه عصيراً محرّماً، أو الامارات المتعارضة كخبر عدل بالحرمة والآخر بالحلّ أو فاسقين بهما وهذا ممّا يستحسن فيه الورع، وله أيضاً درجات في الشدّة والضعف.
أو الاشتباه في الصفات التي بها يناط الحكم كأن يوصى لفقهاء البلد فيعلم أنّ المتبحّر في الفقه داخل فيه ، والمبتدي المشتغل بالتعلّم منذ يوم أو شهر لا يدخل فيه ، وبينهما درجات لا تحصى ، فيقع الشكّ في بعضها والورع في الاجتناب ، ولعلّه أغمض مثارات الشبهة ؛ لأنّ بينها صوراً يتحيّر المفتي تحيّراً لازماً لا محيص له عند فيها ، إذ يكون المتّصف بالصفة في درجة متوسّطة بين المتقابلين لا يظهر ميله عن أحدهما إلى الآخر ، وكذا الصدقات المصروفة إلى المحتاجين فمن لا شيء له محتاج يقيناً ، ومن له مال كثير غني كذلك ، ومن له بعض الأثاث والأشياء من الثياب الدار والكتب وغيرها يستشكل فيه، فإنّ قدر الحاجة لا يمنع وهو غير محدود، وإنّما يدرك تقريباً ويتعدّى منه النظر إلى سعة الدار وقيمتها وكونها في محلّ مرغوب وحصول الاكتفاء بما دونها، وكذا الأثاث والكتب.
وتعظم الحاجة إلى هذا الفن من الورع في الوصايا والأوقاف، فهذه مثارات الشبهة ولو اجتمعت على واحد كانت أغلظ، فأوّل درجة نافعة من الورع في الآخرة هذه، أعني ترك الشبهات بأسرها، فإنّ الحرام المشتبه وإن حلّ في ظاهر الشرع لكن لا يرتفع عنه خاصيّة الحرمة، كما لا يرتفع أثر السكر من الخمر بحلّيتها من عدم العلم بها، ولا يخلص من إهلاك الطعام المسموم بأكله مع الجهل به؛ ولذا قال صلى الله عليه وآله: «فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم» (7).
ومن خواصّه انه يورث قسوة في القلب لا يبالي معها عن الحرام البينّ ولا برهان عليه أقوى من التجربة والعيان، فإنّ أغلب علماء السوء إنّما نشأ تهتّكهم وفساد أعمالهم من أخذ الشبهات من عطايا الحكّام وجوائزهم وهدايا الرعايا المشابهة للرشى.
ولذا قال صلى الله عليه وآله : «سيأتي علي الناس زمان يستحلّ فيه السحت بالهديّة» (8) مع كون أموال الرعية بأسرها من جنس الشبهات لقلّة معرفتهم بالأحكام الشرعيّة ، وشدّة حرصهم في اقتنائها من دون تعمّق في وجوه حرمتها وحلّها ووصول الأيدي الخبيثة العادية إلى جلّها بل كلّها بحيث لا يمكن الآن القطع بحلية الأقوات ، لكون المياه والأراضي مغصوبة ، ولا بحلية اللحوم والدسوم لكون المواشي والحيوانات منهوبة ، وهذه نار استطار شررها في البلاد ، وعمّ ضررها بين العباد ، فأكثروا بسببها من الفسق والفجور وقست قلوبهم وغرّهم بالله الغرور ، واجترؤوا على هتك ناموس الشريعة وسلطت أيدي الفجّار والظلمة على الرعية، ولم يبق أحد الا وقد ابتلي بأنواع المهالك الدنيويّة والأخروية، لأجل صعوبة المدخل الحلال الذي لا يتطرق إليه شائبة شبهة ورد في الأخبار ما ورد.
ففيها قال تعالى: «يابن آدم اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس» (9).
وفيها: «من طلب الدنيا حلالاً في عفاف كان في درجة الشهداء» (10).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: «من أكل الحلال أربعين يوماً نوّر الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» (11).
وطلب بعض منه صلى الله عليه وآله أن يصير مستجاب الدعوة فقال صلى الله عليه وآله: «أطب طعمتك يستجب دعوتك» (12).
ولو كان المراد من الحلال هذا الذي نحكم بحلّيته ظاهراً لكان آكله مستجاب الدعوة وانفتح من قلبه ينابيع الحكمة، ونحن ما نرى في هذا الزمان منه أثراً سوى قسوة القلب والشقاوة.
فإن قلت: ما دلّت الأدلة القطعية كالسنّة والاجماع على حلية مثل عطايا الحكام وجوائزهم والهدايا التي وغير ذلك يكون حلالاً بيّناً، فكيف تطلق عليه لفظ الشبهة مع ما ذكرت من أنّه لا بدّ فيها من الشكّ، ولا شكّ مع وجود الدليل القطعي، كما لا يخفى.
قلت: نعم، لكن حليتها قطعاً إنّما هي بحسب الظاهر، لا في نفس الأمر، فإنّ المال المأخوذ غصباً في نفس الأمر غير المعلوم ظاهراً كيف نحكم بكونه حلالاً بيّناً في نفس الأمر، كما أنّه لا معنى لحلية الخمر غير المعلوم أنّه خمر في نفس الأمر، وإن كان بحسب الظاهر حلالاً، فإنّ قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين تستلزم إناطة الأحكام بهما، فالقبيح بالذات كيف يصير بالشك حسناً، وكذا العكس، ومعنى كونه في الظاهر حلالاً أنّ الأصل عدم كون هذا الفرد الخارجي خمراً أو مغصوباً مثلاً لا أنّه مع فرض الخمريّة والغصبيّة حلال، وقد بيّنا لك أنّ أثر الحرام لا ينفك عنه بصيرورته في الظاهر حلالاً، فقد تبيّن أنّ الاشتباه إنّما هو في كون هذا الفرد الخارجي من أفراد الحرام الواقعي أو الحلال الواقعي، ولذا تطلق عليه الشبهة في الموضوع.
ولو كانت الحلية الظاهريّة المنوطة بالظن كافية في إخراجه عن حدّ الشبهة لم يحصل مصداق للشبهة أصلاً، فإنّ كلّ ما لم يتحقّق كونه حراماً فالأصل حليته في ظاهر الشريعة، الا ما ثبتت حرمته قبل الشكّ فتستصحب، فلا يبقى وجه لتثليث الأحكام، فافهم فإنّه من مزالق الأقدام، هذا مع أنّ في كثير من المواضع يشتبه على الانسان من طرف النفس الحرام المحض البيّن ، كما في أغلب ما تعارف إطلاق الهدية عليه ، فإنّه بعد التأمل يعرف كونه رشوة محرّمة ، وإنّما هو تلبيس من الشيطان وانخداع من النفس ينكشف بعد سلب الأغراض الشهويّة ، فإنّ باذل المال لا يبذل ماله الا لغرض إمّا الثواب في الآجل أو جزاء في العاجل إمّا بتوقّع مال أو إعانة في فعل معيّن ، أو تقرّب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبّة إمّا للمحبّة في عينها أو للتوصّل بها إلى عوض ورائها ، وكلّ ذلك على درجات يحرم الأخذ في أكثرها ، ويتشكّل الأمر في القليل منها ويحل في الأقلّ، فلا بدّ من التفصيل في ذلك.
فنقول: أمّا الثواب في الآخرة فإنّما يتصوّر بأن يكون المصروف إليه محتاجاً أو عالماً أو منتسباً بنسب ديني أو صالحاً متديّناً.
والأوّل لا يحل له الأخذ الا مع علمه باتّصافه به.
وكذا الثاني، الا أن يكون في العلم على الحدّ المعلوم للمعطي من الكمال الذي تخيّله فيه حتّى صار باعثاً له على التقرّب.
والثالث إن كان كاذباً أو شاكّاً في نسبه لم يحلّ له أخذه، وقلّ ما يوجد من لو كشف من باطنه بقيت القلوب مائلة إليه، وإنّما حبّب الخلق إلى الخلق سترًا لله تعالى عنهم، والتقوى خفيّ ليس كالعلم والفقر والنسب.
وأمّا قصد المال كالفقير يهدي إلى الغني طمعاً فهو حلال مع تحقّق المطموع فيه، والأخبار دالّة عليه أيضاً.
وأمّا الاعانة بالفعل المعيّن كالمهدي إلى خاصّة السلطان لغرض معيّن إن (فإن ظ) كان المقصود منه حراماً كالحكومة والظلم وغيرهما حرم الأخذ.
وإن كان واجباً كدفع ظلم متعيّن على القادر عليه أو أداء شهادة فكذلك وهي الرشوة بعينها، كالقاضي يأخذ الرشوة على الحكم بالحقّ لصاحبه.
وإن كان مباحاً جاز الأخذ وكان كالجعالة كالوكيل للخصومة بين يدي القاضي إن لم يسع في حرام.
وإن كان المقصود يحصل بكلمة لا تعب فيها لكن من ذي الجاه، حتّى تفيد، كقول الوزير لبوّاب السلطان لا تمنعه عن الدخول، فقيل: إنّه حرام؛ لأنّه عوض عن الجاه، ولم يثبت جوازه في الشرع (13).
قال: ونحوه أخذ الطبيب العوض على تعليم دواء ينفرد بمعرفته، فإن عمله في التلفّظ غير متقوّم كحبة من سمسم فلا يجوز العوض عليه، ولا على علمه لعدم انتقاله منه إلى الغير، وإنّما يحصل له مثله. أقول: وفيه نظر.
وإن كان طلب المحبّة في عينها (14) طلباً للتودّد والاستئناس فهو مقصود للعقلاء مستحبّ شرعاً.
فعن أميرالمؤمنين عليه السلام: «لأنّ أهدي إلى أخي المسلم هديّة أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها» (15).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: «تهادوا تحابّوا تذهب بالضغائن» (16).
فهذه هي الهدية المحلّلة.
وإن كان طلب المحبّة لا للأنس من حيث هو أنس بل ليتوصّل إلى أغراض غير محصورة النوع، وإن انحصر جنسها ولولا جاهه لما أهدى إليه، فإن كان جاهه لعلم أو نسب فهو وإن جاز وكان أخفّ، لكنّه مكروه لمشابهته بالرشوة، فالورع في مثله ممدوح، وإن كان لولاية تولّاها من قضاء وولاية صدقات أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانيّة فهو رشوة في صورة الهدية، والأخبار صريحة في المنع عنه.
ففي الخبر: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث والياً إلى صدقات الأزد، فلمّا جاء أمسك بعض ما معه وقال: إنّه هديّة لي، فقال صلى الله عليه وآله: هلّا جلست في بيتك وبيت أبيك وبيت أمك حتى يأتيك هديّة إن كنت صادقاً ثمّ قال: ... والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئاً بغير حقّه الا أتى الله يحمله، ولا يأتينّ أحدكم يوم القيامة ببعير له خوار أو شاة تبعر. ثم رفع يديه إلى السماء حتّى رأيت بياض ابطيه ثم قال: اللّهمّ هل بلّغت» (17).
فلا بدّ أن يقدّر نفسه في بيت أبيه وأمّه فما كان يهدى بعد العزل في بيت أمّه جاز له الأخذ في ولايته، وما علم أنّه لأجل ولايته ولو عزل صرف عنه إلى المنصوب بعده حرم أخذه، وما استشكل عليه الأمر فيه فهو شبهة يحسن الاجتناب والورع عنه.
وأمّا عطايا الحكّام فهي وإن دلّ الإجماع والنصوص من طريق أهل البيت عليهم السلام على جواز أخذها ولو علم أنّهم يظلمون بها الناس سواء كان أخذهم من الناس باسم الخراج والمقاسمة أو غير ذلك ، وسواء رضي المالك أم لم يرضَ ، وسواء كانت العطايا على سبيل الهديّة ونحوها أو على سبيل المعاوضة الشرعيّة ، الا انّها مختصّة بسلاطين أهل الخلاف لورودها فيهم ، وبينهم وبين أهل الحقّ فرق؛ لأنّهم يأخذون من المخالفين مع اعتقاد الاستحقاق وسلاطين الشيعة يأخذون من الشيعة مع اعتقادهم عدم الاستحقاق ، فلا مجال للمقايسة ، وليست العلّة للجواز هناك اختلاط الحلال بالحرام حتّى يجوز الأخذ مالم يعرف بعينه؛ لأنّ القياس حرام الا مع النصّ بالعلّة ... مع أنّ في الأخبار ما يدلّ على الجواز وإن عرف بعينه، نعم لو لم يعرف بعينه جاز الأخذ هنا، بناءً على تلك القاعدة (18)، لكن لا ريب في الكراهة الشديدة وترتّب أثر الحرام الواقعيّ عليه لو كان حراماً، وأيّ برهان أعظم من التجربة كما أشرنا إليه. هذا مع ما ورد من النهي الشديد عن مخالطتهم ومعاملتهم ونهاية احتراز علماء الآخرة من الصحابة والتابعين عن مجالستهم ، كما لا يخفى على متتبّع الآثار ، بل كانت مبالغتهم في الاحتراز عنهم بحيث لم ينقل عنهم مع الفسّاق والفجّار وأهل الأسواق وأرباب الحرف الخسيسة مع غلبة الفسق والفجور والكذب فيهم ، بل مع الكفّار أيضاً ، وإنّما كانت في خصوص الظلمة الآكلين أموال اليتامى والمساكين المواظبين على إيذاء المسلمين وطمس رسوم شرائع الدين ، والسرّ فيه أنّ الفسق لازم لا يتعدى ، وكذا الكفر وهما جنايتان على حقّ الله وحسابهما على الله، وظلم الولاة متعدّ يعمّ ويزداد ويسري، ويقدر العموم والسراية يزيد الغضب والمقت من الله تعالى، فيجب الاحتراز خوفاً من أن يشمله الغضب.
روى محمد بن مسلم قال: مرّ بي الصادق عليهالسلام وأنا جالس عند قاضي المدينة، فدخلت عليه من الغد فقال: «ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قلت: جعلت فداك إنّ هذا القاضي لي مكرم، فربّما جلست إليه، فقال لي: ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في المجلس؟» (19).
وفي الخبر: أنّ الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون: أنّي مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستّين ألفاً من شرارهم! فقال: ياربّ ما بال الأخيار؟ قال: إنّهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم (20).
وفي النبوي صلى الله عليه وآله: «إنّ الله تعالى لعن علماء بني إسرائيل إذ خالطوا الظالمين في معائشهم» (21).
والأخبار كثيرة، فالتورّع عن أكل أموالهم أمر مطلوب جداً، محمود شرعاً وعقلاً.
وأمّا أخذهم عليهم السلام فلا دخل له بالمقام، لكونه حقّاً لهم، والإذن لشيعتهم إمّا لعلمهم باحتياجهم وعدم تمكّنهم من الامتناع وإمّا تحليل لهم عليهم السلام بقبوله عنهم من طرف حقّهم الذي لهم عليهم، هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنّ حكم الظاهر غير الورع، ولذا جعلنا هذه المرتبة بعد تلك المرتبة، وهذا واضح بحمد الله لا سترة ولاريب يعتريه.
وثالثها: ورع المتّقين، وهو ترك الحلال المحض خوفاً من أدائه إلى الحرام، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: «انه لا يكون الرجل من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس» (22).
وذلك كالتورّع عن التحدّث بأحوال الناس خيفة أن ينجرّ إلى الغيبة، والتورّع عن أكل لذائذ الأطعمة ولبس النفائس المكتسبة من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه خوفاً من هيجان النشاط والبطر المؤدّي إلى مقارفة المحظورات.
ولعلّه هو السرّ في منع بعضهم ولو على سبيل الكراهة عن تجصيص المسجد وتزيينه استناداً بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن تكحيل المسجد، فقال صلى الله عليه وآله: «بل عريش كعريش موسى» (23) خوفاً من سريان اتباع الشهوات في المباحات إلى مقارفة المحظورات، فإنّ المباح والمحظور يشتهيان بشهوة واحدة، وإلى هذه المراتب الثلاث أشير في الكتاب المجيد بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة: 93].
قال مولانا الصادق عليه السلام: «التقوى على ثلاثة أوجه، تقوى من خوف النار والعقاب وهو ترك الحرام، وهو تقوى العام، وتقوى من الله وهو ترك الشبهات فضلاً عن الحرام، وهو تقوى الخاصّ، وتقوى في الله وهو ترك الحلال فضلاً عن الشبهة» (24).
ورابعها: ورع الصدّيقين، وهو الاعراض عمّا سوى الله خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد قرباً إليه تعالى، وإن علم أنّه لا يفضي إلى حرام، وهؤلاء يرون كل ما ليس لله حراماً امتثالاً لقوله تعالى: {ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام: 91] والأخبار في فضل الورع ممّا لا تحصى، وهو من أمّهات الفضائل كما أن ضدّه على ما عرفت من أمّهات الرذائل؛ ولذا قال الصادق عليهالسلام: «لا ينال ما عند الله الا بالورع» (25) وفّقنا الله للتقوى وجنّبنا عن اتّباع الهوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المحجة البيضاء: 3 / 213، والوسائل: كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 43.
(2) الوسائل: كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 42، وفيه: «وتأخذ ...».
(3) يعني يحتمل ملكية الصيّاد الأوّل له بالحيازة ثمّ أفلت من يده فصاده الصيّاد الثاني.
(4) بل يعدّ لعدم اعتبار الاستناد إلى سبب في صدق الشبهة، ولكن لا يجب الاعتناء بها.
(5) يعني الظنون غير المعتبرة شرعاً.
(6) التحقيق وجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، ولا دلالة للأخبار على حلّية المجموع، والتفصيل يطلب من مظانّه، فالورع في المحصور لازم.
(7) المحجة البيضاء: 3 / 235 نقلاً عن الكافي (1 / 68) وفيها: «ارتكب المحرّمات».
(8) المحجة البيضاء: 3 / 274.
(9) الكافي: 2 / 77، كتاب الايمان والكفر، باب الورع، ح 7.
(10) المحجة البيضاء: 2 / 203.
(11) المحجة البيضاء: 3 / 204.
(12) المحجة البيضاء: 3 / 204.
(13) قائل هذا القول وكذا الذي بعده هو أبو حامد الغزالي كما في المحجة البيضاء (3 / 276) وقال الفيض رحمه الله بعد الثاني: ولي فيه نظر، بل وفيما قبله أيضاً.
(14) كذا، وفي المحجة البيضاء (3 / 273) ... ما يقصد به المحبّة وجلبها ...
(15) الكافي: 5 / 144، كتاب المعيشة، باب الهدية، ح 12 مع اختلاف.
(16) الكافي: 5 / 144، كتاب المعيشة، باب الهدية، ح 14، وفيه: «تهادوا تحابّوا، تهادوا فإنّها تذهب بالضغائن».
(17) المحجة البيضاء: 3 / 274 ـ 275.
(18) يعني بها ما مرّ (ص 273) من شمول الأخبار المؤمنة لأطواف العلم الإجمالي في المحصورات.
(19) المحجة البيضاء: 3 / 270 نقلاً عن التهذيب (2 / 69).
(20) المحجة البيضاء: 3 / 270.
(21) المحجة البيضاء: 3 / 270.
(22) المحجة البيضاء: 3 / 213 مع اختلاف.
(23) المحجة البيضاء: 3 / 215.
(24) المحجة البيضاء: 3 / 5 نقلاً عن مصباح الشريعة (الباب 82 خ التقوى) مع تقديم وتأخير.
(25) الكافي: 2 / 76، كتاب الايمان والكفر، باب الورع، ذيل ح 3.
 الاكثر قراءة في العفة والورع و التقوى
الاكثر قراءة في العفة والورع و التقوى
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












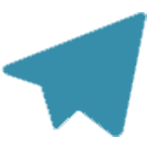
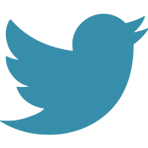

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)