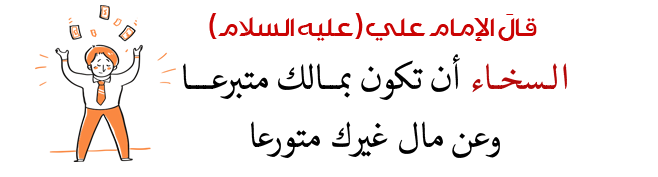
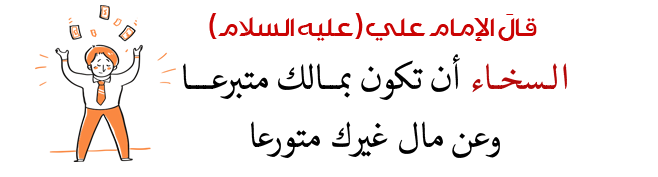

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017
التاريخ: 7-2-2017
التاريخ: 27-2-2017
التاريخ: 10-2-2017
|
قال تعالى : { أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا } [النساء : 78-79].
خاطبهم تعالى فقال : {أينما تكونوا يدرككم الموت} : أينما كنتم من المواضع والأماكن ينزل بكم الموت ، ويلحقكم {ولو كنتم في بروج مشيدة} قيل : يعني بالبروج : القصور ، عن مجاهد ، وقتادة ، وابن جريج . وقيل : قصور في السماء بأعيانها ، عن السدي ، والربيع . وقيل : المراد به بروج السماء .
وقيل : البيوت التي فوق الحصون ، عن الجبائي وقيل : الحصون والقلاع ، عن ابن عباس . فهذه خمسة أقوال . والمشيدة : المجصصة ، عن عكرمة . وقيل : المزينة ، عن أبي عبيدة . وقيل : المطولة في ارتفاع ، عن الزجاج ، وغيره . {وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله} اختلف في من حكى عنهم هذه المقالة ، فقيل : هم اليهود ، قالوا : ما زلنا نعرف النقص في أثمارنا ، ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل ، عن الزجاج ، والفراء . فعلى هذا يكون معناه : وإن أصابهم خصب ومطر ، قالوا : هذا من عند الله ، وإن أصابهم قحط وجدب ، قالوا : هذا من شؤم محمد كما حكى عن قوم موسى : {وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه} ذكره البلخي ، والجبائي ، وهو المروي عن الحسن ، وابن زيد . وقيل : هم المنافقون : عبد الله بن أبي ، وأصحابه ، الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد ، وقالوا للذين قتلوا في الجهاد : لو كانوا عندنا ما ماتوا ، وما قتلوا . فعلى هذا يكون معناه : إن يصبهم ظفر وغنيمة ، قالوا : هذا من عند الله ، وإن يصبهم مكروه وهزيمة ، قالوا : هذه من عندك يا محمد ، بسوء تدبيرك ، وهو المروي عن ابن عباس ، وقتادة .
وقيل : هو عام في اليهود والمنافقين ، وهو الأصح . وقيل : هو حكاية عمن سبق ذكره قبل الآية ، وهم الذين يقولون ربنا لم كتبت علينا القتال ، وتقديره : وإن تصب هؤلاء حسنة ، يقولوا : هذه من عند الله {وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك} : قال ابن عباس ، وقتادة : الحسنة والسيئة : السراء والضراء ، والبؤس والرخاء ، والنعم والمصيبة ، والخصب والجدب . وقال الحسن ، وابن زيد : هو القتل والهزيمة ، والظفر والغنيمة {قل} يا محمد {كل من عند الله} : أي جميع ما مضى ذكره من الموت والحياة ، والخصب والجدب ، من عند الله ، وبقضائه وقدره ، ولا يقدر أحد على رده ودفعه . ابتلى بذلك عباده ليعرضهم لثوابه بالشكر عند العطية ، والصبر على البلية {فما لهؤلاء القوم} : أي ما شأن هؤلاء المنافقين {لا يكادون يفقهون حديثا} : أي لا يقربون فقه معنى الحديث الذي هو القرآن ، لأنهم يبعدون منه بإعراضهم عنه ، وكفرهم به . وقيل : معناه لا يفقهون حديثا : أي لا يعلمون حقيقة ما يخبرهم به أنه من عند الله من السراء والضراء ، على ما وصفناه .
{ما أصابك من حسنة فمن الله} قيل : هذا خطاب للنبي ، والمراد به الأمة ، عن الزجاج . وقيل : خطاب للإنسان أي ما أصابك أيها الإنسان ، عن قتادة ، والجبائي ، قال : وعنى بقوله {من حسنة} : من نعمة في الدين والدنيا ، فإنها من الله {وما أصابك من سيئة} : أي من المعاصي {فمن نفسك} وقيل : عنى بالحسنة : ما أصابهم يوم بدر من الغنيمة ، وبالسيئة ما أصابهم يوم أحد من الهزيمة ، عن ابن عباس .
قال أبو مسلم : معناه لما جدوا في القتال يوم بدر ، وأطاعوا الله ، آتاهم النصر . ولما خالفوا يوم أحد ، خلى بينهم ، فهزموا . وقيل : الحسنة : الطاعة .
والسيئة : المعصية ، عن أبي العالية . قال أبو القسم : وهذا كقوله : {وجزاء سيئة سيئة مثلها} وقيل : الحسنة : النعمة ، والرخاء . والسيئة : القحط ، والمرض ، والبلاء ، والمكاره ، واللأواء ، والشدائد ، التي تصيبهم في الدنيا بسبب المعاصي التي يفعلونها ، وربما يكون لطفا ، وربما يكون على سبيل العقوبة ، وإنما سماها {سيئة} مجازا ، لان الطبع ينفر عنها ، وإن كانت أفعالا حسنة غير قبيحة ، فيكون المعنى على هذا : ما أصابك من الصحة ، والسلامة ، وسعة الرزق ، وجميع نعم الدين ، والدنيا فمن الله . وما أصابك من المحن ، والشدائد ، والآلام ، والمصائب ، فبسبب ما تكسبه من الذنوب ، كما قال : {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} وقوله : {فمن نفسك} معناه : فبذنبك ، عن الحسن ، وجماعة من المفسرين .
وفسره أبو القسم البلخي فقال : ما أصاب المكلف من مصيبة ، فهي كفارة ذنب صغير ، أو عقوبة ذنب كبير ، أو تأديب وقع لأجل تفريط ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من خدش بعود ، ولا اختلاج عرق ، ولا عثرة قدم ، إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر " وقيل : {فمن نفسك} أي : من فعلك . وقال علي بن عيسى : " وفي الآية دلالة على أن الله لا يفعل الألم إلا على وجه اللطف ، أو العقاب ، دون مجرد العوض ، لان المصائب إذا كانت كلها من قبل ذنب العبد ، فهي إما أن تكون عقوبة ، وإما أن تكون من قبل تأديب للمصلحة " وقوله : {وأرسلناك للناس رسولا} معناه : ومن الحسنة إرسالك يا محمد ، ومن السيئة خلافك يا محمد {وكفى بالله شهيدا} لك وعليك . وقيل في معنى اتصاله بما قبلها : إن ما أصابهم فبشؤم ذنوبهم ، وإنما أنت رسول ، طاعتك طاعة الله ، ومعصيتك معصية الله ، لا يطير بك ، بل الخير كله فيك {وكفى بالله شهيدا} أي كفى الله ، ومعناه : حسبك الله شاهدا لك على رسالتك . وقيل ، معناه : كفى بالله شهيدا على عباده بما يعملون من خير وشر ، فعلى هذا يكون متضمنا للترغيب في الخير ، والتحذير عن الشر .
_________________________
1. مجمع البيان ، ج3 ، ص 135-139 .
{ أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ ولَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } . سبق نظيرها عند تفسير الآية 145 من سورة آل عمران ، فقرة « الأجل محتوم » .
{ وإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ } . كل ما يراه الإنسان حسنا يقال له حسنة ، ويرادفها لفظ الخير الذي يرغب فيه الإنسان ويتمناه ، وكل ما يراه سيئا يقال له سيئة ، ويرادفها لفظ الشر الذي يبتعد عنه الإنسان ويأباه ، وقد يكون الخير عاما كالخصب والرخاء الذي لا يختص بفرد أو فئة ، وقد يكون خاصا كسعادة المرء ببيته وأسرته ، وكذلك الشر يكون خاصا كشقاء المرء بزوجته وأولاده ، ويكون عاما كالجدب والغلاء ، والمراد بالحسنة في الآية خير الطبيعة الذي يعم الجميع ، كالمطر ونحوه ، وبالسيئة شرها العام الذي يشمل الجميع ، كالقحط وما إليه ، لأن المنافقين والمشركين كانوا ان أصابتهم نعمة كالمطر قالوا : ان اللَّه أكرمنا بها ، وان أصابهم نقمة كالقحط قالوا : هذا بسبب محمد ، تماما كبني إسرائيل الذين أخبر اللَّه عنهم بقوله : { فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى } [الأعراف :131] .
ليس بالإمكان أبدع مما كان :
{ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً } . هذا رد على من نسب الحسنة إلى اللَّه ، والسيئة إلى رسول اللَّه ، لأنهما معا من اللَّه ، ذلك ان القحط والأمطار ، والزلازل والمعادن ، كل هذه وما إليها من لوازم الطبيعة وآثارها ، واللَّه سبحانه هو الذي خلق الطبيعة وأوجدها ، إذن ، ينسب خير الطبيعة وشرها إليها مباشرة ، والى اللَّه سبحانه بواسطة إيجاده للطبيعة . . فهو جلت عظمته سبب الأسباب .
وتسأل : لما ذا لم يخلق اللَّه الطبيعة من غير شر ، بحيث تكون خيرا خالصا من كل شائبة ، ويريح بهذا عباده من الويلات والمتاعب ؟ .
وقد طرح هذا السؤال أو الإشكال منذ آلاف السنين ، وحلَّه « زرادشت » بوجود إلهين : إله للخير ، وهو « موزد » وإله للشر ، وهو « اهريمن » .
وقال آخرون : ان اللَّه خلق هذه الطبيعة بما فيها ولها من خير وشر ، ولكنه في الوقت نفسه خلق عقولا تكيّف هذه الطبيعة إلى خير الإنسان وصالحه ، ومنها هذه المخترعات التي قربت البعيد ، وسهلت العسير ، وأنشأت السدود لصد الفيضان ، وتنبأت بالعواصف قبل وقوعها . إلى ما لا يحصى كثرة . وقال عابد زاهد :
ان الشر لا بد منه لعقوبة العصاة والمذنبين . . وهذا الجواب يكذبه العيان والقرآن ، فان الطبيعة لا ترحم مؤمنا ولا ضعيفا ، والزلازل لا تميز بين الطيب والخبيث ، قال تعالى : { واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال : 25 ] .
ومنهم من قال : اللَّه يعلم ، ونحن لا نعلم شيئا . وقال الأشاعرة ، هذا السؤال مردود شكلا وأساسا ، لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض والغايات : « لا يسأل عما يفعل » .
وجاء في كتاب الأسفار للعظيم الشهير بالملا صدرا ما يتلخص بأنه من المحال ذاتا إيجاد كون لا شر فيه ، فان الكون الطبيعي من حيث هو ، وبموجب وضعه وتكوينه يلزمه حتما ان يكون فيه خير وشر ، وقوة وضعف ، وحنان وعنف ، وإلا استحال وجوده من الأساس ، كما يستحيل على أمهر المتخصصين في فن البناء ان يبني من حبة الرمل حصنا منيعا (2) . ذلك ان الطبيعة يستحيل أن توجد وتتكون إلا من عناصر متضادة متباينة ، وهذه العناصر في حركة دائمة بين جذب ودفع ، وتفاعل مستمر ، ومن هذا التفاعل تتولد الظواهر الطبيعية ، كالزوابع والعواصف ، والحر والبرد ، والمطر والصحو ، وما إلى ذلك من آثار الطبيعة خيرها وشرها ، وعلى هذا يدور الأمر بين اثنين لا ثالث لهما : أما ان لا يوجد الكون من رأس ، وأما أن يوجد بخيره وشره ، وهذا هو معنى القول المشهور :
« ليس بالإمكان أبدع مما كان » . كما انه يتفق تماما مع قول علماء الطبيعة :
ان في كل جزء من أجزائها قوة موجبة ، وأخرى سالبة .
وبهذا يتبين معنا ان قول القائل : لما ذا لم يخلق اللَّه الطبيعة من غير شر ، ان هذا أشبه بقول من قال : لما ذا لم يخلق اللَّه نارا ، لا حرارة فيها ، وثلجا ، لا برودة فيه ، وعقلا لا ادراك له ، وحياة لا حراك فيها ، وموتا ، لا جمود فيه . . ان هذا السؤال تعبير ثان عن هذيان المحموم ، وقوله : لما ذا لا يكون الشيء غير نفسه . . وبهذا ندرك السر البليغ العميق في قوله تعالى :
{ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً } .
والخلاصة انه لا تأثير لمحمد (صلى الله عليه وآله) ، ولا لغيره في شيء من خير الطبيعة وشرها . وقد اشتهر عن الرسول الأعظم انه قال حينما انكسفت الشمس عند موت ولده إبراهيم : الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه يجريان بأمره مطيعين له ، لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته .
{ ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } . وتسأل :
ان اللَّه سبحانه أصاف في الآية الأولى كلا من الحسنة والسيئة إلى نفسه ، حيث قال : { كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ } وفي الآية الثانية أضاف الحسنة إليه ، والسيئة إلى العبد ، فما هو وجه الجمع ؟
الجواب : قدمنا ان المراد بالحسنة في الآية الأولى خير الطبيعة ، وبالسيئة شرها ، وانهما من ظواهر الطبيعة ، وهي من صنع اللَّه ، فصحت نسبتهما إليه تعالى بهذا الاعتبار . أما المراد بالحسنة في الآية الثانية فهو نجاح المرء في هذه الحياة دينا ودنيا ، والمراد بالسيئة فشله وخذلانه فيهما ، وقد نسب اللَّه سبحانه هذا النجاح المعبر عنه بالحسنة ، نسبه إلى نفسه بالنظر إلى انه تعالى قد زوّد الإنسان بالصحة والإدراك ، وأمره بالعمل من أجل سعادته في الدارين ، فإن امتثل وعمل وبلغ النجاح نسب نجاحه إلى اللَّه ، لأنه هو الذي أقدره عليه ، وزوده بأدواته ، وبهذا اللحاظ قال تعالى : { ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } .
وأيضا يجوز أن ينسب النجاح إلى الإنسان ، لأنه آثر الجد والعمل على الإهمال والكسل . . ولا دلالة في الآية على ان الإنسان لا تأثير له إطلاقا في نجاحه ، أما إذا أهمل وتكاسل ، ولم يصل إلى شيء بسبب إهماله وتكاسله فلا ينسب فشله وحرمانه إلا إليه ، لأنه هو الذي بلغ بنفسه هذا المبلغ بسوء ما اختار لها من الإهمال . وبهذا الاعتبار قال سبحانه : { وما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } . ولا يجوز أن ينسب الفشل إلى اللَّه بحال ، لأنه جل وعلا قد أمر الإنسان بالعمل ، وحثه عليه بعد أن زوده بجميع الأدوات والمؤهلات .
____________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 384-387 .
2. والفلاسفة يعبرون عن هذا وأمثاله بالعجز في المقدور ، لا في القادر .
قوله تعالى : { أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } البروج جمع برج وهو البناء المعمول على الحصون ، ويستحكم بنيانه ما قدر عليه لدفع العدو به وعنه ، وأصل معناه الظهور ، ومنه التبرج بالزينة ونحوها ، والتشييد الرفع ، وأصله من الشيد وهو الجص لأنه يحكم البناء ويرفعه ويزينه فالبروج المشيدة الأبنية المحكمة المرتفعة التي على الحصون يأوي إليها الإنسان من كل عدو قادم .
والكلام موضوع على التمثيل بذكر بعض ما يتقى به المكروه ، وجعله مثلا لكل ركن شديد تتقى به المكاره ، ومحصل المعنى : أن الموت أمر لا يفوتكم إدراكه ، ولو لجأتم منه إلى أي ملجأ محكم متين فلا ينبغي لكم أن تتوهموا أنكم لو لم تشهدوا القتال ولم يكتب لكم كنتم في مأمن من الموت ، وفاته إدراككم فإن أجل الله لآت.
قوله تعالى : { وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ } ( إلى آخر الآية ) جملتان أخريان من هفواتهم حكاهما الله تعالى عنهم ، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يجيبهم عنهما ببيان حقيقة الأمر فيما يصيب الإنسان من حسنة وسيئة.
واتصال السياق يقضي بكون الضعفاء المتقدم ذكرهم من المؤمنين هم القائلون ذلك قالوا ذلك بلسان حالهم أو مقالهم ، ولا بدع في ذلك فإن موسى أيضا جبه بمثل هذا المقال كما حكى الله سبحانه ذلك بقوله { فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ } : [ الأعراف : 131] وهو مأثور عن سائر الأمم في خصوص أنبيائهم ، وهذه الأمة في معاملتهم نبيهم لا يقصرون عن سائر الأمم ، وقد قال تعالى : { تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ } : [ البقرة : 118 ] وهم مع ذلك أشبه الأمم ببني إسرائيل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنهم لا يدخلون جحر ضب إلا دخلتموه » وقد تقدم نقل الروايات في ذلك من طرق الفريقين.
وقد تمحل في الآيات أكثر المفسرين بجعلها نازلة في خصوص اليهود أو المنافقين أو الجميع من اليهود والمنافقين ، وأنت ترى أن السياق يدفعه.
وكيف كان فالآية تشهد بسياقها على أن المراد بالحسنة والسيئة ما يمكن أن يسند إلى الله سبحانه ، وقد أسندوا قسما منه إلى الله تعالى وهو الحسنة ، وقسما إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو السيئة فهذه الحسنات والسيئات هي الحوادث التي كانت تستقبلهم بعد ما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وأخذ في ترفيع مباني الدين ونشر دعوته وصيته بالجهاد ، فهي الفتح والظفر والغنيمة فيما غلبوا فيه من الحروب والمغازي ، والقتل والجرح والبلوى في غير ذلك ، وإسنادهم السيئات إلى النبي صلى الله عليه وآله في معنى التطير به أو نسبة ضعف الرأي ورداءة التدبير إليه.
فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بأن يجيبهم بقوله { قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ } فإنها حوادث ونوازل ينظمها ناظم النظام الكوني ، وهو الله وحده لا شريك له إذ الأشياء إنما تنقاد في وجودها وبقائها وجميع ما يستقبلها من الحوادث له تعالى لا غير. على ما يعطيه تعليم القرآن .
ثم استفهم استفهام متعجب من جمود فهمهم وخمود فطنتهم من فقه هذه الحقيقة وفهمها فقال : { فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً } .
قوله تعالى : { ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } ، لما ذكر أنهم لا يكادون يفقهون حديثا ثم أراد بيان حقيقة الأمر ، صرف الخطاب عنهم لسقوط فهمهم ، ووجه وجه الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وبين حقيقة ما يصيبه من حسنة أو سيئة لذاك الشأن ، وليس للنبي صلى الله عليه وآله في نفسه خصوصية في هذه الحقيقة التي هي من الأحكام الوجودية الدائرة بين جميع الموجودات ، ولا أقل بين جميع الأفراد من الإنسان من مؤمن أو كافر ، أو صالح أو طالح ، ونبي أو من دونه .
فالحسنات وهي الأمور التي يستحسنها الإنسان بالطبع كالعافية والنعمة والأمن والرفاهية كل ذلك من الله سبحانه ، والسيئات وهي الأمور التي تسوء الإنسان كالمرض والذلة والمسكنة والفتنة كل ذلك يعود إلى الإنسان لا إليه سبحانه فالآية قريبة مضمونا من قوله تعالى { ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [الأنفال : 53] ولا ينافي ذلك رجوع جميع الحسنات والسيئات بنظر كلي آخر إليه تعالى كما سيجيء بيانه.
قوله تعالى : { وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً } ، أي لا سمة لك من عندنا إلا أنك رسول وظيفتك البلاغ ، وشأنك الرسالة لا شأن لك سواها وليس لك من الأمر شيء حتى تؤثر في ميمنة أو مشأمة ، أو تجر إلى الناس السيئات ، وتدفع عنهم الحسنات ، وفيه رد تعريضي لقول أولئك المتطيرين في السيئات { هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ } تشؤما به صلى الله عليه وآله ثم أيد ذلك بقوله { وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً } .
_______________________
1. تفسير الميزان ، ج5 ، ص 6-8 .
نستنتج من الآيات السابقة واللاحقة أنّ هاتين الآيتين تقصدان مجموعة من المنافقين تسللوا إلى صفوف المسلمين ، وقد قرأنا في الآيات السابقة أن هؤلاء قد أبدوا الخوف والقلق من المشاركة في مسئولية الجهاد ، وقد ظهر عليهم الضجر والاستياء حين نزول حكم الجهاد ، فردّ عليهم القرآن الكريم وأنبّهم لموقفهم هذا بقوله : {قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى} (2) موضحا أن الحياة بكل زخارفها سرعان ما تزول ، وإنّ ما يناله المؤمنون الذين يخشون الله ولا يعصونه من الخير والثواب هو خير من كل ما في هذه الدنيا من خيرات .
وفي هذا المقطع القرآني ردّ آخر على أولئك المنافقين ، حيث بيّن أن الموت آتيهم يوما لا محالة ، حتى إذا تحصنوا في قلاع عالية ومنيعة بحسب ظنّهم ، وما دام الموت يدرك الإنسان بهذه الصورة أليس من الخير له أن يموت على طريق مثمر وصحيح كالجهاد ؟!
وممّا يلفت الانتباه أنّ القرآن الكريم يطلق في مواقع متعددة اسم «اليقين» على الموت ، كما في الآية (٩٩) من سورة الحجر ، والآية (٤٨) من سورة المدثر ـ ومعنى هذه العبارة القرآنية هو أن الإنسان مهما كانت عقيدته ـ يؤمن بوجود الموت إيمانا لا يخامره فيه شك مطلقا ، ومهما أنكر المرء من حقائق لا يستطيع إنكار الموت الذي يشهده بأم عينه أو يسمع عنه كل يوم ، والإنسان الذي يحب الحياة ويخال أن الموت هو الفناء الذي لا حياة بعده أبدا يخاف من ذكر الموت ويفر من مظاهره .
الآيتان الأخيرتان تؤكدان حقيقة عدم جدوى الفرار من الموت ، فهو يدرك الإنسان يوما ما لا محالة ، وهو حقيقة قطعية يقينية في عالم الوجود .
وعبارة {يُدْرِكْكُمُ} الواردة في الآية الأولى تعني الملاحقة ، واللاحق هو الموت الذي يدرك الإنسان ، وتوحي بأنّ الفرار لا ينقذ الإنسان من هذا المصير الحتمي.
وتؤكد الحقيقة المذكورة الآية الثّامنة من سورة الجمعة إذ تقول : {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ} .
إذن ليس من العقل والمنطق أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة ويفر بعد ذلك من ميدان الجهاد ، ويحرم نفسه أشرف ميتة وهي الشهادة في سبيل الله ، فيموت على فراشه فلو عاش الإنسان بعد فراره من الجهاد أيّاما أو شهورا أو سنوات لتكرر ما فعل ولتكررت أمامه المشاهد الماضية ، فهل من العقل أن يحرم الإنسان نفسه لأجل هذه المتكررات من الثواب الأبدي الذي يناله المجاهد في سبيل الله ؟! وهنا أمر ثان يجب الانتباه له في الآية الأولى من هاتين الآيتين ، وهو عبارة {بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} (3) التي تؤكد أنّ الموت لا تحول دونه القلاع والحصون المنيعة العالية ، والسرّ في هذا الأمر هو أنّ الموت الطبيعي لا يداهم الإنسان من خارج وجوده ـ خلافا لما يتصورون ـ ولا يحتاج إلى اجتياز القلاع والحصون ، بل يأتي من داخل وجود الإنسان حيث تقف أجهزة الإنسان عن العمل بعد نفاذ قدرتها المحدودة على البقاء .
نعم ، الموت غير الطبيعي يأتي الإنسان طبعا من خارج وجوده ، وبذلك قد تنفع القلاع والحصون في تأخير هذا النوع من الموت عنه .
ولكن ما ذا ستكون النهاية والنتيجة؟ هل بمقدور القلاع والحصون أن تحول دون وصول الموت الطبيعي الذي سيدرك الإنسان ـ دون شك ـ في يوم من الأيّام ؟!
من أين تأتي الانتصارات والهزائم ؟
يشير القرآن في هاتين الآيتين إلى وهم آخر من أوهام المنافقين ، حين يوضح أن هؤلاء إذا أحرزوا نصرا أو غنموا خيرا قالوا : إنّ الله هو الذي أنعم عليهم بذلك ، وزعموا أنّهم أهل لهذه النعمة : {وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ} .
أمّا إذا مني هؤلاء بهزيمة أو لحقهم أذى في ميدان القتال ، ألقوا اللوم على النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وافتروا عليه بقولهم إنّ ما نالهم من سوء هو من عنده ، متهمين خططه العسكرية بالضعف ، من ذلك ما حدث في غزوة أحد ، تقول الآية : {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ...} .
ويحتمل بعض المفسّرين أن تكون هذه الآية قد نزلت بشأن اليهود ، ويرون أنّ المقصود بالحسنة والسيئة ـ هنا ـ هو ما كان يحدث من وقائع سارة وضارة ، حيث كان اليهود حين بعثة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسبون كلّ حدث سار ونافع إلى الله ، ويعزون حدوث الوقائع الضّارة إلى وجود النّبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم ، بينما اتصال الآية بالآيات السابقة والتالية ـ التي يدور الحديث فيها عن المنافقين ـ يدل على أنّ المقصود في هذه الآية الأخيرة هم المنافقون .
ومهما يكن من أمر ، فإنّ القرآن الكريم يردّ على هؤلاء مؤكدا إنّ الإنسان المسلم الموحد الذي يؤمن صادقا بالله ويعبده ولا يعبد سواه ، إنّما يعتقد بأنّ كل الوقائع والأحداث والانتصارات والهزائم هي بيد الله العليم الحكيم ، فالله هو الذي يهب الإنسان ما يستحقه ويعطيه بحسب قيمته الوجودية ، وفي هذا المجال تقول الآية : {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ} .
والآية ـ هذه ـ تحمل في آخرها تقريعا وتأنيبا للمنافقين الذين لا يتفكرون ولا يمعنون في حقائق الحياة المختلفة ، حيث تقول : {فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً} .
وبعد هذا ـ في الآية التالية ـ يصرّح القرآن بأنّ كل ما يصيب الإنسان من خيرات وفوائد وكل ما يواجهه الكائن البشري من سرور وانتصار هو من عند الله ، وإن ما يحصل للإنسان من سوء وضرر وهزيمة أو خسارة فهو بسبب الإنسان نفسه تقول الآية : {ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ...} وتردّ الآية في آخرها على أولئك الذين كانوا يرون وجود النّبي صلى الله عليه وآله وسلم سببا لوقوع الحوادث المؤسفة فيما بينهم فتقول : {وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً} .
جواب على سؤال مهم :
السّؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن حين قراءة هاتين الآيتين الأخيرتين هو : لما ذا نسب الخير والشر في الآية الأولى كلّه لله ؟ ولما ذا حصرت الآية التالية الخير ـ وحده ـ لله ، ونسبت الشرّ إلى الإنسان ؟
حين نمعن النظر في الآيتين تواجهنا عدّة أمور ، يمكن لكل منها أن يكون هو الجواب على هذا السؤال .
١ـ لو أجرينا تحليلا على عناصر تكوين الشر لرأينا أنّ لها اتجاهين : أحدهما إيجابي والآخر سلبي ، والاتجاه الأخير هو الذي يجسد شكل الشر أو السيئة ويبرزه على صورة «خسارة نسبية» فالإنسان الذي يقدم على قتل نظيره بسلاح ناري أو سلاح بارد يكون قد ارتكب بالطبع عملا شريرا وسيئا ، فما هي إذن عوامل حدوث هذا العمل الشرير ؟
إنّها تتكون من : أوّلا : قدرة الإنسان وعقله وقدرة السلاح والقدرة على الرمي والتهديف الصحيحين واختيار المكان والزمان المناسبين ، وهذه تشكل عناصر الاتجاه الإيجابي للقضية ، لأنّ كل عنصر منها يستطيع في حدّ ذاته أن يستخدم كعامل لفعل حسن إذا استغل الاستغلال الحكيم ، أمّا الاتجاه السلبي فهو في استغلال كل من هذه العناصر في غير محله ، فبدلا من أن يستخدم السلاح لدرء خطر حيوان مفترس أو للتصدي لقاتل ومجرم خطير ، يستخدم في قتل إنسان بريء ، فيجسد بذلك فعل الشر ، وإلّا فإنّ قدرة الإنسان وعقله وقدرته على الرمي والتهديف ، وأصل السلاح وكل هذه العناصر ، يمكن أن يستفاد منها في مجال الخير.
وحين تنسب الآية الأولى الخير والشرّ كلّه لله ، فإن ذلك معناه أنّ مصادر القوّة جميعها بيد الله العليم القدير حتى تلك القوّة التي يساء استخدامها ، ومن هذا المنطلق تنسب الخير والشرّ لله ، لأنّه هو واهب القوى .
والآية الثّانية : تنسب «السيئات» إلى الناس انطلاقا من مفهوم «الجوانب السلبية» للقضية ومن الإساءة في استخدام المواهب الإلهية .
تماما مثل والد وهب ابنه مالا ليبني به دارا جديدة ، لكن هذا الولد بدلا من أن يستخدم هذا المال في بناء البيت المطلوب ، اشترى مخدرات ضارة أو صرفه في مجالات الفساد والفحشاء ، لا شك أنّ الوالد هو مصدر هذا المال ، لكن أحدا لا ينسب تصرف الابن لوالده ، لأنه أعطاه للولد لغرض خيري حسن ، لكن الولد أساء استغلال المال ، فهو فاعل الشرّ ، وليس لوالده دخل في فعلته هذه .
٢ـ ويمكن القول ـ أيضا ـ بأنّ الآية الكريمة إنّما تشير إلى موضوع «الأمر بين الأمرين» .
وهذه قضية بحثت في مسألة الجبر والتفويض ، وخلاصة القول فيها أنّ جميع وقائع العالم خيرا كانت أم شرّا ـ هي من جانب واحد تتصل بالله سبحانه القدير لأنّه هو الذي وهب الإنسان القدرة والقوّة وحرية الانتخاب والإختيار ، وعلى هذا الأساس فإنّ كل ما يختاره الإنسان ويفعله بإرادته وحريته لا يخرج عن إرادة الله ، لكن هذا الفعل ينسب للإنسان لأنّه صادر عن وجوده ، وإرادته هي التي تحدد اتجاه الفعل.
ومن هنا فإنّنا مسئولون عن أعمالنا ، واستناد أعمالنا إلى الله ـ بالشكل الذي أوضحناه ـ لا يسلب عنّا المسؤولية ولا يؤدي إلى الإعتقاد بالجبر .
وعلى هذا الأساس حين تنسب «الحسنات» و «السيئات» إلى الله سبحانه وتعالى ، فلفاعلية الله في كل شيء ، وحين تنسب السيئة إلى الإنسان فلإرادته وحريته في الإختيار.
وحصيلة هذا البحث إنّ الآيتين معا تثبتان قضية الأمر «الأمر بين الأمرين» (تأمل بدقّة) !
٣ـ هناك تفسير ثالث للآيتين ورد فيما أثر عن أهل البيت عليهم السلام ، وهو أنّ المقصود من عبارة السّيئات جزاء الأعمال السيئة وعقوبة المعاصي التي ينزلها الله بالعاصين ، ولما كانت العقوبة هي نتيجة لأفعال العاصين من العباد ، لذلك تنسب أحيانا إلى العباد أنفسهم وأحيانا أخرى إلى الله ، وكلا النسبتين صحيحتان ، إذ يمكن القول في قضية إنّ القاضي هو الذي قطع يد السارق ، كما يجوز أن يقال إنّ السارق هو السبب في قطع يده لارتكابه السرقة .
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 214-218 .
2. الآية ٧٧ من نفس السورة .
3. «مشيدة» في الأصل من مادة «شيد» على وزن فيل ، بمعنى الجص والمواد الاخرى التي تستخدم لتقوية البنيان ، وبما أن أكثر المواد استعمالا في البناء في تلك الأزمنة هو الجص فان هذه الكلمة تطلق عليه عادة ، فيكون معنى «بروج مشيدة» هو القلاع الرصينة والمتينة ، وقد تستعمل ويراد بها المرتفعة والعالية. وذلك أيضا لنفس السبب لأنّه من دون استخدام الجص لم يكن بالإمكان بناء تلك الأبنية المرتفعة.



|
|
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تنظّم دورةً حول آليّات الذكاء الاصطناعي لملاكاتها
|
|
|