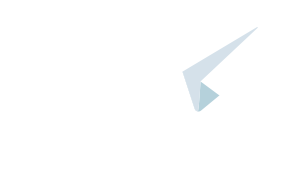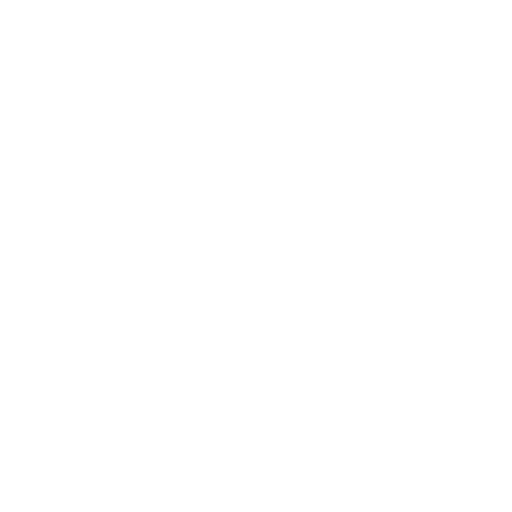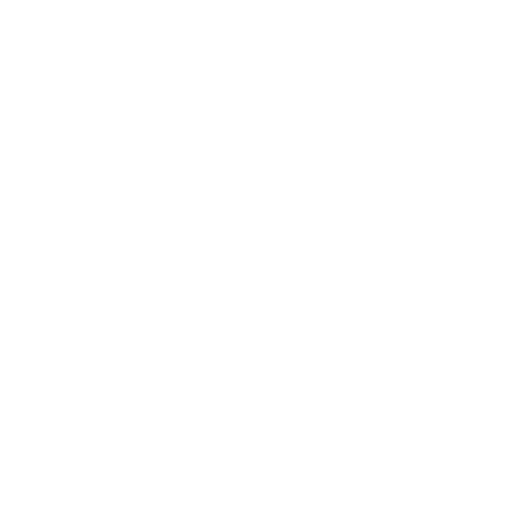علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
شبهات الأخباريّين في الاستغناء عن علم الرجال والرد عليها
المؤلف:
الملا علي كني
المصدر:
توضيح المقال في علم الرجال
الجزء والصفحة:
ص 44 ـ 74.
2/10/2022
4071
[إنّ للأخباريّين] شبهات عديدة مذكورة في كتب الاصول. واحتمال ذكر بعضها من قِبَلهم وإن لم يذكروه أو بإرادة فرض ذكرهم له ليس بذلك البعيد.
فمنها: أنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه؛ لأنّ فيه تفضيح الناس، وقد نُهِينا عن التجسّس عن معايبهم وأُمِرنا بالغضّ والتستّر.
ومنها: أنّ بعض أهل هذا العلم- الذي قد بنوا على أقوالهم في الجرح والتعديل كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فسّاقاً بالجوارح.
مثل: ابن عُقدة وكان زيديّاً جاروديّاً مات عليه بنصّ النجاشي (1) والشيخ (2).
وفي الخلاصة: "كان زيديّاً" (3)، ومثل: عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال وكان فطحيّاً بتصريح الشيخ والنجاشي (4)، وصرّح في الخلاصة بفساد مذهبه (5)، ومع ذلك قال في التعليقة ـ في بيان حاله أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضال ـ :
"وكثيراً ما يعتمدون على قوله في الرجال، ويستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح والتعديل" (6).
بل غير خفيّ أنّه أعرف بهم من غيره، بل من جميع علماء الرجال، فإنّك إذا تتبّعت وجدت المشايخ في الأكثر، بل كاد أن يكون الكلّ يستندون إلى قوله ويسألونه ويعتمدون عليه.
ومنها: أنّ الاختلاف في معنى العدالة والفسق معلوم، وكذا في قبول الشهادة على أحدهما من غير ذكر السبب، فلا يعلم من إطلاقهم ما هو المختار عندنا حتّى نعوّل عليه لو لم يعلم خلافه، فإنّ مختار الشيخ أنّ العدالة ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق (7)، كثير من التعديلات منه، بل على ظاهر دعوى الشيخ أنّه المشهور، فيكون مذهب مَنْ عداه أيضاً. والمتأخّرون لا يكتفون بذلك فكيف يعتمدون على تعديله بل تعديل غيره!؟
ومنها: أنّ الصحّة عند المتأخّرين لابدّ فيها من ثبوت العدالة والضبط والإماميّة في جميع سلسلة السند، وقلّما يتعرّض في الرجال لجميع ما ذكر، وهُمْ يكتفون فيها بقولهم: «إنّ فلاناً ثقة» أو: «من وجوه أصحابنا» أو: «كبارهم» ونحو ذلك.
ولا دلالة في شيء ممّا ذكر على ما ذكروه حتّى لفظ «الثقة» فإنّ غاية مفادها العدالة، وأمّا «الضبط» لاسيّما «الإماميّة» فلا، لاسيّما إذا كان في كلام غير الإماميّ كمن مرّ، خصوصاً حيث كان في كلام الإماميّ جرحه، مع أنّ كثيراً مّا يقال في حقّه أيضاً من الموثّق أو غيره: إنّه واقفيّ أو فطحيّ ونحو ذلك، وهذا ينافي كون مفادها ما ذكر.
وبالجملة: فهُمْ يكتفون في الصحّة بأُمور لا دلالة لها عليها بشيء من الدلالات، على ما يأتي الكلام فيه في بعض ألفاظهم.
ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازَفَة أو لا شاهد عليها أصلًا.
ومنها: أنّ أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح وغيره، وأكثر أسباب التميّز لا تفيد إلّا أقلّ مراتب الظنّ المنهيّ عن العمل به عقلًا ونقلًا، كتاباً وسنّةً وإجماعاً، وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظنّ دون ما يحصل من الشواهد الآتية في اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظنّ القويّ القريب إليه!؟
ومنها: أنّ كثيراً من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنيٌّ على ترجيحهم واجتهادهم، ولا يجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره، وما ليس من ذلك فهو شهادة كَتْبِيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللفظ، وممّا أجمع أصحابنا عليه وورد به بعض الروايات أنّه لا عبرة بالكتاب.
وأيضاً فالأغلب أنّها من شهادة الفرع بل فرع الفرع وهكذا.
ولا خلاف في عدم اعتبار غير الأولى مطلقاً، ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوق دون غيرها، وفي كونها على مدح الرواة وقدحها منها تأمّل، بل منع، مضافاً إلى أنّ المعتبر حينئذٍ اثنان، والمعروف الاكتفاء بالواحد.
ومنها: أنّ مَنْ تأمّل المنتقى وغيره- من كتب الماهرين في معرفة الطبقات- يعرف أنّ جملة من الروايات- لاسيّما [ما] في كتب الشيخ رحمه الله- مرسلة بالمعنى الأعمّ؛ لسقوط راوٍ أو اثنين، وغير العارف بالطبقة يظنّ الاتّصال، ويصحّح السند مع وثاقة الموجودين، وليس كذلك.
وكذا يعلم أنّ في كثير من الأسانيد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم، وكذا وقع في كثير كلمةٍ المجاورة بين شخصين، وحقّه العطف، فمع ضعف أحدهما يضعف الخبر، أو العكس فبالعكس، وكلاهما من الخطأ.
وقد تكون مصحَّفةً من كلمة «ابن» فيشتبه الراوي ويُضعَّف بالوالد، ولا دَخْل له بالسند إلى غير ذلك.
وأيضاً قيل: إنّ كثيراً ممّا رواه الشيخ عن موسى بن القاسم العجليّ أخذه من كتابه، وهو أيضاً أخذه من كتب جماعة، فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتّكالًا على ذكرها في أوّل كتابه، فينقل الشيخ عن موسى من أحد الجماعة من غير إشارة إلى الواسطة، فيظنّ الاتّصال مع أنّ الواقع الإرسال، وجميع ذلك محتمل في جميع الموارد من الشيخ ومن غيره. وممّا يخصّ روايته عن الكافي أنّه قد يترك أوّل السند اعتماداً على ذكره قبله، وربّما غفل عنه الشيخ فروى بإسقاط أول السند بزعم الاتّصال.
ولا يخفى أنّ مفاد هذه الوجوه إنّما هو عدم العبرة بالرجال، ولازمه نفي الافتقار المحْوِج للبحث عنه؛ لتوقّفه على اعتبار المفتقر إليه، فأمّا أنّ المرجع والمعوّل عليه حينئذٍ ماذا؟ فلا يُعلم منها، وإنّما يُعلم من وجوه اخر حكاها كلّاً أو بعضاً المحدّث البحراني على ما قيل عن أمينهم الاسترآبادي أنّه قال: إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن الأئمّة عليهم السلام فلا حاجة إلى ملاحظة أسانيدها (8).
أمّا الكبرى فظاهرة، وأمّا الصغرى: فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة لذلك:
منها [من القرائن]: القرائن الحالية والمقالية في متونها، واعتضاد بعضها ببعض، وكون الراوي ثقةً في نفسه أو في الرواية غير راضٍ بالافتراء ولا متسامح في أمر الدين، فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار.
ومنها [من القرائن]: نقل العالم الثقة الورع في كتابه المؤلَّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه.
ومنها [من القرائن]: كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، على المعنى الظاهر الذي عليه الأكثر ...
ومنها [من القرائن]: كونه مِمَّن نصَّ في الروايات على توثيقه وأمر بالأخذ منه ومن كتابه أو أنّه المأمون في أمر الدين والدنيا (9).
ومنها [من القرائن]: وجودها في أحد الكتب الأربعة: الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار؛ لشهادة مؤلّفيها بصحّة ما فيها من الأخبار، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة التي إليها المرجع وعليها المعوّل.
ومن ذلك: ما ذكره الشيخ الفاضل الكامل الحرّ العامليّ في الوسائل فقال:
"الفائدة التاسعة: في ذكر الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتابَ وأمثالها ووجوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالًا، ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد (10) على تقسيم الأحاديث إلى صحيح وموثّق وحسن وضعيف، الذي تجدّد في زمان العلّامة وشيخه أحمد بن طاووس، والذي يدلّ على ذلك وجوه" (11).
قلتُ: المناسب لهذا المختصر الاقتصار على نقل عمدتها ولو بالمعنى، وجمع ما هو من باب واحد أو بعضه متفرّع على بعض في أمر واحد، فنقول:
أحدها: أنّ المعلوم بالتواتر والأخبار المحفوفة بقرائن القطع أنّه كان دأب القدماء في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها، وكانت هِمَمُهم على تأليف ما تعمل به الطائفة المحقّة، وعرضه على الأئمة عليهم السلام، وقد استمرّ ذلك إلى زمن تأليف الكتب الأربعة حتّى بقيت جملة منها بعد ذلك، وهذه الأربعة منقولة من تلك الأُصول المعتمدة، بشهادة أربابها الثقات، ولغاية بُعْد تأليفهم من غيرها مع تمكّنهم منها ومن تميّز ما هو المعتبر عن غيره غاية التمكّن، مع علمهم بعدم اعتبار الظنّ في الأحكام الشرعيّة مع التمكّن من العلم والتبيّن.
والمعلوم من وثاقتهم وجلالتهم عدم التقصير في ذلك، كيف وأهل التواريخ لا يأخذون القصص من كتاب أو شخص غير معتمد مع التمكّن من الأخذ عن المعتمد، فما الظنّ بهؤلاء المشايخ العظام!؟ وعلى فرض أخذهم من غير الكتب المعتبرة كيف يدلّسون! بل يشهدون بصحّة جميع ما نقلوه وكونه حجّةً بينهم وبين ربّهم (12).
وثانيها: "أنّ مقتضى الحكمة الربّانية وشفقة الرسول والأئمّة عليهم السلام أن لا يُضيَّع مَنْ في أصلاب الرجال من الأمّة، ويُتركوا حيارى يلتجئون إلى التشبّث بظنون واهية وغيرها، بل يمهّد لهم اصول معتبرة يعملون بها في الغيبة، كما هو الواقع والمعلوم بالتتبّع في أحوالهم والتأمّل في الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّهم أَمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه والعمل به في الحضور والغيبة بالنصّ عليها بقولهم: «سيأتي زمان لا يستأنسون فيه إلّا بكتبهم» وفي الأحاديث الكثيرة الدالّة على اعتبار تلك الكتب والأمر بالعمل بها، وعلى أنّها عُرضت على الأئمّة عليهم السلام، فمدحوها ومدحوا صاحبها.
وقد نصّ المحقّق بأنّ كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان كانا عنده (13) ذكر علماء الرجال أنّهما عرضا عليهم (سلام الله عليهم)، فما الظنّ بأرباب الأربعة.
وقد صرّح الصدوق في مواضع بأنّ كتاب محمّد بن الحسن الصفّار، المشتمل على مسائل وجوابات العسكري عليه السلام كان عنده بخطّه الشريف، وكذا كتاب عبد اللَّه بن عليّ الحلبي، المعروض على الصادق عليه السلام (14).
ثمّ رأيناهم يرجّحون كثيراً مّا حديثاً مرويّاً في غير الكتاب المعروض على الحديث الذي فيه، وهذا لا يتّجه إلّا بأنّهم جازمون بكونه في الاعتبار وصحّة الصدور كالكتاب المعروض.
ويقرب من ذلك ما ترى من الشيخ وغيره إلى زمان الاصطلاح والعمل بكثير ممّا هو ضعيف عليه، وكثيراً مّا يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكّنهم من طرق صحيحة، كما صرّح به صاحب المنتقى وغيره.
وهذا ظاهر في صحّة تلك الأخبار بوجوه آخر، ودالّ على عدم العبرة بالاصطلاح الجديد، وحصول العلم بقول الثقة ليس ببدع ولا منكر، فقد نصّ صاحب المدارك (15) وغيره على أنّه يتّفق كثيراً حصول العلم بالوقت في أذان الثقة الضابط العارف حيث لم يكن مانع من العلم، وبمثله صرّح كثير من علمائنا في مواضع كثيرة" (16).
وثالثها: الوجه الأخير من الوجوه المتقدّمة للأسترآبادي (17)، وفيه التصريح بحصول القطع العاديّ من شهاداتهم كالعلم بأنّ الجبل لم ينقلب ذهباً، وقال:
"إنّه لاتّفاق الشهادات وغير ذلك أَولى من نقل ثقة واحد- كالمحقّق والشهيدين- لفتوى من فتاوى أبي حنيفة في كتابه، مع أنّا نرى حصول العلم لنا بذلك من النقل المذكور، فكيف لا يحصل بشهادة الجماعة؟".
وذكر أيضاً أنّه لو لم يجز لنا قبول شهاداتهم في صحّة أحاديث كتبهم لما جاز لنا قبولها في مدح الرواة وتوثيقهم، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثَّق، بل تبقى جميع أخبارنا ضعيفة، واللازم باطل فكذا الملزوم، والملازمة ظاهرة، بل الإخبار بالعدالة أشكل وأعظم وأَولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة، فإنّ ذلك أمر محسوس، والعدالة أمر خفيّ عقليّ يعسر الاطّلاع عليه، ولا مفرّ لهم عن هذا الالتزام عند الإنصاف (18).
وذكر أيضاً أنّ علماءنا الأجلّاء الثقات إذا جمعوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحّتها، لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصوم عليه السلام؛ لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره، ففي الحقيقة هُمْ ينقلونها عن المعصوم عليه السلام، وقد وردت روايات (19) كثيرة جدّاً في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقاً إذا قالوا: إنّ الخبر من المعصوم، وليس هذا من القياس، بل عملٌ بالعموم.
وقال أيضاً:
"إنّهم إن كانوا ثقاتٍ حين شهادتهم، وجب قبولها؛ لكونها عن محسوس، وهو النقل من الكتب المعتمدة، وإلّا كانت أحاديث كتبهم ضعيفةً باصطلاحهم فكيف يعملون بها!؟" (20).
ورابعها: أنّ هذا الاصطلاح مستحدث من زمن العلّامة وشيخه محمّد بن أحمد ابن طاووس، كما هو معلوم لا ينكرونه، وهو اجتهاد منهم وظَنٌّ (21) فيرد عليه ما مرّ في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ في كتاب القضاء وغيره، وهي مسألة أُصولية، فلا يجوز فيها التقليد ولا العمل بالظنّ اتّفاقاً من الجميع، وليس لهم دليل قطعيّ، فلا يجوز العمل به، وما يتخيّل من الاستدلال لهم ظنّيّ السند أو الدلالة أو كلاهما، فكيف يجوز الاستدلال بظنّ على ظنّ، فإنّه دَوْرٌ مع قولهم عليهم السلام: شرّ الأُمور محدثاتها (22). (23)
وذكر أيضاً:
"أنّه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد عُلِمَ نقلها من الاصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثاً بل محرّماً، وشهادتهم بصحّتها زوراً وكذباً، ويلزم بطلان الإجماع الذي عُلِمَ دخول المعصوم عليه السلام فيه، واللوازم باطلة فكذا الملزوم، بل مستلزم لضعف الأحاديث كلّها؛ لأنّ الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإماميّ في جميع الطبقات، ولم ينصّوا على عدالة واحد من الرواة إلّا نادراً، وإنّما نصّوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً، بل بينهما عموم من وجه كما صرّح به الشهيد الثاني وغيره:
ودعوى بعض المتأخرّين (24) أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مُطالَبٌ بدليلها، وإنّما المراد بها مَنْ يُوثَق بخبره ويُؤمَنُ منه الكذب عادةً، وقد صرّح بذلك جماعة من المتقدّمين.
وكذلك كون الراوي ضعيفاً في الحديث لا يستلزم الفسق، بل يجامع العدالة؛ إذ العدل الكثير السهو ضعيفٌ في الحديث.
ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أنّ آية النبإ مُشعِرَةٌ بصحّة هذا الاصطلاح، مضافاً إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختَلَف في حجّيّته.
فإن أجابوا بأصالة العدالة.
أجبنا بأنّه خلاف مذهبهم، ولا يذهب منهم إليه إلّا قليل، ومع ذلك يلزم الحكم بعدالة المجهولين والمهمَلِين، وهُمْ لا يقولون به" (25).
وذكر أيضاً:
أنّ هذا الاصطلاح يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الحضور والغيبة، كما ذكره المحقّق في أُصوله حيث قال: "أفرط قوم في العمل بخبر الواحد".
إلى أن قال: "واقتصر قوم عن هذا الإفراط فقالوا: كلّ سليم السند يُعمل به. وما علم أنّ الكاذب قد يصدق، ولم يتفطّن أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب، إذ لا مصنِّف إلّا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل (26) ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع" (27).
وذكر أيضاً:
"أنّ طريقة المتقدّمين موافقة لطريقة الخاصّة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامّة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر للمتتبّع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن" (28).
وقال أيضاً:
إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم، مأخوذة عن أهل العصمة عليهم السلام؛ لأنّهم قد أمروا باتّباعها، وقرّروا العمل بها، فلم ينكروه، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعاً، فتعيّن العمل بطريقة القدماء (29).
وذكر:
"أنّ إجماع الطائفة المحقّة- الذي نقله الشيخ والمحقّق وغيرهما- على [نقيض] (30) اصطلاح القدماء، فالاصطلاح الجديد استمرّوا على خلافه من زمن الأئمّة: إلى زمان العلّامة، وقد عُلم دخول المعصوم في ذلك الإجماع" (31).
وخامسها: "أنّهم اتّفقوا على أنّ مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة، وقد عرفت أنّ أخبار الكتب المشهورة محفوفة بالقرينة، وقد اعترف بذلك بعض أصحاب الاصطلاح الجديد في عدّة مواضع نقلنا بعضها، فلا موضوع له فيها.
وقد ذكر صاحب المنتقى أنّه من متخرّجاتهم، أي العامّة، بعد وقوع معاني تلك الأنواع في أحاديثهم، ولا وجود لأكثرها في أخبارنا" (32).
قلتُ: مُحصَّل كلماته ما سمعتَ وإن رفع الوجوه إلى اثنين وعشرين، لكن لارتباط بعضها ببعض جعلنا جملة منها وجهاً واحداً، وأشرنا إلى أكثرها بقولنا: ذكر، أو
قال أيضاً، وأكثر ما نقلناه من ألفاظه.
[في الجواب عن الشبهات المذكورة]
إذا عرفت هذا نقول:
إنّ هذه الشبهات وإن لم تكن حاجة إلى دفعها؛ لوضوح فسادها، إلّا أنّا نشير إليه لمن لم يتّضح له ذلك، وحيث إنّها أنواع ثلاثة بالنسبة إلى أربابها فلنتكلّم في دفعها في مقامات ثلاثة:
فنقول في [المقام] الأول:
نجيب عن الأول نقضاً بمقام المرافعات في الجرح والتزكية حتّى قدّر بأيّام، واستثناء الغيبة عند المشاورة.
وحلاً [بالآتي]:
أولاً: بأولويّة كلّيّة الأحكام والحقوق عن جزئيّاتها المجوّز فيها ذلك كالمقامين.
وثانياً: بالمنع عن شمول دليل المنع للمقام ولو للانصراف إلى غيره، أو غيره.
وثالثاً: بانعقاد الطريقة والسيرة والإجماع حتّى من الأخبارية على الجواز في المقام؛ إذ البحث- كما عرفت- إنّما هو في الوجوب؛ للافتقار، والعدم؛ للعدم.
ورابعاً: بورود نحوه في كثير من الأخبار بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد والجوارح.
وخامساً: بما قرّر في الأُصول من سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهمّ، كإنقاذ الغريق عند كونها أجنبيّةً أو توقَّف على غصبٍ في الطريق أو الآلة أو غيرهما، وقد عرفت التوقّف، والأهميّة واضحة.
وعن الثاني [بالآتي]:
أولاً: بالنقض بالعمل- حتّى منهم- برواية المتحرِّزِين عن الكذب مع الوثوق والاعتضاد بقرائن الثبوت. ودعوى الشيخ والمحقّق وغيرهما بعمل الطائفة بنحو هذه الرواية معلومةٌ مذكورة في هذا الإيراد من غيرهما.
وثانياً: بما يأتي في التتمّة من كون الرجوع إلى علماء الرجال من باب تحصيل الظنّ القائم مقام العلم الواجب عند التعذّر.
وعن الثالث نقضاً: بالمرافعات وغيرها.
وحلاً: بأنّ مجرّد الاختلاف في مسألة غير مانع عن العمل بعد البناء على قول، وإلّا لامتنع في أكثر المسائل أو جميعها عدا قليلها.
واختيار الشيخ للقول المزبور مطلقاً أو حين تأليفه الرجال غير معلوم؛ لما في نهايته من روايته رواية ابن أبي يعفور، المعروفة، والمعروف أنّ عمله فيها على طبق رواياتها حيث لم يتعرّض لدفعها.
وعلى فرضه فإرادته مختارة فيها من التعديل في رجاله الموضوع لعمل غيره غير معلوم إن لم يعلم أو يظنّ خلافه، فإنّ التأليف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى الدهر لاسيّما في هذا الأمر العظيم إنّما يكون على وجه ينتفع به الكلّ أو الجلّ، فلا يبنى على مذهب خاصّ إلّا بالتنبيه عليه، وهنا مفقود.
ولو أراده، كان الأجمع أن يفصّل في الأشخاص، فمن كان عدلًا عند الجميع أو فاسقاً عندهم أو عنده أطلق وصفه ويقيّد في غيره.
ويشهد على ما استظهرناه أنّه لم يتعرّض في كتابيه لجماعة كثيرة لولا الأكثر- خصوصاً في كتاب رجاله- بمدح فيهم أو قدح، مع التصريح بكونهم من الإماميّة في بيان أحوالهم وفي مفتتح الكتابين، لوضعهما لذكر رواة الشيعة، فظهر إسلامهم مع ظهوره قطعاً ولو للغلبة والدار وغيرهما، أو بما يلزمه الإيمان أو الإسلام، ككونه من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام. ولازم البناء على مذهبه في العدالة الجرح إن ظهر، وإلّا فالعدالة.
وما ذكر جارٍ في تأليف غيره أيضاً خصوصاً النجاشيّ؛ لوضع كتابه أيضاً للشيعة، فلا يضرّ كون الشهرة على مختار الشيخ مع المنع عن ثبوتها، فإنّ دعواها من بعض على الملكة وآخر على حسن الظاهر مطلقة، بل في الأخيرة التصريح بكونها من القدماء.
وعن الرابع: ما يأتي عن قريب وفي الخاتمة في اصطلاحاتهم.
وعن الثلاثة المذكورة بعده: أنّها إنّما تدفع كون الرجوع إلى الرجال من جهة استفادة القطع أو كون توصيفهم بالمدح أو القدح شهادةً شرعيّة، وتسمع في التتمّة أنّه من جهة استفادة الظنّ القائم مقام العلم الواجب المتعذّر، كما قرّر في قاعدة الانسداد، فإنّا وإن خالفناها في الاصول لا في بعض مقدّماتها هناك إلّا أنّه لا مناص عنها في المقام.
فأمّا وجه عدم اعتبار الظنّ الحاصل من غير هذا العلم- كالأمارات الآتية التي استفادوا منها العلم، وكتصحيح الغير ونحو ذلك- فهو أنّ المعتبر بهذه القاعدة إنّما هو الظنّ المستقرّ الحاصل بالفحص والبحث عن أسبابه، ولذا أوجب القائلون بها في الاصول البحث في الأخبار وغيرها من الأدلّة، ولم يكتفوا بالظنّ الحاصل لغيره ولو شهد بالحكم مَنْ شهد، كيف! وإلّا لزم جواز اكتفاء المجتهد بفتاوى أمثاله، وحَلَّ له التقليد الممنوع في حقّه بالإجماع، ومجرّد تسميته اجتهاداً لا ينفع، وأيّ فرق حينئذٍ بينه وبين التقليد بناءً على اعتباره للظنّ كما يقول به كلُّ أو جُلُّ البانين على هذه القاعدة؟
ولا يرد مثله علينا في الرجوع إلى علماء الرجال في الجرح والتوثيق؛ لمنع كونهما باجتهادهم، بل الظاهر أنّ ذلك بنقل اللاحق عن السابق كما في اللغة، أما سمعت ما مرّ من التعليقة في حقّ ابن فضّال أو بشياع الحال المكتفي به في العدالة والجرح، كما في كثير من متقاربي العصر أو مُتَّحِديه مع فقد الملاقاة والمعاشرة أو بقرائن أُخر مفيدة للظنّ المعتبر؟ ومع التسليم فمثله نادر.
على أنّ الرجوع إلى اجتهاد لا نتمكّن نحن من مثله لا بأس به بعد البناء على الظنّ؛ لأنّ الحاصل من مثله مستقرّ معتبر بالقاعدة المزبورة، بخلاف ما نتمكّن من مثله.
فأمّا كون شهادتهم كَتْبِيّةً في غير موضع اجتهادهم وفرعاً أو فرعَ فرع فهو كذلك، لكن أشرنا إلى أنّ الرجوع لاستفادة الظنّ لا الشهادة ولا ريب في حصول الظنّ بأيّ قسم كانت الشهادة.
مضافاً إلى ما يأتي في التتمّة من إمكان الاكتفاء بنحو هذه الشهادة في خصوص المقام؛ للعمل والإجماع.
فأمّا الإرسال والخطأ الخَفِيّان من الشيخ أو غيره فمع ما مرّ- من كون البناء على الظنّ وعدم اقتضائهما الغنى عن الرجال لو لم يثبتانه لوضوح حصول معرفتهما به- أنّ البحث في الفحص الموجب للتميّز المتوقّف على معرفة الطبقات بالمميّزات، وليس المدار على ظنّ الجاهل، مع أنّهما محتملان في الحكم بصحّة ما في الكتب بالنسبة إلى ما صحّح بالسند.
وتخيّل نفي وجوده فيها رأساً- مع كونه رجماً بالغيب- منافٍ لخبرة الصدوق والشيخ بالرجال غاية الخبرة؛ لوضوح أنّ اقتصارهما على الأخذ من الأُصول المعروفة المعلومة من مصنّفيها يوجب عدم إعمالهما للرجال أصلًا، أو في غير أرباب الاصول، وهو بعيد جدّاً. ولو كان ثبوتها لديهما بالوسائط المتوقّف معرفتهم على الرجال فقد قام هنا الاحتمال.
ونقول في المقام الثاني إجمالاً:
إنّ ما ذكر في هذا الوجه بأجمعه غيرُ مفيدٍ للقطع بالصدور؛ إذ لا أقلّ من قيام احتمال السهو والغفلة؛ لوضوح عدم عصمة الرواة والمؤلّفين للأُصول والكتب المأخوذة منها، ومع التسليم فلا يوجب الغنى عن الرجال على الإطلاق؛ لوضوح وجود الأخبار المعارضة في جملة هذه الأخبار كأخبار التقيّة، ومن المعلوم المدلول عليه بالأخبار العلاجيّة منها وغيرها توقّف تميّز الراجح المعتبر منها على مراجعة الرجال، فأين الغنى المدّعى على كلّ حال؟
إلّا أن يقال: نختار حينئذٍ التخيير الموجود في بعض هذه الأخبار، كما هو مختار ثقة الإسلام (33) ومعه لا افتقار إلى علم الرجال، لا في نفس الأخبار المتعارضة في الأحكام ولا في المتعارضة منها في العلاج، إلّا إذا اخترنا التخيير في القسم الأخير لأخبار الترجيح، فيقع الافتقار في الجميع أو في القسم الأوّل إلّا أنّه بالفرض.
ويدفع [بالآتي:]
أولاً: أنّ المختار حتّى لأكثر الأخباريّة الترجيح دون التخيير.
ثانياً: بأنّ اختيار التخيير إنّما هو بعد ترجيح أخباره على أخبار الترجيح، والترجيح يلتمس الرجحان الذي عمدته في الرواة، المتوقّف معرفتها على الرجال.
ثالثاً: بأنّ المستفاد من الأخبار ترتّب التخيير على تعذّر الترجيح؛ لفقد سببه أو وجوده في الجانبين، فهو في الحقيقة في مقابل التوقّف والرجوع إلى الاصول والقواعد لا الترجيح.
مضافاً إلى أنّ الظاهر- كما قيل- أنّ كلّ مَنْ قال بالافتقار إلى علم الرجال قال به عيناً، فإذا ثبت الافتقار تخييراً بينه وبين التخيير بأخباره، ثبت مطلقاً بالإجماع
المركّب من غير الخصم المنازع.
وبما ذكرناه من إيجاب تعارض أخبار الأحكام- كما هو الغالب- الافتقارَ ولو لم يلاحظ معها أخبار العلاج اندفع ما أمكن أن يقال- بل قيل- من اختصاص أخبار العلاج بزمن الحضور؛ لتصريح بعضها بالإجازة إلى ملاقاة الإمام عليه السلام، ولظهورها في صورة ظنّيّة الأخبار دون قطعيّتها، كما هو المفروض عند الخصم، وللإجماع المركّب، فإنّ كلّ مَنْ قال بالقطعيّة نفى الرجوع إلى أخبار العلاج، والأوّل ثابت بما مرّ فكذا الثاني.
مضافاً إلى ما في دعوى الاختصاص المزبور بوجوهه على التقرير الآخر الملحوظ فيه أخبار العلاج أيضاً أو خصوصها.
ونقول تفصيلاً: وإن كان أيضاً جليّاً: إنّا نمنع الصغرى والكبرى، كما أشرنا إلى منعهما في الإجمال.
ففي الوجه الأول في الصغرى: أنّ حصول القطع من المتن في غاية الندرة، وكذا من الاعتضاد، وعلى فرضه- على ندرته- لا يلازم حصوله في غيره، والافتقار في الغالب كافٍ، بل هو المدّعى.
وكذا من كون الراوي ثقةً؛ لمنع حصول القطع للراوي الثقة؛ لعدم لزومه لا في الرواية ولا في العمل، فلعلّه أخذها ممّن يثق به تعبّداً أو ظنّاً خاصّاً أو مطلقاً، وعلى تسليمه فحصوله لا يستلزمه لنا؛ لاحتمال السهو والنسيان والذهول عن القرينة أو خفائها، كما وقع في كثير من الرواة فردعَهم: بقوله عليهم السلام: "ليس كما ظننت" (34) أو "ليس كما تذهب" (35) أو "ما أراك بعد إلا هاهنا".
وفي باب الأوقات: "قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلاً، فتركوها حتّى اشتبكت النجوم".
وفيه أيضاً بعد ذكر أبي الخطّاب ولعنه قال: إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.
مضافاً إلى أنّ معرفة وثاقة الراوي وضبطه وغير ذلك من الامور الموجبة للقطع أو الظنّ إنّما هي بالرجوع إلى الرجال، وإن حصل لنا القطع بعده، فإنّا لم نجعل منشأ الافتقار حصول خصوص الظنّ.
ومن هنا يظهر قوّة ما أشرنا إليه من أنّ مجرّد دعوى قطعيّة الصدور لايلازم الغنى عن الرجال، فلاحظ.
ومن هنا يظهر أنّ حصول العلم لنا بل مطلقاً باتّصاف الرواة بهذه الأوصاف في غاية الندرة، على أنّ بقاء الراوي على الوثاقة وغيرها من الصفات الموجبة للقطع بما يخبر به إلى حين إخباره غير معلوم في أكثر الرواة أو جميعهم، وثبوتها في الجملة غير كافٍ في مقام حصول العلم وإن اكتفي به للاستصحاب أو غيره في مقام الظاهر.
كما أنّ ثبوتها علماً حين بعض رواياته (36) لا تكفي إلّا في هذا البعض، مع أنّ ذلك كلّه- على فرض تسليمه- إنّما ينفع في حال الاختيار وعدم خوف تقيّة ونحوها، وإلّا فلا؛ لجواز بل لزوم التحرّز عن الضرر بإظهار غير المعتقد ولو بتورية ونحوها لاسيّما إن اريد بالقطع قطعيّة المفاد.
وفي الثاني من وجوهها بعد جملة ممّا سمعت، سواء اريد بالناقل الثقة المشافهة للمعصوم عليه السلام أو غيره أو مطلقاً- أنّ احتمال الدسّ في كتابه من المخالفين أو المعاندين له أو لمالك كتابه أو من الهازل أو الفاسق كيف ينسدّ، خصوصاً مع ما ورد نحوه في أخبار كثيرة مرّ بعضها، وكيف العلم مع عدم انسداده!؟
وأيضاً فالغلط من الكتاب بما يخفى ويتغيّر به المعنى ممّا لا يخفى، إلى غير ذلك ممّا لا يجامع العلم احتماله، خصوصاً إن أُريد الثقة غير المشافهة كالمشايخ الثلاثة وأضرابهم؛ لأنّ حصول العلم لهم بصدور جميع ما جمعوه عن المعصوم عليه السلام مع كثرة الوسائط، وتضعيفهم لكثير من ذلك ـ كما في الفقيه وزيادة في التهذيب والاستبصار ـ كما ترى، مع أنّهم لم يدّعوا ذلك، بل ادّعوا الصحّة، وهي لا تلازم علم الصدور، ويأتي الكلام في هذا بوجه أبسط وأوفى.
وأمّا إن اريد به خصوص المشافهة، ففيه- بعد تسليم حصول العلم لنا باتّصافه بالصفات المزبورة من غير مراجعة إلى الرجال-: أنّ كتب أمثاله لم تصل إلينا.
مضافاً إلى اختلاف النَقَلَة في نقل جملة منها، فذكر النجاشي في ابن عمير:
"أنّ نوادره كثيرة؛ لأنّ الرواة لها كثيرة" (37) وفي محمّد بن عذافر: "له كتاب تختلف الرواة عنه" (38) وغير ذلك.
وفي الثالث: أنّه إجماع منقول، غايته إفادة الظنّ، والأخباريّة لا يرون الاعتماد عليه، مع أنّ المحتمل بل الظاهر إرادة مطلق الاتّفاق منه دون الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، فلا حجّيّة فيه، فكيف بالقطع بمفاده!؟ على أنّ الظاهر إرادة الوثوق من الصحّة، فإنّ المراد منها في اصطلاح القدماء باعتراف الجماعة، فيكون المعنى أنّ ما يصدر منه واثقاً به موثوق به عند المجمعين، وأين هذا من العلم؟
وعلى فرضه فقد مرّ أنّ علم الغير- واحداً أو متعدّداً- لا يوجب علمنا، مضافاً إلى ما يأتي في بيان معنى العبارة وتعيين أشخاص المجمع عليهم، فإنّ فيهما اختلافاً مخلّاً بالعلم جدّاً، مع أنّ معرفة ذلك كلّه بالرجال، فكيف يستغنى به عنه!؟
وفي الرابع ـ بعد كثير ممّا مرّ- أنّ توثيق المعصوم عليه السلام لم يثبت أنّه مَبنيٌّ على غير الظاهر. سلّمنا، لكنّه منقول إلينا بأخبار الآحاد غير المفيدة للعلم، مع وقوع التعارض في كثير منها على ما يظهر من ملاحظة جمع الكشي رحمه الله وغيره، بل منها يظهر أنّ وقوع التوثيق بسندٍ صحيح من غير معارضة مثله لم يقع إلّا في حقّ نادر من الرجال، وهذا على تسليمه لا ينافي الافتقار في غيره.
وفي الخامس: أنّه ليس في كلماتهم ما يدلّ على علمية جميع ما جمعوه في كتبهم من الأخبار، وإنّما فيه ما يفيد أنّها معمول بها عندهم أو عند غيرهم؛ لوضوح أعمّيّة العمل من العلم، وكذا أخذ ما فيها من الاصول المعتبرة.
وقد أشرنا إلى عدم كونها قطعيّةً بجميع ما فيها عند أربابها أيضاً، فكيف بغيرهم ممّن عاصرهم!؟ وكيف بمن تأخّر عنهم!؟ فإنّ المرجعيّة والتعويل على شيء لا تقتضي إلّا الحجّيّة والاعتبار، وغايتهما إفادة الوثوق والاعتماد، فأينَ ذلك من العلم؟ وقد أشرنا في وجوه المختار إلى التزامهم بذكر أسانيد الأخبار تفصيلًا أو إجمالًا، مع التعليل بالتحرّز عن خروج أخبارهم عن الإرسال، فلو كانت علميّةً لم يفتقر إلى ذلك أصلًا، ولبطل التعليل المزبور.
وأيضاً تراهم غير متّفقين في الجمع لما جمعوه، فالكلينيّ ترك كثيراً ممّا نقله المتأخّر عنه وكذا المتأخّر عنه، وزاد على ما جمعه السابق عليه حتّى بالنسبة إلى الكلينيّ والصدوق مع تقارب العصر، والمنقول عن أحوالهم أنّهم كانوا يتعبون في جمع الأخبار ونقدها وتصحيحها، ومَنْ هذا شأنه كيف يترك جملة من الأخبار العلميّة التي وافقه غيره عليها ويأتي بغيرها!؟
وأيضاً فالصدوق نرى اعتمد كثيراً على تصحيح وتضعيف شيخه ابن الوليد حتّى قال: "إنّ كلّ ما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح" وذكر بعد استضعافه لرواية محمّد بن موسى الهمدانيّ: "أنّ كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته فهو عندنا متروك" (39).
وأيّ مدخل لذلك في الأخبار العلميّة؟ وكيف يستفاد من تصحيح الغير العلمُ بالصدور خصوصاً!؟ ومن الظاهر بل المعلوم أنّ تصحيح شيخه وتضعيفه كان بالاجتهاد في الرجال، كما وقع التعليل في بعض ذلك، وقد نصّوا في أحوال شيخه: "أنّه كان عارفاً بالرجال" (40). وكيف يردّ الأخبار العلميّة بدعواه أخذها من الكتب المعوّل عليها بمجرّد تضعيف شيخه؟
ومن لاحظ أوّل (الإستبصار) لمتأخّر عن جميع هذه الكتب مصنِّفاً وتصنيفاً، وهو في الحقيقة لسان غيره، عَلِم علماً قطعيّاً أنّ هذا الإسنادَ إليهم توهّمٌ صرف أو صرفُ افتراء؛ لأنّه- بعد أن ذكر المتواتر وما أوجب العلم، وجعل القسم الآخر كلّ خبر لا يكون متواتراً ويتعرّى من واحدة من القرائن التي ذكرها- قال:
"إنّ ذلك خبر واحد، ويجوز العمل به على شروط، فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر، فإنّ ذلك يجب العمل به، لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل، إلّا أن يعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به. وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارِضَيْنِ، فيعمل على أعدل الرواة" (41).
إلى أن قال:
"وأنت إذا فكرتَ في هذه الجملة، وجدتَ الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام، ووجدتَ أيضاً ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام، ولم نُشر في أوّل كلّ باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي عملنا عليها وإن كنّا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك، طلباً للإيجاز والاختصار" (42).
وهل يقدر العاقل أن يقول: الآحاد التي عمل بها الشيخ، وادّعى عليه الإجماع المفيد لكون عمل مَنْ سبقه أيضاً عليه، ونظر فيه مع التعارض إلى ما لا يعلم أو يظنّ إلّا بالرجال؟ وكان بناؤه في كتبه جميعاً على الترجيح بالأسباب التي يعلم ممّا ذكر منها أنّها ممّا يعرف بالرجال، وغايتها إفادة الظنّ أنّي مع كلّ ذلك عالم بصدور هذه الأخبار عن المعصوم عليه السلام أو بمفادها من غير رجوع إلى الرجال، بل التحقيق عدم حصول الظنّ بذلك أيضاً إلّافي جملة منها معيّنة أو مجملة كما لا يخفى على المتأمّل.
ومنه يظهر أنّ تنزيل بعضهم لدعوى القطعيّة على إرادة العلم العادي كالعلم بأنّ الجبل لم ينقلب ذهباً أو على ما يسمّى به في العرف العامّ أو الخاصّ بالمبتدئين في العلم، وهو الظنّ القويّ كما عن آخر أيضاً، واضح الفساد، خصوصاً والأخير لا يغني عن الاجتهاد والرجوع إلى الرجال وغيره من أسباب الظنّ بالاعتبار أو الدلالة.
نعم، إن أرادوا بذلك قطعيّة الحجّيّة في كثير ممّا فيها لا في الجميع، فهو حقّ لاشكّ فيه حتّى عند العاملين بالظنّ المطلق، إلّا أنّ ذلك من مقدّمات الافتقار إلى الرجال لا من الأدلّة على خلافه.
وأمّا من استدلّ بأقوالهم في أوائلها على الصحّة بأنّها شهادة منهم عليها والبيّنة معتبرة مطلقاً، خصوصاً وهي منهم متضمّنة لتعديل رواة ما في كتبهم من الأخبار، وأنّها لا تقصر إن لم تكن أولى من شهادة واحد أو أكثر من علماء الرجال على وثاقة راوٍ، فيدفعه:
أولاً: ما عرفت من منع كونها شهادةً، كيف ويعتبر فيها العلم بلا خلاف!؟ وعرفت أنّ عملهم من باب الترجيح والرجوع إلى أحوال الرجال وغير ذلك ممّا غايته الظنّ غالباً.
ثانياً: منع اعتبار الشهادة في أمثال هذه الموارد التي هي بالفتوى أقرب، بل هي منها؛ لكونها إخباراً عمّا اجتهد فيه في المسألة الاصوليّة، وهي مسألة حجّيّة أخبار الآحاد.
ثالثاً: منعه؛ لكونها شهادةً علميّة على تسليمها وتسليم أخبارهم بطريق الجزم، وفي اعتبارها خلاف وإشكال.
رابعاً: لعدم تعيين المشهود به من الروايات والرواة.
خامساً: لكونها كتبيّةً.
سادساً: لإعراض المشهور عن الاكتفاء بها، كما يشهد له بناؤهم على الاصطلاح الجديد، وتعليله بتميّز المعتبر عن غيره بعد دعوى إخفاء القرائن المفيدة لذلك.
ويشهد له أيضاً مخالفة بعض المشايخ لبعض وعدم اكتفائه بشهادة مَنْ سبقه.
سابعاً: بأنّ مرادَهم بالصحيح- كما يجيء في الباب الثاني بل الثالث- هو ما اعتمدوا بكونه من المعصوم سواء قطعوا أو ظنّوا لجملة من الأمارات التي كانت عندهم، وواضح أنّه من باب اجتهادهم وفحصهم عن الأمارات، ولا يجوز لنا تقليدهم
وعلى فرض تسليم الجميع فإنّما هي في الأخبار الموجودة في الجميع أو في اثنين منها؛ لوضوح اعتبار العدد في الشهادة بالإجماع والأخبار، وقد فَصَّلنا ذلك في كتاب القضاء والأحكام، والاكتفاء بتوثيق واحد في الرجال؛ لكونه من نبإ العدل أو مطلق الظنّ كما يأتي. ويأتي أنّ الحقّ هو الأخير، وإلزامنا بالعمل بها من هذه الجهة مرّ دفعه في الجواب عن رابع وجوه المقام الأوّل.
[في الجواب عمّا أورده صاحب الوسائل]
ونقول في المقام الثالث إجمالاً بمثل إجمال المقام الثاني، وتفصيلًا بالإضافة إلى إجماله، وإلّا فهو أجمل من تفصيل المقام الثاني.
ففي الوجه الأول بعد ما مرّ فيما يقرب منه، خصوصاً ما سبق من أخبار دسّ المعاندين، واختلاف جملة من الأُصول في أنفسها، وبسبب اختلاف رواتها
والعرض عليهم (عليهم السلام) إنّما هو في قليل من تلك الأصول، وكون جميع الكتب الأربعة منها غير معلوم، بل المعلوم خلافه، مع أنّه منقول بأخبار الآحاد، وإثبات اعتبار غيرها بها لا يخلو من دور، كيف! وقد سمعت ما عن الصدوق وما في الاستبصار.
ومنه ظهر أنّ التميّز الممكن في حقّهم إنّما هو بالظنّ والترجيح.
ودعوى عدم العلم بالظنّ حينئذٍ أو مع التمكّن حقّ إن أُريد مطلقه، وإلّا فكما ترى، خصوصاً بعد ما وَرَد في أخبار العلاج، بل في حجّيّة الأخبار، وعرفت أنّ الأخذ من الكتب المعتمدة لا يوجب العلم بالصدور ولا الاعتبار في الجميع، كما عرفت أنّ الصحّة المشهود بها ليست إلّا ما يوجب العمل والاعتماد، قطعاً كان أو ظنّاً معتبراً بالنصّ أو الاجتهاد في الأدلّة.
وفي الثاني: أنّ الضياع إنّما هو مع عدم نصب طريق ولو ظنّيّاً، بل مطلقاً، لا مطلقاً، وقد قال معدن الأحكام عليه وآله الصلاة والسلام: "إنّا نحكم بالظاهر واللَّه يتولّى السرائر" (43) فأين هذه الحكمة في الحكومات مع أنّ فيها تضييع الأموال وتحريم الحلال وتحليل الحرام كما في أصل الأحكام.
ومرّ الجواب عمّا دلّ على اعتبار الكتب والعرض، وأنّ شيئاً من ذلك ونحوه لا يوجب الجزم بالصدور.
وأمّا طرح ما هو الصحيح بالاصطلاح المتأخّر والعمل بضعيفه فغيرُ دالٍّ على عدم العبرة بهذا الاصطلاح، كيف! ودَيْدَنُهم على الطرح والعمل المذكورين، بل غايته أنّ اعتبار الصحيح في مصطلحهم- كعدم اعتبار ضعيفه - أصل ربّما يخرج عنه لأمر خارج، أو كلٌّ منهما مشروط بفقد ما يورث الظنّ بالخلاف ونحو ذلك، أو لأنّ عمدة الوجه تحصيل الظنّ بالصدور، وهذا قد يكون في الضعيف وقد لا يكون في الصحيح، وأنّه الظاهر من القدماء، وليس ببعيد، بل أقرب من غيره.
وأمّا حصول العلم بقول الثقة مع ضمّ القرائن فشيء لا ينكره مُنكِرٌ، فلاحاجة إلى الاستشهاد فيه بكلمات العلماء إلّا أنّ الكلام في حصوله في المقام.
وفي الثالث: ما مرّ في الجواب عن أخير وجوه المقام الثاني، فأمّا دعوى أولويّة شهاداتهم عن نقل مذهب مخالف أو موافق فكما ترى، فإنّ هذا بالمشاهدة والعَيان، وتلك بمراعاة الظنّ والترجيح والاجتهاد كما عرفته فيما مرّ من البيان، مضافاً إلى منع حصول العلم في الأخير أيضاً.
نعم، إن أُريد به مجرّد ثبوت أخذ ما في الأربعة عن الكتب المعتمدة باعتقاد الآخذ فللتنظير وجه، إلّا أنّه لا يفيد المستدلّ شيئاً؛ لما سمعت من منع العلم في المقامين، وعدم إيجاب اعتمادهم لاعتمادنا؛ لما مرّ في وجهه، مضافاً إلى ما قيل أو احتمل من أنّهم وإن ذكروا ذلك في أوائل الكتب إلّا أنّهم غفلوا عنه أو رجعوا منه في الأثناء
وأمّا مقايسة اعتبار شهاداتهم باعتبار توثيقهم في الرجال، بل أنّه أولى وأنّه لا مفرّ لهم عن هذا الإلزام، فدفعه أوهن شيء مَرَّ إليه الإشارة في الجملة؛ لأنّ الأوّل
بالاجتهاد، بخلاف الثاني غالباً، والاكتفاء في الأخير بقاعدة الانسداد، المجوّزة للعمل بالظنّ المستقرّ دون غيره، وأنّه غير حاصل في الأوّل، بل هو تقليد مع تمكّن الاجتهاد (44) ومنه يظهر الفرق بين ما حدّدوه بالسماع والقراءة ونحوهما وبين ما اجتهدوا في اعتباره وصحّته ثمّ أخبروا عن مختارهم.
وبه يتّجه منع صدق الرواة عليهم بالاعتبار الأخير إذا انفكّ عن الرواية على الوجه المتعارف.
وفي الرابع أنّ إحداث الاصطلاح ليس من البدعة أو المحرّمة منها، وإلّا فإحداث الوضع في الحقيقة عند المتشرّعة وغيرها منها، وأمّا كونه من الاجتهاد أو الظنّ الوارد في ذمّهما الأخبار فكلّا؛ لوضوح المغايرة، مع أنّ الاجتهاد الممنوع هو العمل بالظنون التي لم يثبت اعتبارها أو ثبت عدمه كالقياس والاستحسان، والكلام فيه خارج عن وظيفة المقام.
وأمّا أنّه مسألة اصوليّة، فإن اريد أصل الاصطلاح، فواضح البطلان. وإن أُريد الحكم باعتبار محلّ اصطلاح دون آخر، فهو كذلك، إلّا أنّ دليله الكتاب والسنّة.
ففي الاعتبار آيات حجّيّة الأخبار كآية النبإ والسؤال والإنذار، والأخبار الدالّة على اعتبار قول الثقة، خصوصاً وعموماً، بالتصريح أو التعليل وغير ذلك، وقد جُمع أكثرها في الوسائل، مضافاً إلى الإجماع والسيرة.
وفي العدم الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظنّ وتقليد الآباء، مضافاً إلى الإجماع أيضاً مع عدم الاعتضاد بأمرٍ خارج، وليس المقام مقام التفصيل.
وأمّا استلزامه لضعف أكثر الأحاديث المعلوم نقلها من الاصول المُجْمَع عليها فممنوع بعد ثبوت كونها من الأصل المجمع على اعتبار تمام ما فيه، كيف! والعمل بالضعيف المجبور بالشهرة مشهور عندهم إن لم يكن مجمعاً عليه فكيف بالمجبور بالإجماع على العمل به!؟
نعم، هو كذلك مع عدم ثبوت ما ذكر إمّا بعدم ثبوت كونها من الأُصول أو عدم كون الأصل مُجمعاً عليه أو مجمعاً على جميع ما فيه مع فقد سائر أسباب الاعتضاد. وظاهر أنّه لا يرد في ذلك شيء من اللوازم المزبورة في هذا الوجه.
ومع التسليم فإنّما هو في بعض الأحاديث لا أكثرها.
ثمّ إنّ في دعوى الإجماع على الأُصول القديمة مع فرض وجودها أن محقّقه غيرُ ثابتٍ، خصوصاً إن أُريد بغير فَقْدٍ وانتخاب. أو قطعيّة الصدور، ومحكيّه غيرُ نافعٍ في إثبات هذا المرام، مع وهنه بردّ أكثر الأصحاب أو جميعهم لكثيرٍ ممّا فيها، وقد اعترف في الوجه الثاني من وجوهه بترجيحهم كثيراً مّا للحديث المرويّ في غير الكتاب المعروض على المعصوم عليه السلام على المرويّ فيه، كيف! ولازمه كون أرباب الأُصول ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، لا خصوص المذكورين في الرجال.
مضافاً إلى ما قيل من أنّ وجه الإجماع والعمل غير معلوم أنّه من جهة مطلق الظنّ أو كونه بناء العدل أو غير ذلك، ومثله غير حجّة، لا لاختلاف مستند الفتوى، بل لاختلاف المفتي به، ومن هنا سمّي إجماعاً تقييديّاً.
وأغرب من ذلك دعوى استلزامه قطعيّة جميع الأحاديث، كما هو واضح على المطّلع بطريقة الأصحاب، ويأتي في باب ألفاظ المدح والقدح ما يتّضح به فساد ما توهّمه في ذلك وفي حكمهم بالفسق إذا قيل في حقّ الرجل: إنّه ضعيف في الحديث.
وأَولى ما يُعتذر له أنّه غير خبيرٍ بطريقة الأصحاب.
وأغرب من ذلك كلّه دعوى استلزامه لتخطئة جميع الطائفة، كيف! وهُمْ كثير من الطائفة إن لم يكونوا أكثرهم؟
وليس المراد من القوم الذين أشار إليهم المحقّق أهل هذا الاصطلاح؛ لوضوح طرحهم كثيراً من سليم السند وعملهم بكثير من ضعيفه، وإن كانوا هم المراد للمحقّق، فالخطأ منه، فلاحِظْ كتب رئيس هذه الطائفة وهو العلّامة ثمّ اعرف
وأمّا ما ذكره من مخالفة الاصطلاحين وأنّه من المتقدّمين موافق لطريقة الخاصّة وموجب للعلم ومأخوذ عن أهل العصمة عليهم السلام ومُجمع عليه بخلافه من المتأخّرين، فإن أراد نفس التسميتين، فمع أنّه لا مشاحّة فيها فيه: أنّ شيئاً منهما غير مأخوذٍ عنهم عليهم السلام ولا إجماع على أحدهما، ولا ضير في مخالفة مثله.
وإن أراد حجّيّة المصطلح عليه عند طائفة- كما ذكر- بخلاف حجّيّة الآخر، ففيه: أنّ مصطلح المتأخّرين ليس على خلاف ما ذكره؛ لما أشرنا إليه من ثبوت الدليل عليه من الكتاب والسنّة بل الإجماع، بل أشرنا فيما سبق إلى أن لا مخالفة بينهم من هذه الجهة، وإنّما الخلاف في تسمية الأحاديث المعتبرة بهذا الاسم أو باسم المعمول عليه عند المتأخّرين وباسم الصحيح عند القدماء، كتسمية خلافها بخلاف هذه الأسامي
نعم، لا ننكر وجود مَن اقتصر في الحجّيّة على الصحيح عند المتأخرين، إلّاأنّه إمّا نادر أو مخالف لما اقتضته الأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع القولي والعملي محقّقاً ومحكيّاً.
وفي الخامس: أنّ اعتراف البعض على فرض ثبوته إنّما يقدح في حقّه لوضوح عدم مضي الإقرار في حقّ غيره، ومع ذلك فله تعيين موضع التقسيم في أخبار غير الكتب المشهورة.
ونفي (المنتقى) وجود أكثر أنواعه في أخبارنا منافٍ لما طفحت به عباراته، وقد وَضَع الكتاب المزبور في الأحاديث الصحاح والحسان، إلّا أن يريد على مذهبه من اعتبار التعدّد في المزكّي والجارح نفي صحيح أو موثّق وهكذا على وجود التعدّد في كلّ واسطة، ومع ذلك فهو كما ترى.
وأمّا ما استند إليه المفصّل في الافتقار إلى الرجال بين صورة تعارض الأخبار فالافتقار، وغيرها فالعدم، فعلى الأخير بعض ما مرّ في شبهات النافي له على الإطلاق، والذي وقفت على حكاية استناده إليه أنّ أخبارَ الكتب الأربعة- لأخذها من الاصول المعتمدة بشهادة مؤلّفيها- معتضَدَةٌ بقرائن الوثوق والصحّة.
وعلى الأوّل ما مرّ أيضاً في سند المشهور، وفي المناقشة مع النافي من دلالة الأخبار على الترجيح بالأعدليّة وغيرها وممّا يُعلم بالرجال، بل بشهادة الاعتبار القاضي بأخذ الراجح دون المرجوح ودون التسوية بينهما؛ لقبحهما، وقد مرّ ما في الوجه الأوّل مفصّلًا ومتفرّقاً.
وأمّا وجه التفصيل بين وجود شهرة معتبرة على وفق بعض الأخبار وغيره- وقد مرّ، أنّا لم نجد به قائلًا وإنّما هو لازم عمل جماعة- فهو أنّ الشهرة من أقوى المرجّحات المنصوصة والاعتباريّة؛ لوضوح قوّة الظنّ بتراكم الظنون من شخص واحد فكثيراً مّا ينتهي إلى القطع، بل لعلّ أغلب العلوم من هذا الباب.
وكذا إذا كانت من أشخاص، فإنّ موافقة الآراء- خصوصاً مع شدّة اختلاف الأفهام- من أقوى أسباب الاعتضاد والقوّة.
وأيضاً فغالب أحكام هذا المذهب كغيره من المذاهب ممّا لم يذهب بذهاب الموجودين من أهله في كلّ طبقة، بل وصل من التقدّم إلى المتأخّر يداً بيد.
قال في بعض مقدمات (كشف الغطاء) ما مفاده: "إنّه لا حاجة في كلّ مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنّة، بل هُما ممّا ينبغي أخذهما ذخيرة ليوم الفاقة، وهو حيث تعارض مقتضى القواعد وفُقِد الإجماع ولم يُعلم ما كان في أيدي الطائفة المحقّة، وإلّا فلا افتقار إليهما؛ لأنّ مذهبنا ليس أقلّ من المذاهب الأربعة عن أربابها وكلّ أو
جُلّ ما صدر عنهم في أيدي تبعته.
ولو سُلِّم المنع عمّا ذكر، فلا ريب أنّ انعقاد الشهرة على خلاف ما هو من المذهب في غاية البُعد.
مضافاً إلى وجود النصّ على الترجيح بها وتعليله بأنّ المجمع عليه لاريب فيه، والتعليل في نفسه من أسباب القوّة والترجيح، ولذا يقدّم المعلّل على غيره، خصوصاً بمثل التعليل المذكور المعتضد بالاعتبار، كما عرفت.
هذا، وأمّا وجه الافتقار في غير ذلك فظاهر"(45).
والجواب عنه [بالآتي:]
أولاً: أنّه منافٍ لما مرّ من إجماع الأُصوليّين قولًا وعملًا بل سيرة جميع الرواة والمحدّثين، فإنّ عمل الجميع على ملاحظة أحوال رجال السند بطرقنا التي منها الرجال المتعيّن في حقّنا لفقد غيره من غير فرق بين وجود الشهرة وعدمه.
ثانياً: أنّ مقتضى تقرير الوجه المزبور الأخذُ بمقالة المشهور، وذلك لتعارض أخبار الترجيح في عدد أسبابه وفي تقديم بعضها على بعض، ولاريب في انعقاد الشهرة على الترجيح بالسند بملاحظة أحوال الرجال حتّى مع وجود الشهرة في أحد الطرفين، فمقتضى اعتبارها اعتباراً بل نصّاً الترجيح بالسند، ويأتي تقرير لزوم ملاحظة الرجال مطلقاً.
وهذا نظير ما قيل على حجّيّة الشهرة من أنّ المشهور عدم حجّيّتها، إلّاأنّ المقام أسلم منه من الإشكال؛ وذلك لأنّ ما دلّ على الترجيح بالشهرة لم يفد المنع عن الترجيح بغيرها، كما أنّ ما دلّ على الترجيح بالسند أو بالمتن باعتبار موافقة القرآن أو مخالفة العامّة كذلك.
نعم، لا يخلو ظواهرها من تعارضٍ مّا من حيث إطلاق كلٍّ منها، ويجمع بإرادة بيان أنّ كلّاً منها سبب للترجيح مع قطع النظر عن الآخر.
ومع الاجتماع في جانبٍ لا إشكال. ومع الاختلاف يؤخذ بما الظنّ معه أقوى لاستفادة البناء عليه من مجموع أخبار التراجيح ومن إلحاق المشهور غير المنصوصة بالمنصوصة وغير ذلك أو بإرادة بيان أنّ كلًّا منها معتَبَرٌ في مقام أو غير ذلك.
وحاصل الجميع: أنّ الشهرة في الفروع مرجّحة وكذا الشهرة في الاصول، أي في أخبار العلاج، وليست هي على تعيّن الترجيح بغير الشهرة في الفروع من ملاحظة المتن والسند، ولذا سمعت عملهم بالضعيف المنجبر بالشهرة، بل المدار على ما أشرنا إليه من قوّة الظن، فإن كانت في الترجيح بالسند، أخذنا به، وإن كانت في الترجيح بالمتن، فكذلك.
وكذا لو كانت في الترجيح بالشهرة، فملاحظة السند لازمة- على كلّ حالٍ- لملاحظة أنّ قوّة الظنّ في الترجيح به أو بغيره، وحيث إنّ احتمال كونها في الترجيح به قائم في جميع الموارد أو أكثرها، فلابدّ من الملاحظة كذلك.
ومن هنا ظهر أنّ الترجيح بالشهرة- سواء كان مشهوراً أم لا- لا ينافيه الإجماع والسيرة على ملاحظة أحوال رجال السند.
نعم، ينافيه الإجماع على الترجيح بهذه الملاحظة على الترجيح بالشهرة، كما أنّ ترجيح الترجيح بها على الترجيح بالملاحظة المزبورة مُنافٍ للإجماع والسيرة المذكورين.
وبالجملة، يحصل الغنى عن الرجال على الالتزام بالترجيح والشهرة مطلقاً فيما وجدت الشهرة المعتبرة، إلّا أنّ هذا القول بمكانٍ من الضعف.
وثالثاً: أنّ قضيّة الوجه المزبور حجّيّة الشهرة كحجّيّة الإجماع، وسمعت أنّ المشهور خلافه.
ورابعاً: أنّ قضاء الاعتبار بل النصّ في الترجيح بالشهرة إنّما هو إذا كان الخبر مشهور النقل بين الرواة على وجه الاعتماد، أو مشهور العمل به بين الفقهاء على وجه الاستناد إليه، لا على مجرّد مطابقة الفتوى المشهورة في نفسها للرواية. ومثل هذا ليس كثير الوقوع إن لم يكن قليله، فعدم الافتقار إلى الرجال في مثله على فرضه غير مُنافٍ لإطلاق اعتباره، وإلّا فواضح أنّه قد يُستغنى عن الرجال لأُمور خارجيّة، مثل كون المسألة إجماعيّةً ونحوها.
وأمّا وجه الاكتفاء بتصحيح الغير فهو أنّ اعتبار قول أهل الرجال سواء كان من جهة كونه شهادةً أو روايةً أو لإفادة الظنّ أو غيرها مثله تصحيح بعض العلماء، خصوصاً إذا كان من أهل الرجال أو كثير البصيرة بذلك العلم كصاحبي المنتقى والتعليقة وغيرهما.
وفيه وضوح الفرق بينهما على الوجوه أو الأقوال المزبورة.
أمّا على الأوّل: فلاعتبار تعيّن المشهود به في الشهادة، وكونها بطريق المطابقة وصدورها عن علم لا باجتهاد ظنّي، والجميع مُنتفٍ في تصحيح الغير.
أمّا الأوّل: فواضح، فمع انتفاء التعيين قد يكون خلاف هذه الشهادة معلوماً عند المشهود عنده بعلمه، وواضح أنّ الشهادة غير معتبرة مع العلم بالخلاف، فلابدّ أن يعيّن حتّى يلاحظ أنّه المعلوم الخلاف أم لا.
فإن قلتَ: السند مضبوط في كتب الحديث فليرجع إليها ويعرفهم، والمحذور إنّما هو لو لم يكن للمشهود عنده طريق إلى التعيين.
قلتُ: نعم، ولكن ربّما لا يعلم كونه المعلوم الخلاف بذلك؛ للاشتراك، فلا يُعلم إلّا بالرجوع إلى الرجال.
فإن قلتَ: عم، فليرجع إليه لكن يكتفى بمجرّد معرفته أنّه ليس من معلوم الخلاف عنده بتصحيح الغير.
قلتُ: أوّلًا: أنّه خلاف مقصود المخالف؛ لوضوح أنّ غرضه الاكتفاء به عن الرجال مطلقاً، وثانياً: نّ غاية الأمر حينئذٍ ارتفاع خصوص هذا المانع دون غيره المانع عن الاكتفاء حينئذٍ.
أيضاً لا يُقال: مورد الشهادة نفس الخبر، فإنّه الذي يشهد بصحّته، وهو معلوم معيّن
لأنّا نقول: معنى صحّته وثاقة رواته، كما هو واضح، فهي في الحقيقة من الأوصاف المتعلّقة بالغير، كقولك: زيد قائم الأب، فاللازم تعيين ذلك الغير الذي هو محلّ الوصف المشهود بثبوته فيه.
وأمّا الثاني: فواضح كوضوح اعتباره الذي فرّقوا به بين الشهادة والإقرار غير المعتبر فيه ذلك، وبه لم يجعلوا الشهادة على قيء الخمر شهادةً على شربها، وجعلوا الإقرار بالشراء إقراراً بالملك السابق للغير.
وأمّا الثالث: فواضح أيضاً؛ لأنّ أغلب التصحيحات من باب الاجتهاد الظنّي.
ولو فرض تصحيح بالعلم، لم نقبله أيضاً؛ لما مرّ من المانِعَيْنِ الممتنع انتفاء ثانيهما مع أنّ البحث في الإطلاق. مضافاً إلى ذلك كلّه أنّ رجوع المجتهد إلى اجتهاد الغير غير جائز إجماعاً أو بغير خلافٍ مُعتَدّ به.
ولا يورد علينا بأنّ كثيراً من توثيقات أهل الرجال أيضاً من باب الاجتهاد؛ لما أشرنا إليه من الفرق بين ما إذا تعذّر أو استلزم محرّماً اجتهادنا بعد اجتهاده وبين غيره.
والمنع عن التقليد أو الاكتفاء بالظنّ الحاصل عن غيره إنّما هو في الأخير دون الأوّل. واجتهادنا في الرجال فيما اجتهد فيه المتقدّمون منهم بل المتأخّرون متعذّر أو متعسّر شديد أو مستلزم لتعطيل الأحكام وترك كثير من الاجتهادات الواجبة كفايةً أو عيناً علينا.
مضافاً إلى أنّ الإجماع القولي والعملي على الرجوع إليهم مطلقاً هو المجوّز للاكتفاء بالظنّ الحاصل من أقوالهم ولو كانت بالاجتهاد، وعلى فرض منع الإجماع فلا إجماع قطعاً على المنع عن الاكتفاء في المقام.
ومن ذلك كلّه يظهر وجه المنع عن الاكتفاء ولو على كون الاعتبار من باب الرواية؛ لأنّ الاكتفاء بالرواية إنّما هو إذا لم تكن عن اجتهاد، وإلّا فنقل جميع الفتاوى رواية، فلا وجه للتمسّك بعموم اعتبارها من العدل على المقام. وقد عرفت الجواب عن إيراد مثله علينا بالنسبة إلى بعض أقوال بعض أهل الرجال.
وعلى تسليم شمول عمومات الرواية للمقام نقول: المخرج عنها في الاكتفاء
بتصحيح الغير ما عرفت، ولا أقلّ من الشهرة القويّة الموهِنة للتمسّك بالعمومات.
وأمّا على الثالث: فلأنّ المعتبر بقاعدة الانسداد- كما قرّر في محلّه- إنّما هو الظنّ المستقرّ؛ لوضوح أنّه من باب الإلجاء والضرورة، والعقل إنّما يحكم بخصوص ذلك لا مطلقاً، وحصول الاستقرار من تصحيح الغير ممنوع جدّاً، كيف! واحتمال خطئه في كلّ واحد من رجال السند على زعم غيره قائمٌ، وهو احتمال يمكن دفعه بالرجال، بخلافه في حقّ نفسه بعد الرجوع فلا نقض. مضافاً إلى ما يرى من كثرة اختلافاتهم في التصحيح.
ومنه يظهر مانع آخر، وهو لزوم الترجيح عند التعارض، كما في الجرح والتعديل، فلابدّ من الفحص في جميع الكتب المشتملة على التصحيح والتضعيف، كما نفحص في الرجال عن المعارِض، ولا يلتزم به المخالف.
وأيضاً فأيّ فرق بين الظنّ الحاصل من اجتهاد الغير في التصحيح والتضعيف واجتهاده في الأحكام، فكيف يكتفي المخالف بأحدهما دون الآخر!؟
ومن هنا أمكن تقرير دليلٍ آخر على المنع على هذا الفرض، وهو أنّ الظنّ الحاصل من اجتهاد الغير ولو كان مستقرّاً فهو مثل الظنّ القياسي ونحوه الممنوع عن العمل به مع فرض الانسداد من باب التخصيص أو التخصّص، وذلك لمصيرهم- كما عرفت- إلى عدم اعتبار الظنّ الحاصل من اجتهاد الغير في حقّ غيره.
ثمّ إنّ هذا البحث إنّما هو مع التمكّن من مراجعة الرجال مع عدم مانعٍ آخر عنها، وإلّا بأن تعذّرت لحبس أو سفر مع وجوب الاستنباط عيناً أو كفايةً من مثله أو مطلقاً أو تعسّرت شديداً أو استلزمت لمحرّمٍ آخر من فوات واجب الاستنباط أو الوجوب المستنبط من الأحكام التكليفيّة الواجبة، فلا أجد خلافاً في عدم وجوب المراجعة وقيام تصحيح الغير مقامها.
وليس فيه سقوط وجوب المقدّمة مع بقاء وجوب ذيلها أو سقوط وجوب ذيلها المفروض خلافه، بل هو من باب قيام مقدّمة مقام أُخرى عند تعذّرها، كتحصيل الصعيد واستعماله عند تعذّر الماء لو فقده إلى غير ذلك من موارد ترتيب المقدّمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال النجاشي، ص 94، الرقم 233.
(2) رجال الطوسي، ص 441، الرقم 30 في من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام).
(3) خلاصة الأقوال، ص 203، الرقم 13.
(4) رجال النجاشي، ص 257- 258، الرقم 676.
(5) خلاصة الأقوال، ص 93، الرقم 15.
(6) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 229.
(7) نقله عنه المحقّق الحلّي في: معارج الأُصول، ص 149.
(8) الفوائد المدنية، ص 40، 53، 56؛ الدرّة النجفية، ص 168.
(9) انظر: خاتمة الوسائل، ص 220 وما بعدها (الفائدة السابعة، التوثيقات العامّة).
(10) في النسخ: «الاستدلال» بدل «الاصطلاح الجديد» وما أثبتناه من المصدر.
(11) خاتمة الوسائل، ص 251 و 252.
(12) خاتمة الوسائل، ج 30، ص 252- 253.
(13) انظر المعتبر، ج 1، ص 7.
(14) الفقيه، ج 4، ص 151، ح 523، وقال الصدوق رحمه الله في ذيل الحديث: "وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السلام". أي: بخطّ الإمام أبي محمد الحسن بن عليّ عليهما السلام.
(15) مدارك الأحكام، ج 3، ص 98، بحث الإعتماد على أذان الثقة.
(16) خاتمة الوسائل، ص 257.
(17) هو صاحب « الفوائد المدنيّة»، الشيخ المحدِّث محمد أمين الأسترآبادي
(18) خاتمة الوسائل، ص 257- 262.
(19) انظر: المصدر السابق، ص 220 (الفائدة السابعة، التوثيقات العامّة).
(20) خاتمة الوسائل، ص 263- 265.
(21) انظر: الفوائد المدنيّة، ص 55 وما بعدها.
(22) بحار الأنوار، ج 2، ص 263، ح 12؛ ج 10، ص 110، ح 1؛ ج 77، ص 122، ح 23.
(23) خاتمة الوسائل، ص 262.
(24) منتقى الجمان، ج 1، ص 5.
(25) خاتمة الوسائل، ص 260 و 261.
(26) المعتبر، ج 1، ص 29.
(27) خاتمة الوسائل، ج 30، ص 259.
(28) خاتمة الوسائل، ج 30، ص 259.
(29) خاتمة الوسائل، ج 30، ص 258.
(30) الزيادة أثبتناها من المصدر.
(31) خاتمة الوسائل، ص 263.
(32) المصدر السابق، ص 262 و 263.
(33) الكافي، ج 1، ص 8، خطبة الكتاب.
(34) بحار الأنوار، ج 71، ص 15، ح 26.
(35) بحار الأنوار، ج 22، ص 331، ح 42.
(36) كذا في الأصل.
(37) رجال النجاشي، ص 326 و 327، الرقم 887.
(38) رجال النجاشي، ص 360، الرقم 966.
(39) الفقيه، ج 2، ص 55 باب صوم التطوّع، خبر صلاة يوم الغدير.
(40) خلاصة الأقوال، ص 147، الرقم 43.
(41) الاستبصار، ج 1، ص 4.
(42) الاستبصار، ج 1، ص 5.
(43) إيضاح الفوائد، ج 3، ص 4866 وفيه« نحن» بدل« إنا ».
(44) قال في وافية الأُصول (ص 294 و 295): واعلم أنّ الاجتهاد كما يطلق على استعلام الأحكام من الأدلّة الشرعية، كذلك يطلق على العمل بالرأي والقياس، وهذا الإطلاق كان شائعاً في القديم.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله في بحث شرائط المفتي من كتاب العدّة: "إنّ جمعاً من المخالفين عدُّوا منها العلم بالقياس والاجتهاد وبأخبار الآحاد وبوجوه العلل والمقاييس وبما يوجب غلبة الظنّ". ثمّ قال: "إنّا بيّنّا فساد ذلك وذكرنا أنّها ليست من أدلّة الشرع"
وظاهراً أنّ الاجتهاد الذي ذكره أنّه ليس من أدلّة الشرع ليس بالمعنى المتعارف؛ إذ لا يحتمل كونه من جنس الأدّلة.
والسيّد المرتضى في كتاب الذريعة ذكر أنّ الاجتهاد: "عبارة عن إثبات الأحكام الشرعيّة بغير النصوص والأدلّة أو إثبات الأحكام الشرعية بما طريقه الأمارات أو الظنون".
وقال في موضع آخر منه: "وفي الفقهاء مَنْ فرّق بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما له أصل يقاس عليه، وجعل الاجتهاد ما لم يتعيّن له أصل، كالاجتهاد في طلب القبلة وفي قيمة المتلفات بالجنايات، ومنهم مَنْ عدّ القياس من الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعمّ منه".
وقال: "وأمّا الرأي فالصحيح عندنا أنّه عبارة عن المذهب والاعتقاد الحاصل من الأدلّة غير الحاصلة من الأمارات والظنون" هذا حاصل كلامه.
وظاهر أيضاً أنّ الاجتهاد في كلامه ليس بمعناه المعروف، وقد ورد ذمّ الاجتهاد في بعض الأخبار، وهو بهذا المعنى الثاني، وكأنّ هذا هو الباعث لإنكار الاجتهاد للقائل المذكور، وهو غلط ناشئ من الإشتراك اللفظي". انتهى. (منه)
(45) كشف الغطاء، ص 39، الطبعة الحجرية.
 الاكثر قراءة في مقالات متفرقة في علم الرجال
الاكثر قراءة في مقالات متفرقة في علم الرجال
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












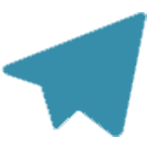
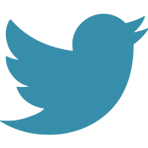

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)