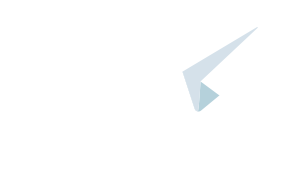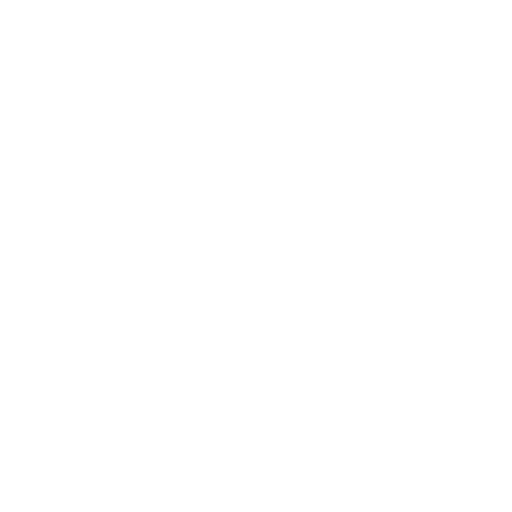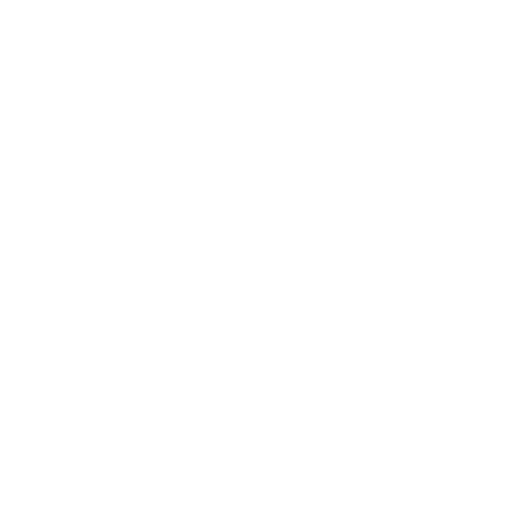الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
اعتبارات الزهد و درجاته
المؤلف:
محمد مهدي النراقي
المصدر:
جامع السعادات
الجزء والصفحة:
ج2. ص67-76
29-7-2016
4107
للزهد اعتبارات تتحقق له بكل اعتبار درجات : (الأول) اعتبار نفسه أي من حيث نفس الترك للدنيا و بهذا الاعتبار له درجات ثلاث : (الأولى) أن يزهد في الدنيا مع ميله إليها و حبه لها بأن يكف نفسه عنها بالمجاهدة و المشقة ، وهذا هو التزهد , (الثانية) أن يترك الدنيا طوعا و سهولة من دون ميل إليها لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما يطمع فيه من لذات الآخرة ، و هذا كالذي يترك درهما لأجل درهمين معاوضة فإنه لا يشق عليه ذلك و إن كان يحتاج إلى قليل انتظار، و مثله ربما أعجب بنفسه و بزهده لاحتمال أن يظن بنفسه أنه ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه , (الثالثة) و هي أعلى الدرجات أن يترك الدنيا طوعا و شوقا ولا يرى أنه ترك شيئا ، إذ عرف أن الدنيا لا شي فيكون كمن ترك خنفساء و أخذ ياقوتة صافية حمراء ، فلا يرى ذلك معاوضة و لا يرى نفسه تاركا شيئا و سبب هذا الترك كمال المعرفة ، فان العارف على يقين بأن الدنيا بالإضافة إلى اللّه و نعيم الآخرة أخس من خنفساء بالنظر إلى ياقوتة ، هذا الزاهد في أمن من خطر الالتفات إلى الدنيا ، كما أن تارك الخنفساء بالياقوتة في أمن من طلب الإقالة في البيع.
وقد ذكر أرباب القلوب من أهل المعرفة أن مثل تارك الدنيا بالآخرة مثل من منعه عن باب الملك كلب يكون في بابه فألقى إليه لقمة خبز نالها من موائد الملك فشغله بنفسه و دخل الباب و نال غاية القرب من الملك حتى نفذ أمره في جميع مملكته ، أ فترى أنه يرى لنفسه عوضا عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلب في مقابلة ما يناله مع كون هذه اللقمة أيضا من الملك فالشيطان كلب على باب اللّه يمنع الناس من الدخول ، مع أن الباب مفتوح و الحجاب مرفوع و الدنيا كلقمة خبز إن أكلها فلذتها في حال المضغ و تنقضي على القرب بالابتلاع ثم يبقى ثقله في المعدة ثم ينتهي إلى النتن و القذر و يحتاج إلى إخراجه ، فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت إليها , و لا ريب في نسبة الدنيا لكل شخص أعني ما يسلم له منها و إن عمر ألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا ، إذ لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي ، و الدنيا متناهية ، و لو كانت تتمادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدورة لكان لا نسبة لها إلى الأبد فكيف و مدة العمر قصيرة و لذاتها مكدرة غير صافية فأي نسبة لها أي نعيم الأبد.
(الثاني) اعتبار المرغوب عنه أعني ما يترك وبهذا الاعتبار له خمس درجات : (الأولى) أن يترك المحرمات و هو الزهد في الحرام ، و يسمى زهد فرض.
(الثانية) أن يترك المشتبهات أيضا وهو الزهد في الشبهة ، و يسمى زهد سلامة.
(الثالثة) أن يزهد في الزائد عن قدر الحاجة من الحلال أيضا و لا يزهد في التمتع بالقدر الضروري من المطعم و الملبس و المسكن و أثاثه و المنكح و ما هو وسيلة إليها من المال و الجاه ، و إلى هذه الدرجات كلا أو بعضا أشار مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله : «كونوا على قبول العمل أشد عناية منكم على العمل ، الزهد في الدنيا قصر الأمل و شكر كل نعمة و الورع عن كل ما حرم اللّه عز و جل».
ومولانا الصادق عليه السلام بقوله: «الزهد في الدنيا ليس بإضاعة المال و لا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق بما في يد اللّه عز و جل».
وهذا مع ما يأتي بعده هو الزهد في الحلال ، و يسمى زهد ثقل.
(الرابعة) أن يترك جميع ما للنفس فيه تمتع و يزهد فيه و لو في قدر الضرورة ، لا بمعنى ترك هذا القدر بالمرة ، إذ ذلك متعذر، بل تركه من حيث التمتع به و إن ارتكبه اضطرارا من قبيل أكل الميتة مع الإكراه له باطنا ، و هذا يتناول ترك جميع مقتضيات الطبع من الشهوة و الغضب والكبر و الرئاسة و المال و الجاه و غيرها ، و إلى هذه الدرجة أشار الصادق (عليه السلام) بقوله : (الزاهد في الدنيا الذي يترك حلالها مخافة حسابه و يترك حرامها مخافة عذابه) وإليها يرجع قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : (الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال اللّه سبحانه : {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد : 23] .
فمن لم يأس على الماضي و لم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه وقوله (عليه السلام) (الزهد في الدنيا ثلاثة أحرف : زاء و هاء و دال أما الزاء فترك الزينة و أما الهاء فترك الهوى و أما الدال فترك الدنيا».
(الخامسة) أن يترك جميع ما سوى اللّه و يزهد فيه حتى في بدنه و نفسه أيضا بحيث كان ما يصحبه و يرتكبه في الدنيا إلجاء و إكراها من دون استلذاذ و تمتع به ، وإلى هذه الدرجة
أشار مولانا الصادق (عليه السلام) حيث قال : «الزهد مفتاح باب الآخرة و البراءة من النار و هو تركك كل شيء يشغلك عن اللّه من غير تأسف على فوقها و لا إعجاب في تركها و لا انتظار فرج منها و لا طلب محمدة عليها و لا عوض منها بل يرى فوتها راحة و كونها آفة»
إلى آخر الحديث .
ثم الالتفات إلى بعض ما سوى اللّه و الاشتغال به ضروري كضرورة الأكل و اللبس و مخالطة الناس و مكالمتهم و أمثال ذلك ، لا ينافي هذه المرتبة من الزهد ، إذ معنى الانصراف من الدنيا إلى اللّه تعالى إنما هو الإقبال بكل القلب إليه تعالى ذكرا و فكرا ، و هذا لا يتصور بدون البقاء ولا بقاء إلا بضرورات المعيشة ، فمتى اقتصر من الدنيا عليها قصدا لدفع المهلكات عن البدن و الاستعانة بالبدن على العبادة و سائر ما يقربه إلى اللّه لم يكن مشتغلا بغير اللّه ، إذ ما لا يتوصل إلى الشيء إلا به فهو منه ، فالمشتغل بعلف دابته في طريق الحج ليس معرضا عن الحج ، و لكن ينبغي أن يكون البدن في طريق اللّه مثل الدابة في طريق الحج ، فكما أن قصدك من تهيئة ما تحتاج إليه دابتك دفع المهلكات عنها حتى تسير بك إلى مقصدك دون تنعمها ، فكذلك ينبغي أن يكون قصدك من الأكل و الشرب و اللباس و السكنى صيانة بدنك عما يهلكك من الجوع و العطش و الحر و البرد فتقتصر على قدر الضرورة و تقصد به التقوى على طاعة اللّه دون التلذذ و التنعم ، و ذلك لا ينافي الزهد بل هو شرطه ، ثم ترتب التلذذ على ذلك لا يضرك إذا لم يكن مقصودا بالذات لك فإن الإنسان قد يستريح في قيام الليل بنسيم الأسحار و صوت الطيور و هذا لا يضر بعبادته إذا لم يقصد طلب موضع خاص لهذه الاستراحة على أنه لا لذة حقيقة في الأكل و الشرب و اللباس و إنما تندفع بها آلام الجوع و العطش و الحر و البرد.
ثم لا يخفى أن الفضول من أمور الدنيا من المطعم و المشرب و الملبس و المسكن و أثاثه و المنكح و المال و الجاه ينبغي تركها و الزهد فيها إذ الأخذ بما لا يحتاج إليه ينافي الزهد.
(وأما) غير الفضول مما يحتاج إليه الإنسان و يكون مهما له من الأمور الثمانية ، فينبغي ألا يترك الزهد فيها ، إذ ما هو المهم الضروري يتطرق إليه فضول في مقداره و جنسه و أوقاته فينبغي ألا يترك الزهد فيه أيضا.
ومقتضى غاية الزهد فيه أن يقتصر من القوت على قوت يومه و ليلته فإن كان عنده أزيد من ذلك فليبذله على بعض المستحقين ، فإن اقتصر من جنسه على خبز الشعير فهو نهاية الزهد في القوت ، إلا أن أكل خبز الحنطة في بعض الأحيان بل أكل أدام واحد في بعض الأوقات إذا لم يكن من اللذائذ الشديدة من أطعمة المتنعمين من أهل الدنيا لا ينافي الزهد ، و ربما لم يكن أكل اللحم في بعض الأحيان منافيا له.
ويقتصر من (اللباس) بعد كونه من القطن أو الصوف على ما يستر الأعضاء و يحفظها من الحر و البرد و لا بأس بكونه اثنين ليلبس الآخر عند غسل أحدهما , و من (المسكن) على ما يحفظ نفسه و أهله من الحر و البرد , و من (أثاثه) أعني الفرش و الظرف و القدر و الكوز و أمثال ذلك ، ما يدفع حاجته من غير تعد إلى ما يمكن زوال ضرورته بدونه , و من (المنكح) على ما تنكسر به سورة شبقة و يحفظه عن النظر و الوساوس الشهوية المانعة عن الحضور في العبادات و من (المال) على ما يقتضي به حاجة يومه بليلته فإن كان كاسبا فإذا اكتسب حاجة يومه فليترك كسبه و يشتغل بأمر الدين ، و إن كانت له ضيعة و لم يكن له مدخل آخر يمكن أن يصل إليه كل يوم قدر حاجته فيه فالظاهر عدم خروجه عن الزهد بإمساك قدر ما يكفي لسد رمقه بسنة واحدة بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل من كفاية نفقته , و ربما قيل إن مثله من ضعفاء الزهاد ، بمعنى أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة من المقامات العالية و الدرجات الرفيعة لا يناله ، و إن صدق عليه كونه زاهدا ، إذ مثله ليس له قوة اليقين ، لأن صاحب اليقين الواقعي إذا كان له قوت يومه لا يدخر شيئا لغده و من شرط التوكل في الزهد ، فلا يكون هذا من الزهاد عنده , و هذا غاية الزهد في الأمور المذكورة ، و عليه جرت طوائف الأنبياء و زمرة الأوصياء و من بعدهم من السلف الأتقياء , و الحق أن حكم الزهد فيها يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات فإن أمر المتفرد في جميع ذلك أخف من أمر المعيل ، و من قصر جميع همه على تحصيل العلم والعمل و لم يقدر على كسب ، حاله يخالف حال أهل الكسب ، وكذا في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن يمكن تحصيل قدر الحاجة في كل يوم و في بعض آخر منها لا يمكن ذلك ، فاللائق لكل أحد أن يلاحظ حاله و وقته و مكانه و يتأمل في أن الأصلح بأمر آخرته و الأعون على تحصيل ما خلق لأجله إمساك أي قدر من المال وصرف أي قدر و جنس من القوت ، بحيث لو كان أقل منه لم يتمكن من تحصيل ما يقربه إلى ربه فيأخذ به و يترك الزائد ، فإن بعد صحة النية و خلوص القصد في ذلك لا يخرج به عن الزهد الواقعي و إن تصور الاكتفاء بأقل من ذلك مع إيجابه لفقد ما هو أهم في تكميل النفس.
وأما (الجاه) فقد تقدم أن القدر الضروري منه في أمر المعيشة كتحصيل منزلة في قلب خادمه ليخدمه ، و في قلب السلطان ليدفع الأشرار عنه ، لا بأس به ، فالظاهر عدم منافاة هذا القدر للزهد ، و قال بعض العلماء : (هذا القدر و إن لم يكن به بأس إلا أنه يتمادى إلى هاوية لا عمق لها و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) و إنما يحتاج إلى المحل في القلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضرر أو لخلاص من ظلم ، أما النفع فيغني عنه المال فإن من يخدم بأجرة يخدم و إن لم يكن لمستأجره عنده قدر، و إنما يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة ، و معلوم أن من أراد أن يخدم بغير أجرة فهو من الظالمين فكيف يكون من الزاهدين , و أما دفع الضرر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل العدل فيها و أن يكون بين جيران يظلمونه ولا يقدر على دفع شرهم إلا بمحل له في القلوب أو محل له عند السلطان , و قدر الحاجة فيه لا ينضبط لا سيما إذا انضم إليه الخوف و سوء الظن بالعواقب ، و الخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك ، بل حق الزاهد ألا يسعى لطلب المحل في القلوب أصلا ، فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له من المحل في القلوب ما يدفع عنه الأذى و لو كان بين الكفار فكيف بين المسلمين , و أما التوهمات و التقديرات التي تخرج إلى الزيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب فهي أوهام كاذبة ، إذ من طلب الجاه أيضا لم يخل عن أذى في بعض الأوقات فعلاج ذلك بالاحتمال و الصبر أولى من علاجه بطلب الجاه ، فإذن طلب المحل في القلوب لا رخصة فيه أصلا و اليسير منه داع إلى الكثير و ضراوته أشد من ضراوة الخمر فليحترز من قليله و كثيره ، نعم ما أعطاه اللّه لبعض عبيده من دون سعيه في طلبه لنشر دينه أو لاتصافه ببعض الكمالات المختصة لحصول منزلة له في القلوب فليس به بأس ولا ينافي الزهد ، فإن جاه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كان أوسع الجاه مع كونه أزهد الناس.
والحق كما تقدم أن الجاه كالمال في نفي البأس من قدر يضطر إليه الإنسان إذا وقع في زمان أو بلد توقف أمر معيشته عليه ، فالقدر الضروري منهما غير محذور و غير مناف للزهد ، و الزائد على الحاجة سم قاتل ، فلا ينبغي أن ينسب المقتصر على الضرورة إلى الدنيا ، بل ذلك القدر من الدين لأنه من شرطه و الشرط من جملة المشروط ، و يدل عليه ما روي أن إبراهيم (عليه السلام) أصابته حاجة فذهب إلى صديق له يستقرض شيئا فلم يقرضه فرجع مهموما فأوحى اللّه تعالى إليه : (لو سألت خليلك لأعطاك) ، فقال يا رب : (عرفت مقتك للدنيا فخفت أن أسألك منها) ، فأوحى اللّه إليه : (ليس الحاجة من الدنيا) , ويدل عليه أيضا كلام الصادق (عليه السلام) مع سفيان الثوري كما أورده بطوله شيخنا الأقدم رحمه اللّه في جامعه الكافي.
فإذن قدر الحاجة من الدين وما وراءه وبال في الآخرة ، بل في الدنيا أيضا ، و يعرف ذلك بالتأمل في أحوال الأغنياء و ما عليهم من المحنة في كسب المال و جمعه و حفظه و تحمل الذل فيه ، و غاية سعادته أن يتركه لورثته، فيأكلونه و هم أعداؤه ، أو يستعينون به على المعصية فيكون معينا لهم عليها ، و لذلك شبه جامع الدنيا و تابع الشهوات بدود القز، لا يزال ينسج على نفسه حتى يقتلها ، ثم يروم الخروج فلا يجد مخلصا فيموت و يهلك بسبب العمل الذي عمله بنفسه كما قيل في ذلك :
ألم تر أن المرء طول حياته معنى بأمر لا يزال يعالجه
كدود كدود القز ينسج دائما و يهلك غما وسط ما هو ناسجه
فكل مكب على الدنيا متبع للشهوات لا يزال يقيد نفسه بسلاسل و أغلال لا يقدر على قطعها إلى أن يفرق ملك الموت بينه و بين شهواته دفعة ، فتبقى السلاسل من قلبه معلقة بالدنيا التي فاتته و خلفها ، و هي تجاذبه إلى الدنيا ، و مخالب ملك الموت قد تعلقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة فأهون أحواله عند الموت أن يكون مثل شخص ينشر بالمناشير و يفصل أحد جانبه عن الآخر , فهذا أول عذاب يلقاه قبل ما يراه من حسرات نزوله في أسفل السافلين و منعه عن أعلى عليين و جوار رب العالمين , فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء اللّه ، و عند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم ، إذ النار لكل محجوب معدة ، كما قال اللّه تعالى : {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ} [المطففين: 15، 16].
ولما انكشف لأرباب القلوب أن العبد يهلك نفسه باتباع الهوى و الخوض في الدنيا إهلاك دود القز نفسه ، رفضوا الدنيا بالكلية , فنسأل اللّه تعالى أن يقرر في قلوبنا ما نفث في روع حبيبه (صلى اللّه عليه و آله) حيث أوحى إليه : «أحبب ما أحببت ، فإنك مفارقه».
(الثالث) اعتبار المرغوب فيه : أعني ما يترك لأجله.
وله بهذا الاعتبار ثلاث درجات , الأولى : أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار و سائر عذاب الآخرة ، و هذا زهد الخائفين , الثانية : أن يكون ثواب اللّه و نعيم الجنة ، وهذا زهد الراجين , الثالثة : و هي الدرجة العليا : ألا تكون له رغبة إلا في اللّه و في لقائه ، فلا يلتفت إلى الآلام ليقصد منها الخلاص و لا إلى اللذات ليقصد نيلها ، بل كان مستغرق الهم باللّه ، و هذا زهد العارفين ، لأنه لا يحب اللّه خاصة إلا من عرفه بصفاته الكمالية , فكما أن من عرف الدينار و الدرهم ، و علم أنه لا يقدر على الجمع بينهما ، لم يحب إلا الدينار, كذلك من عرف اللّه ، و عرف لذة النظر إلى وجهه الكريم و عرف أن الجمع بين تلك اللذة و لذة التنعم بالحور العين و النظر إلى القصور و خضرة الأشجار غير ممكن، فلا يحب إلا لذة النظر و لا يؤثر غيره.
وقال بعض العرفاء : و لا تظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه اللّه تعالى يبقى للذة الحور و القصور متسع في قلوبهم ، بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم الجنة ، كلذة ملك الدنيا و الاستيلاء على أطراف الأرض و رقاب الخلق ، بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور و اللعب به و الطالبون لنعيم الجنة ، عند أهل المعرفة و أرباب القلوب ، كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك ، و ذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك , لا لأن اللعب بالعصفور في نفسه أعلى و ألذ من الاستيلاء بطريق الملك على كافة الخلق.
 الاكثر قراءة في الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الاكثر قراءة في الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












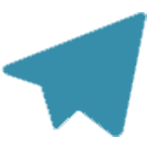
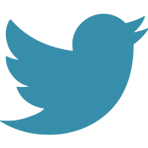

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)