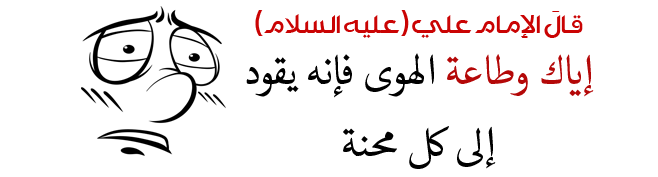
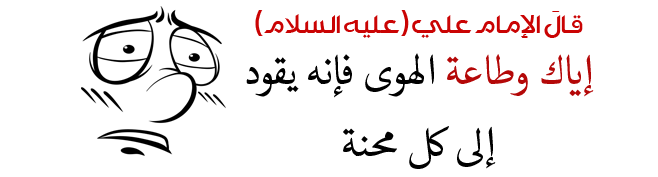

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-8-2019
التاريخ: 10-8-2019
التاريخ: 7-8-2019
التاريخ: 13-8-2019
|
قال تعالى : { لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [التوبة : 25 - 27] .
تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآيات (1) :
لما تقدم أمر المؤمنين بالقتال ، ذكرهم بعده بما أتاهم من النصر ، حالا بعد حال ، فقال : {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة} اللام : للقسم ، فكأنه سبحانه قسم بأنه نصر المؤمنين أي : أعانهم على أعدائهم في مواضع كثيرة ، على ضعفهم وقلة عددهم ، حثا لهم على الانقطاع إليه ، ومفارقة الأهلين والأقربين في طاعته .
وورد عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا : كانت المواطن ثمانين موطنا . وروي أن المتوكل اشتكى شكاية شديدة ، فنذر أن يتصدق بمال كثير إن شفاه الله ، فلما عوفي سأل العلماء عن حد المال الكثير ، فاختلفت أقوالهم ، فأشير عليه أن يسأل أبا الحسن ، علي بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام ، وقد كان حبسه (2) في داره ، فأمر أن يكتب إليه ، فكتب يتصدق بثمانين درهما ، ثم سألوه عن العلة في ذلك ، فقرأ هذه الآية ، وقال : عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين موطنا .
{ويوم حنين} أي : وفي يوم حنين {إذ أعجبتكم كثرتكم} أي : سرتكم ، وصرتم معجبين بكثرتكم . قال قتادة : وكان سبب انهزام المسلمين يوم حنين ، ان بعضهم قال حين رأى كثرة المسلمين : لن نغلب اليوم عن قلة! فانهزموا بعد ساعة ، وكانوا اثني عشر ألفا . وقيل : إنهم كانوا عشرة آلاف . وقيل : ثمانية آلاف . والأول أصح وأكثر في الرواية {فلم تغن عنكم شيئا} أي : فلم يدفع عنكم كثرتكم سوءا ، {وضاقت عليكم الأرض بما رحبت} أي : برحبتها . والباء بمعنى مع ، والمعنى :
ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ، كما يقال اخرج بنا إلى موضع كذا أي : معنا ، والمراد : لم تجدوا من الأرض موضعا للفرار إليه ، {ثم وليتم مدبرين} أي : وليتم عن عدوكم منهزمين ، وتقديره وليتموهم أدباركم ، وانهزمتم {ثم أنزل الله سكينته} أي : رحمته التي تسكن إليها النفس ، ويزول معها الخوف {على رسوله وعلى المؤمنين} حين رجعوا إليهم وقاتلوهم . وقيل : على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله ، علي والعباس في نفر من بني هاشم ، عن الضحاك بن مزاحم . وروى الحسن بن علي بن فضال : عن أبي الحسن الرضا أنه قال : السكينة ريح من الجنة تخرج طيبة ، لها صورة كصورة وجه الانسان ، فتكون مع الأنبياء . أورده العياشي مسندا .
{وأنزل جنودا لم تروها} أراد به جنودا من الملائكة . وقيل : إن الملائكة نزلوا يوم حنين بتقوية قلوب المؤمنين وتشجيعهم ، ولم يباشروا القتال يومئذ ، ولم يقاتلوا إلا يوم بدر خاصة ، عن الجبائي . {وعذب الذين كفروا} بالقتل ، والأسر ، وسلب الأموال ، والأولاد ، {وذلك جزاء الكافرين} أي : وذلك العذاب جزاء الكافرين على كفرهم ، {ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء} : ذكر سبحانه ثم في ثلاثة مواضع متقاربة الأول . {ثم وليتم مدبرين} عطف على ما قبله من الفعل ، وهو قوله {ضاقت عليكم} والثاني : {ثم أنزل الله سكينته} عطف على {وليتم مدبرين} .
والثالث : {ثم يتوب الله} عطف على {أنزل} ، وإنما حسن عطف المستقبل على الماضي ، لأن يشاكله ، فإن الأول تذكير بنعمة الله ، والثاني وعد بنعمة الله .
والمعنى ثم يقبل الله توبة من تاب عن الشرك ، ورجع إلى طاعة الله والإسلام ، وندم على ما فعل من القبيح . ويجوز أن يريد : ثم يقبل الله توبة من انهزم من بعد هزيمته . ويجوز أن يريد : يقبل توبتهم عن اعجابهم بالكثرة ، وإنما علقه بالمشيئة لأن قبول التوبة تفضل من الله ، ولو كان واجبا على ما قاله أهل الوعيد لما جاز تعليقه بالمشيئة ، كما لا يجوز تعليق الثواب على الطاعة بالمشيئة ، ومن خالف في ذلك قال : إنما علقها بالمشيئة لأن منهم من له لطف يصلح به ، ويتوب ويؤمن عنده ، ومنهم من لا لطف له منه {والله غفور} أي : ستار للذنوب {رحيم} بعباده .
____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج5 ، ص 31-33 .
2 . وفي نسخة مخطوطة (وقد كان حينئذ) .
تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنيه في تفسير هذه الآيات (1) :
قصة حنين :
حنين واد بين مكة والطائف ، وتسمى غزوته بغزوة حنين ، وغزوة أو طاس وغزوة هوازن ، وكانت في شوال سنة ثمان للهجرة .
لما فتح النبي ( صلى الله عليه وآله ) مكة خافته هوازن وثقيف ، فجمعوا لحربه الألوف ، وبلغ رسول اللَّه ما أجمعوا عليه ، فتهيأ للقائهم باثني عشر ألف رجل ، عشرة من أصحابه الذين فتح بهم مكة ، وألفان من الطلقاء ، ومنهم أبو سفيان وابنه معاوية .
وتوجه النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى هوازن ، وكان طريقه على وادي حنين ، وكان ضيقا منحدرا ، وكان جيش العدو قد سبقهم إلى احتلال مضايقه ، وكمن فيها ، وما ان وصل المسلمون إلى قلب الوادي ، حتى أمطرهم العدو بوابل من سهامه ، فانهزم الناس ، وأولهم أبو سفيان . قال الشيخ الغزالي في فقه السيرة : « وعاد إلى بعضهم كفره باللَّه ورسوله ، فقال أبو سفيان : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ، ولا عجب فإن الأزلام التي كان يستقسم بها في جاهليته لا تزال في كنانته » .
وثبت مع رسول اللَّه علي شاهرا سيفه بين يدي رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله ) والعباس آخذا بلجام بغلته ، والفضل بن العباس عن يمين النبي ، والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب وزيد بن أسامة ، وأيمن بن أم أيمن ، وقتل بين يدي الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . وحين رأى المشركون انهزام المسلمين خرجوا من شعاب الوادي ، وقصدوا رسول اللَّه ، فقال لعمه العباس ، وكان جهوري الصوت : ناد القوم ، وذكرهم العهد ، فنادى بأعلى صوته : يا أهل بيعة الشجرة ، يا أصحاب سورة البقرة أين تفرون ؟
اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول اللَّه ، فلما سمع الأنصار نداء العباس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم ، وهم يقولون : لبيك ، لبيك فاستقبل بهم النبي الأعداء واقتتل الفريقان قتالا شديدا .
وكان حامل راية المشركين وطليعتهم رجل يدعى أبا جرول ، فكان يكر على المسلمين وينال منهم ، فبرز له علي بن أبي طالب وقتله ، وبقتله تفرقت جموع المشركين ، وتم النصر للنبي والمؤمنين ، ولما علم الطلقاء بانتصار المسلمين وكثرة الغنائم رجعوا إلى رسول اللَّه . وفي تفسير البحر المحيط ان الطلقاء فروا وقصدوا بذلك إلقاء الهزيمة في المؤمنين . وقال الشرقاوي في كتاب ( محمد رسول الحرية ) :
« إن ألفين من قريش ، على رأسهم أبو سفيان أسلموا خوفا أو طمعا قد جاؤوا اليوم لا لينصروا الإسلام ، بل ليخذلوه ، وليشيعوا الانهزام بين المجاهدين القدماء ! ! » .
وهكذا المنافقون والانتهازيون يتظاهرون بالإخلاص ، ويندسون في صفوف الأحرار يدبرون المؤامرات ، فان نجحت بلغوا ما يريدون ، وان نجح الأحرار قالوا لهم : نحن وأنتم شركاء . وتقدم الكلام عن هؤلاء في ج 2 ص 466 .
{ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ } منها وقعة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة : { ويَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ } قال الرازي : « ان رجلا من المسلمين قال : لن نغلب اليوم من قلة ، فساء ذلك رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل : انه هو قالها ، وقيل : قالها أبو بكر ، واسناد هذه الكلمة إلى الرسول بعيد » .
{ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وضاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ } .
فمن الاعجاب بالكثرة إلى أبشع الهزائم التي لم يجدوا معها في الأرض مكانا ينجيهم من عدوهم ، وهذه نهاية كل من تاه بغروره ، واستهان بعدوه .
{ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُؤْمِنِينَ } السكينة الثقة والاطمئنان ، ومعنى إنزالها على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقاؤه ثابتا في قلب المعركة ساكن الجأش ، شديد البأس يدبر الأمر ويحكمه على الرغم من فرار جيشه الذي بلغ 12 ألفا إلا نفرا لا يتجاوزون العشرة ، وجيش العدو يعد بالألوف . . قال الرواة : كان النبي يدفع ببغلته نحو العدو ولا يبالي ، وهو ينادي المنهزمين ، ويقول : إلي عباد اللَّه أنا رسول اللَّه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب . . والمؤمنون الذين أنزل اللَّه سكينته عليهم هم الذين ثبتوا مع رسول اللَّه ولم يفروا عنه ، والذين عادوا إلى المعركة بعد الهزيمة ، واستجابوا لنداء النبي مخلصين ، ومعنى إنزال السكينة عليهم تسكين قلوبهم ، وإزالة الخوف والرعب منها .
{ وأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها } قال الرازي : « لا خلاف ان المراد إنزال الملائكة » . أما نحن فنعتقد ان للَّه جنودا من الملائكة وغير الملائكة لا تحصى أنواعها فكيف أفرادها ! . ومن تلك الأنواع قوى النفس وغرائزها ، ومنها قوى خارجية ، والآية لم تبين نوع هذه الجنود التي أنزلها اللَّه يوم حنين ، لذلك نترك علمها للَّه الذي قال : { وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ } [المدثر - 31] . { وعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ } عذبهم في الدنيا بالقتل والأسر والهزيمة وأخذ الأموال ، وعذبهم في الآخرة بنار جهنم وسوء المصير .
{ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . ان اللَّه كريم لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم ، وبابه مفتوح لكل طارق ، فمن فر عن رسول اللَّه من المسلمين ، ثم تاب فان اللَّه يحب التوابين ، ومن كفر وحارب اللَّه ورسوله ، ثم تاب وآمن وعمل صالحا فهو من المفلحين . قال المؤرخون : بعد ان انتهت المعركة ، ووزعت الغنائم جاء وفد من هوازن مسلما ، وقالوا : يا رسول اللَّه أنت خير الناس وأبرّهم ، وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج4 ، ص 24-27 .
تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآيات (1) :
قوله تعالى : ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين - إلى قوله - ثم وليتم مدبرين﴾ المواطن جمع موطن وهو الموضع الذي يسكنه الإنسان ويتوطن فيه .
وحنين اسم واد بين مكة والطائف وقع فيه غزوة حنين قاتل فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هوازن وثقيف وكان يوما شديدا على المسلمين انهزموا أولا ثم أيدهم الله بنصره فغلبوا .
والإعجاب الإسرار والعجب سرور النفس بما يشاهده نادرا ، والرحب السعة في المكان وضده الضيق .
وقوله : ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ ذكر لنصرته تعالى لهم في مواطن كثيرة ومواضع متعددة يدل السياق على أنها مواطن الحروب كوقائع بدر وأحد والخندق وخيبر وغيرها ، ويدل السياق أيضا أن الجملة كالمقدمة الممهدة لقوله : ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ الآية فإن الآيات الثلاث مسوقة لتذكير قصة وقعة حنين ، وعجيب ما أفاض الله عليهم من نصرته وخصهم به من تأييده فيها .
وقد استظهر بعض المفسرين كون الآية وما يتلوها إلى تمام الآيات الثلاث تتمة لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما أمره ربه أن يواجه به المؤمنين في قوله : ﴿قل إن كان آباؤكم﴾ الآية وتكلف في توجيه الفصل الذي في قوله : ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ .
ولا دليل من جهة اللفظ على ذلك بل الدليل على خلافه فإن قصة حنين وما يشتمل عليه من الامتنان بنصر الله وإنزال السكينة وإنزال الجنود وتعذيب الكافرين والتوبة على من يشاء أمر مستقل في نفسه ذو أهمية في ذاته وهو أهم هدفا من قوله تعالى : ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم﴾ الآية أو هو مثله لا يقصر عنه فلا معنى لاتباعه إياه وعطفه عليه في المعنى .
وحينئذ لو كان مما يجب أن يخاطب به القوم لكان من الواجب أن يقال .
وقل لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الآية ، على ما جرى عليه القرآن في نظائره كقوله تعالى : ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد - إلى أن قال - قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين﴾ [حم السجدة : 9] وغيره من الموارد .
على أن سياق الآيات وما يجب أن تشتمل عليه من الالتفات وغيره - لو كانت الآيات مقولة للقول - لا تلائم كونها مقولة للقول السابق .
والخطاب في قوله : ﴿لقد نصركم الله﴾ وما يتلوه من قوله : ﴿إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ الآية ، للمسلمين وهم الذين يؤلفون مجتمعا إسلاميا واحدا حضروا بوحدتهم هذه الوحدة أمثال وقائع بدر وأحد والخندق وخيبرا وحنينا وغيرها .
وهؤلاء فيهم المنافقون والضعفاء في الإيمان والمؤمنون صدقا على اختلافهم في المنازل إلا أن الخطاب متوجه إلى الجميع باعتبار اشتماله على من يصح أن يخاطب بمثل قوله : ﴿إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ إلى آخر الآية .
وقوله : ﴿ويوم حنين﴾ أي ويوما وقعت فيه القتال بينكم وبين أعدائكم بوادي حنين ، وإضافة اليوم إلى أمكنة الوقائع العظيمة شائع في العرف كما يقال : يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق نظير إضافته إلى الجماعة المتلبسين بذلك كيوم الأحزاب ويوم تميم ، وإضافته إلى نفس الحادثة كيوم فتح مكة .
وقوله : ﴿إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ أي أسرتكم الكثرة التي شاهدتموها في أنفسكم فانقطعتم عن الاعتماد بالله والثقة بأيده وقوته واستندتم إلى الكثرة فرجوتم أن ستدفع عنكم كيد العدو وتهزم جمعهم ، وإنما هو سبب من الأسباب الظاهرية لا أثر فيها إلا ما شاء الله الذي إليه تسبيب الأسباب .
وبالنظر إلى هذا المعنى أردف قوله : ﴿إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ بقوله : ﴿فلم تغن عنكم شيئا﴾ أي اتخذتموها سببا مستقلا دون الله فأنساكم الاعتماد بالله ، وركنتم إليها فبان لكم ما في وسع هذا السبب الموهوم وهو أن لا غنى عنده حتى يغنيكم فلم يغن عنكم شيئا لا نصرا ولا شيئا آخر .
وقوله : ﴿وضاقت عليكم الأرض بما رحبت﴾ أي مع ما رحبت ، وهو كناية عن إحاطة العدو بهم إحاطة لا يجدون مع ذلك مأمنا من الأرض يستقرون فيه ولا كهفا يأوون إليه فيقيهم من العدو ، أي فررتم فرارا لا تلوون على شيء .
فهو قريب المعنى من قوله تعالى في قصة الأحزاب : ﴿إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا﴾ [الأحزاب : 10] .
وقول بعضهم : أي ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا موضعا تفرون إليه .
غير سديد .
وقوله : ﴿ثم وليتم مدبرين﴾ أي جعلتم العدو يلي أدباركم وهو كناية عن الانهزام وهذا هو الفرار من الزحف ساقهم إليه اطمئنانهم بكثرتهم والانقطاع من ربهم ، قال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره - إلى أن قال - فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير : ﴾ [الأنفال : 16] وقال : ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا﴾ [الأحزاب : 15] .
فهذا كله أعني ضيق الأرض عليهم بما رحبت ثم انهزامهم وفرارهم من الزحف على ما فيه من كبير الإثم ، ووقوفهم هذا الموقف الذي يستتبع العتاب من ربهم إنما ساقهم إليه اعتمادهم واطمئنانهم إلى هذه الأسباب السرابية التي لا تغني عنهم شيئا .
والله سبحانه بسعة رحمته وعظم منه امتن عليهم بنصره وإنزال سكينته وإنزال جنود لم يروها ، وتعذيب الكافرين ووعد مجمل بمغفرته وعدا ليس بالمقطوع وجوده حتى تبطل به صفة الخوف من قلوبهم ، ولا بالمقطوع عدمه حتى تزول صفة الرجاء من نفوسهم بل وعدا يحفظ فيهم الاعتدال والتوسط بين صفتي الخوف والرجاء ، ويربيهم تربية حسنة تعدهم وتهيئهم للسعادة الواقعية .
وقد أغرب بعض المفسرين في تفسير الآية مستظهرا بما جمع به بين الروايات على اختلافها فأصر على ما ملخصه أن المسلمين لم يفروا على جبن ، وإنما انكشفوا عن موضعهم لما فاجأهم من شد كتائب ثقيف وهوازن عليهم شد رجل واحد فاضطربوا اضطرابة زلزلتهم وكشفتهم عن موضعهم دفعة واحدة وهذا أمر طبيعي في الإنسان إذا فاجأه الخطر ودهمته بلية دفعة ومن غير مهل اضطربت نفسه وخلي عن موضعه . ويشهد به نزول السكينة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليهم جميعا فقد كان الاضطراب شمله وإياهم جميعا ، غير أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أصابه ما أصابه من الاضطراب والقلق حزنا وأسفا مما وقع ، والمسلمون شملهم ذلك لما فوجئوا به من حملة الكتائب حملة رجل واحد .
ومن الشواهد أنهم بمجرد ما سمعوا نداء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ونداء العباس بن عبد المطلب رجعوا من فورهم وهزموا الكفار بالسكينة النازلة عليهم من عند الله تعالى .
ثم ذكر ما نزل من الآيات في صفة الصحابة كآية بيعة الرضوان ، وقوله تعالى : ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾ الآية ، وقوله : ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾ الآية ، وما ورد من طريق الرواية في مدح صحابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
والذي أورده من الخلط بين البحث التفسيري الذي لا هم له إلا الكشف عما يدل عليه الآيات الكريمة ، وبين البحث الكلامي الذي يرام به إثبات ما يدعيه المتكلم في شيء من المذاهب من أي طريق أمكن من عقل أو كتاب أو سنة أو إجماع أو المختلط منها والبحث التفسيري لا يبيح لباحثه شيئا من ذلك ، ولا تحميل أي نظر من الأنظار العلمية على الكتاب الذي أنزله الله تبيانا .
أما قوله : ﴿إنهم لم يفروا جبنا ولا خذلانا للنبي﴾ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وإنما كان انكشافا لأمر فاجأهم فاضطربوا وزلزلوا ففروا ثم كروا فهذا مما لا يندفع به صريح قوله تعالى : ﴿ثم وليتم مدبرين﴾ مع اندراج هذا الفعل منهم تحت كلية قوله تعالى في آية تحريم الفرار من الزحف : ﴿فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره - إلى أن قال - فقد باء بغضب من الله﴾ الآية .
ولم يقيد سبحانه النهي عن تولية الأدبار بأنه يجب أن يكون عن جبن أو لغرض الخذلان ، ولا أستثني من حكم التحريم كون الفرار عن اضطراب مفاجئ ، ولا أورد في استثنائه إلا ما ذكره بقوله : ﴿إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة﴾ وليس هذان المستثنيان في الحقيقة من الفرار من الزحف .
ولم يورد تعالى أيضا فيما حكي من عهدهم شيئا من الاستثناء إذ قال : ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا﴾ [الأحزاب : 15] .
وأما استشهاده على ذلك بأن الاضطراب كان مشتركا بينهم وبين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واستدلاله على ذلك بقوله تعالى : ﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ حيث إن نزول السكينة بعد انكشافهم بزمان - على ما تدل عليه كلمة ثم - يلازم نزول الاضطراب عند ذلك على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كان عن حزن وأسف إذ لا يتصور في حقه (صلى الله عليه وآله وسلم) التزلزل في ثباته وشجاعته .
فلننظر فيما اعتبره للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الحزن والأسف هل كان ذلك حزنا وأسفا على ما وقع من الأمر من انهزام المسلمين وما ابتلاهم الله به من الفتنة والمحنة جزاء لما أعجبوا من كثرة عددهم ، وبالجملة حزنا مكروها عند الله؟ فقد نزهه الله عن ذلك وأدبه بما نزل عليه من كتابه وعلمه من علمه ، وقد أنزل عليه مثل قوله عز من قائل : ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ آل عمران : 128 ، وقال : ﴿سنقرئك فلا تنسى﴾ [الأعلى : 6] .
ولم يرد في شيء من روايات القصة أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) زال عن مكانه يومئذ أو اضطرب اضطرابا مما نزل على المسلمين من الوهن والانهزام .
وإن كان ذلك حزنا وأسفا على المسلمين لما أصابهم من ناحية خطئهم في الاعتماد بغير الله والركون إلى سراب الأسباب الظاهرة ، والذهول عن الاعتصام بالله سبحانه حتى أوقعهم في خطيئة الفرار من الزحف لما كان هو (صلى الله عليه وآله وسلم) عليه من الرأفة والرحمة بالمؤمنين فهذا أمر يحبه الله سبحانه وقد مدح رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) به إذ قال : ﴿بالمؤمنين رءوف رحيم﴾ [التوبة : 128] .
وليس يزول مثل هذا الأسف والحزن بنزول السكينة عليه ، ولا أن السكينة لو فرض نزولها لأجله مما حدث بعد وقوع الانهزام حتى يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاليا عنها قبل ذلك بل كان (صلى الله عليه وآله وسلم) على بينة من ربه منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه ، وكانت السكينة بهذا المعنى نازلة عليه حينا بعد حين . ثم السكينة التي نزلت على المؤمنين ما هي؟ وما ذا يحسبها؟ أكانت هي الحالة النفسانية التي تحصل من السكون والطمأنينة كما فسرها بها واستشهد عليه بقول صاحب المصباح : أنها تطلق على الرزانة والمهابة والوقار حتى كانت ثبات الكفار وسكونهم في مواقفهم الحربية عن سكينة نازلة إليهم؟ فإن كانت السكينة هي هذه فقد كانت في أول الوقعة عند كفار هوازن وثقيف خصماء المسلمين ثم تركتهم ونزلت على عامة جيش المسلمين من مؤمن ثبت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن مؤمن لم يثبت واختار الفرار على القرار ، ومن منافق ومن ضعيف الإيمان مريض القلب فإنهم جميعا رجعوا ثانيا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وثبتوا معه حتى هزموا العدو فهم جميعا أصحاب السكينة أنزلها الله إليهم فما باله تعالى يقصر إنزال السكينة على رسوله وعلى المؤمنين إذ يقول : ﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ .
على أنه إن كانت السكينة هي هذه ، وهي مبتذلة مبذولة لكل مؤمن وكافر فما معنى ما امتن الله به على المؤمنين بما ظاهره أنها عطية خاصة غير مبتذلة؟ ولم يذكرها في كلامه إلا في موارد معدودة - بضعة موارد - لا تبلغ تمام العشرة .
وبذلك يظهر أن السكينة أمر وراء السكون والثبات لا أن لها معنى في اللغة أو العرف وراء مفهوم الحالة النفسانية الحاصلة من السكون والطمأنينة بل بمعنى أن الذي يريده تعالى من السكينة في كلامه له مصداق غير المصداق الذي نجده عند كل شجاع باسل له نفس ساكنة وجاش مربوط ، وإنما هي نوع خاص من الطمأنينة النفسانية له نعت خاص وصفة مخصوصة .
كيف؟ وكلما ذكرها الله سبحانه في كلامه امتنانا بها على رسوله وعلى المؤمنين خصها بالإنزال من عنده فهي حالة إلهية لا ينسى العبد معها مقام ربه لا كما عليه عامة الشجعان أولوا الشدة والبسالة المعجبون ببسالتهم المعتمدون على أنفسهم .
وقد احتفت في كلامه بأوصاف وآثار لا تعم كل وقار وطمأنينة نفسانية كما قال في حق رسوله : ﴿إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها﴾ [التوبة : 40] وقال تعالى في المؤمنين ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم﴾ [الفتح : 18] فذكر أنه إنما أنزل السكينة عليهم لما علمه من قلوبهم فنزولها يحتاج إلى حالة قلبية طاهرة سابقة يدل السياق على أنها الصدق ونزاهة القلب عن إبطان نية الخلاف .
وقال أيضا : ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض﴾ [الفتح : 4 ] فذكر أن من أثرها زيادة الإيمان مع الإيمان وقال أيضا : ﴿إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها﴾ [الفتح : 26] .
والآية - كما ترى - تذكر أن نزول السكينة من عنده تعالى مسبوق باستعداد سابق وأهلية وأحقية قبلية وهو الذي أشير إليه في الآية السابقة بقوله : ﴿فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة﴾ .
وتذكر أن من آثارها لزوم كلمة التقوى ، وطهارة ساحة الإنسان عن مخالفة الله ورسوله باقتراف المحارم وورود المعاصي .
وهذا كالمفسر يفسر قوله في الآية الأخرى : ﴿ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾ فازدياد الإيمان مع الإيمان بنزول السكينة هو أن يكون الإنسان على وقاية إلهية من اقتراف المعاصي وهتك المحارم مع إيمان صادق بأصل الدعوة الحقة .
وهذا نعم الشاهد يشهد أولا : أن المراد بالمؤمنين في قوله في الآية المبحوث عنها ﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ غير المنافقين وغير مرضى القلوب وضعفاء الإيمان ، ولا يبقى إلا من ثبت من المؤمنين مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهم ثلاثة أو أربعة أو تسعة أو عشرة أو ثمانون أو دون المائة على اختلاف الروايات في إحصائهم ، ومن فر وانكشف عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولا ثم رجع وقاتل ثانيا وفيهم جل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدة من خواصهم .
فهل المراد بالمؤمنين الذين نزلت عليهم ، جميع من ثبت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن فر أولا ثم رجع ثانيا ، أو أنهم هم الذين ثبتوا معه من المؤمنين حتى نزل النصر؟ .
الذي يستفاد من آيات السكينة أن نزولها متوقف على طهارة قلبية وصفاء نفسي سابق حتى يقرها الله تعالى بالسكينة ، وهؤلاء كانوا مقترفين لكبيرة الفرار من الزحف آثمين قلوبا ، ولا محل لنزول السكينة على من هذا شأنه فإن كانوا ممن نزلت عليهم السكينة كان من الواجب أن يندموا على ما فعلوا ، ويتوبوا إلى ربهم توبة نصوحا بقلوب صادقة حتى يعلم الله ما في قلوبهم فينزل السكينة عليهم فيكونون أذنبوا أولا ثم تابوا ورجعوا ثانيا ، فأنزل الله سكينته عليهم ونصرهم على عدوهم ، ولعل هذا هو الذي يشير إليه التراخي المفهوم من قوله تعالى ﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ حيث عبر بثم .
لكن يبقى عليه أولا : أنه كان من اللازم على هذا أن يتعرض في الكلام لتوبتهم فيختص حينئذ قوله : ﴿ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم﴾ على الكفار الذين أسلموا بعد منهم ، ولا أثر من ذلك في الكلام ولا قرينة تخص قوله : ﴿ثم يتوب الله﴾ إلخ بالكافرين الذين أسلموا بعد ، فافهم ذلك .
وثانيا : أن في ذلك غمضا عن جميل المسعى والمحنة الحسنة التي امتحن بها أولئك النفر القليل الذين ثبتوا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين تركه جموع المسلمين بين الأعداء وانهزموا فارين لا يلوون على شيء ، ومن المستبعد من دأب القرآن أن يهمل أمر من تحمل محنة في ذات الله ، وألقى نفسه في أشق المهالك ابتغاء مرضاته - وهو شاكر عليم - فلا يحمده ولا يشكر سعيه .
والمعهود من دأب القرآن أنه إذا عم قوما بعتاب أو توبيخ وذم ، وفيهم من هو بريء من استحقاق اللوم أو العتاب أو طاهر من دنس الإثم والخطيئة أن يستثنيه منهم ويخصه بجميل الذكر ، ويحمده على عمله وإحسانه كما نراه كثيرا في الخطابات التي تعمم اليهود أو النصارى عتابا أو ذما وتوبيخا فإنه تعالى يخاطبهم بما يخاطب ويوبخهم وينسب إليهم الكفر بآياته والتخلف عن أوامره ونواهيه ، ثم يمدح منهم الأقلين الذين آمنوا به وبآياته وأطاعوه فيما أراد منهم .
وأوضح من ذلك ما يتعرض من الآيات لوقعة أحد ، وتمتن على المؤمنين بما أنزل الله عليهم من النصرة والكرامة ، ويعاتبهم على ما أظهروه من الوهن والفشل ثم يستثني الثابتين منهم على أقدام الصدق ، ويعدهم وعدا حسنا إذ قال مرة بعد مرة : ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾ [آل عمران : 144] ، ﴿وسنجزي الشاكرين﴾ [آل عمران : 145] .
ونجد مثله في ما يذكره الله سبحانه من أمر وقعة الأحزاب فإن في كلامه عتابا شديدا لجمع من المؤمنين ، وتوبيخا وذما للمنافقين والذين في قلوبهم مرض حتى قال فيما قال : ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا﴾ [الأحزاب : 15] ، ثم إنه تعالى ختم القصة بمثل قوله : ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا﴾ [الأحزاب : 23] .
فما باله تعالى لم يتعرض لحالهم في قصة حنين ، وليست بأهون من غيرها ، ولا خصهم بشيء من الشكر ، ولا حمدهم بما يمتنون به من لطيف حمده تعالى كغيرهم في غيرها .
فهذا الذي ذكرناه مما يقرب إلى الاعتبار أن يكون المراد بالمؤمنين الذين ذكر نزول السكينة عليهم هم الذين ثبتوا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأما سائر المؤمنين ممن رجع بعد الانكشاف فهم تحت شمول قوله : ﴿ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم﴾ يشمل من شملته العناية منهم كما يشمل من شملته العناية والتوفيق من كفار هوازن وثقيف ومن الطلقاء والذين في قلوبهم مرض .
هذا ما يهدي إليه البحث التفسيري ، وأما الروايات فلها شأنها وسيأتي طرف منها .
وأما ما ذكره من شهادة رجوعهم من فورهم حين سمعوا نداء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونداء العباس فذلك مما لا يبطل ما قدمناه من ظهور قوله تعالى : ﴿ثم وليتم مدبرين﴾ إذا انضم إلى قوله : ﴿إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار﴾ الآية في أن ما ظهر منهم في الوقعة من الفعل كان فرارا من الزحف فعلوه عن جبن أو تعمد في خذلان أو عن قلق واضطراب وتزلزل .
وأما ما ذكره من الآيات التي تمدحهم وتذكر رضى الرب عنهم واستحقاقهم جزيل الأجر من ربهم .
ففيه أن هذه المحامد مقيدة فيها بقيود لا يتحتم معها لهم الأمر فإن الآيات إنما تحمد من تحمده منهم لما به من نعوت العبودية كالإيمان والإخلاص والصدق والنصيحة والمجاهدة الدينية فالحمد باق ما بقيت الصفات ، والوعد الحسن على اعتباره ما لبثت فيهم النعوت والأحوال الموجبة له فإذا زالت لحادثة أو خطيئة زال بتبعه .
وليس ما عندهم من مبادئ الخير والبركات بأعظم ولا أهم مما عند الأنبياء من صفة العصمة يستحيل معها صدور الذنب منهم ، وقد قال الله تعالى بعد ثناء طويل عليهم : ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون﴾ [الأنعام : 88] وقد قال تعالى قبال ما ظنوا أنهم مصونون عن ما يكرهونه من أقسام المجازاة كرامة لإسلامهم كما ظن نظيره أهل الكتاب : ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به﴾ [النساء : 123] .
والذي ورد في بيعة الرضوان من قوله : ﴿لقد رضي الله﴾ فإنما رضاه تعالى من صفاته الفعلية التي هي عين أفعاله الخارجية منتزعة منها فهو عين ما أفاض عليهم من الحالات الطاهرة النفسية التي تستعقب بطباعها جزيل الجزاء وخير الثواب إن بقيت أعمالهم على ما هي عليها وإن تغيرت تغير الرضى سخطا والنعمة نقمة ولم يأخذ أحد عليه تعالى عهدا أن لا يخلف عهده فيحمله على السعادة والكرامة أحسن أو أساء ، أطاع أو عصى ، آمن أو كفر .
وليس رضى الرب من صفاته الذاتية التي يتصف بها في ذاته فلا يعرضه تغير أو تبدل ولا يطرأ عليه زوال أو دثور .
قوله تعالى : ﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ إلى آخر الآية السكينة - كما تقدم - حالة قلبية توجب سكون النفس وثبات القلب ملازمة لازدياد الإيمان مع الإيمان ولكلمة التقوى التي تهدي إلى الورع عن محارم الله على ما تفسرها الآيات .
وهي غير العدالة التي هي ملكة نفسانية تردع عن ركوب الكبائر والإصرار على الصغائر فإن السكينة تردع عن الصغائر والكبائر جميعا .
وقد نسب الله السكينة في كتابه إلى نفسه نسبة تشعر بنوع من الاختصاص كما نسب الروح إلى نفسه دون العدالة ووصفها بالإنزال فلها اختصاص عندي به تعالى بل ربما يشعر بعض الآيات بأنه عدها من جنوده كقوله تعالى : ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض﴾ [الفتح : 4] .
وفي غير واحد من الآيات المشتملة على ذكر السكينة ذكر الجنود كقوله : ﴿فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها﴾ [التوبة : 40] ، وكما في الآية المبحوث عنها : ﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها﴾ . والذي يفهم من السياق أن هذه الجنود هي الملائكة النازلة إلى المعركة ، أو أن يقال من جملتها الملائكة النازلة والذي ينتسب إلى السكينة والملائكة أن يعذب بهم الكفار ويسدد ويسعد بهم المؤمنون كما اشتملت عليه آيات آل عمران القاصة قصة أحد ، وآيات في أول سورة الفتح فراجعها حتى يتبين لك حقيقة الحال إن شاء الله تعالى .
وقد تقدم في قوله تعالى : ﴿فيه سكينة من ربكم﴾ [البقرة : 248] في الجزء الثاني من الكتاب بعض ما يتعلق بالسكينة الإلهية من الكلام مما لا يخلو من نفع في هذا المقام .
قوله تعالى : ﴿ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم﴾ قد تقدم مرارا أن التوبة من الله سبحانه هي الرجوع إلى عبده بالعناية والتوفيق أولا ثم بالعفو والمغفرة ثانيا ، ومن العبد الرجوع إلى ربه بالندامة والاستغفار ، ولا يتوب الله على من لا يتوب إليه .
والإشارة في قوله : ﴿من بعد ذلك﴾ على ما يعطيه السياق إلى ما ذكره في الآيتين السابقتين من خطيئتهم بالركون إلى غير الله سبحانه ومعصيتهم بالفرار والتولي ثم إنزال السكينة وإنزال الجنود وتعذيب الذين كفروا .
والملائم لذلك أن يكون الموصول في ﴿من يشاء﴾ شاملا للمسلمين والكافرين جميعا فقد ذكر من الفريقين جميعا ما يصلح لأن يتوب الله عليهم فيه إن تابوا وهو من الكفار كفرهم ومن المسلمين خطيئتهم ومعصيتهم ، ولا وجه لتخصيص التوبة على بعضهم مع ما في آيات التوبة من عموم الحكم وسعته ولم يقيد في هذه الآية المبحوث عنها بما يوجب اختصاصها بأحد الفريقين : المسلمين أو الكافرين مع وجود المقتضي فيهما جميعا .
ومما ذكرنا يظهر فساد ما فسر به بعضهم الآية مع قصر الإشارة على التعذيب إذ قال : إن معناها ثم يتوب الله تعالى بعد هذا التعذيب الذي يكون في الدنيا على من يشاء من الكافرين فيهديهم إلى الإسلام وهم الذين لم يحط بهم خطيئات جهالة الشرك وخرافاته من جميع جوانب أنفسهم ، ولم يختم على نفوسهم بالإصرار على الجحود والتكذيب أو الجمود على ما ألفوا بمحض التقليد .
وقد عرفت أن تخصيص الآية بما ذكر والتصرف في سائر قيوده كقصر الإشارة على التعذيب وغير ذلك مما لا دليل عليه البتة .
والوجه في التعبير بالاستقبال في قوله : ﴿ثم يتوب الله﴾ الإشارة إلى انفتاح باب التوبة دائما ، وجريان العناية وفيضان العفو والمغفرة الإلهية مستمرا بخلاف ما يشير إليه قوله : ﴿ثم أنزل الله سكينته﴾ الآية ، فإن ذلك أمور محدودة غير جارية .
____________________________
1 . تفسير الميزان ، ج9 ، ص 181-190 .
تفسير الأمثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآيات (1) :
الكثرة وحدها لا تجدي نفعا :
في الآيات المتقدمة رأينا أنّ اللّه سبحانه يدعوا المسلمين إلى التضيحة والجهاد على جميع الصعد في سبيل اللّه وقلع جذور الشرك وعبادة الأوثان ، ويهدد بشدّة من يتقاعس منهم عن الجهاد والتضحية بسبب التعلق بالأزواج والأولاد والأرحام والعشيرة والمال والثروة.
أمّا الآيات محل البحث فتشير إلى مسألة مهمّة ، وهي أنّ على كل قائد أن ينّبه أتباعه في اللحظات الحساسة بأنّه إذا كان فيهم بعض الأشخاص من ضعاف الايمان والذين يحجبهم التعلّق بالمال والولد والأزواج وما إلى ذلك عن الجهاد في سبيل اللّه ، فلا ينبغي أن يقلق المؤمنون المخلصون من هذا الأمر ، وعليهم أن يواصلوا طريقهم ، لأنّ اللّه لم يتخلّ عنهم يوم كانوا قلة ، كما هو الحال في معركة بدر ، ولا يوم كانوا كثرة- ملء العين (كما في معركة حنين) وقد أعجبتهم الكثرة فلم تغن عنهم شيئا ، لكن اللّه سبحانه أنزل جنودا لم تروها ، وعذب الذين كفروا ، فاللّه في الحالين ينصر المؤمنين ويرسل إليهم مدده ...
لهذا فإن الآية الأولى من الآيات محل البحث تقول {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ} .
والمواطن جمع الموطن ، ومعناه المحل الذين يختاره الإنسان للسكن الدائم ، أو المؤّقت ، إلّا أن من معانيه أيضا ساحة الحرب والمعركة ، وذلك لأنّ المقاتلين يقيمون في مكان الحرب مدّة قصيرة أو طويلة أحيانا .
ثمّ تضيف الآية معقبة {ويَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} وكان جيش المسلمين يوم حنين زهاء اثني عشر ألفا ، وقال بعض المؤرخين : كانوا عشرة آلاف أو ثمانية آلاف ، غير أنّ الرّوايات المشهورة تؤيد ما ذكرناه آنفا ، إذ تقول :
إنّهم كانوا اثني عشر ألفا ، وهذا الرقم لم يسبق له مثيل في الحروب الإسلامية قبل ذلك الحين ، حتى اغترّ بعض المسلمين وقالوا : «لن نغلب اليوم».
إلّا أنّه- كما سنبيّن الموضوع في الحديث على غزوة حنين- قد فرّ كثير من المسلمين ذلك اليوم ، لكونهم جديدي عهد بالإسلام ولم يتوغل الإيمان في قلوبهم فانكسر جيش المسلمين في البداية وكاد العدوّ أن يغلبهم لولا أن اللّه أنزل بلطفه مدده وجنوده فنجّاهم.
ويصور القرآن هذه الهزيمة بقوله {وضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} .
وفي هذه اللحظات الحساسة حيث تفرق جيش الإسلام هنا وهناك ، ولم يبق مع النّبي إلّا القلة ، وكان النّبي مضطربا ومتألّما جدّا لهذه الحالة نزل التأييد الإلهي : {ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها} .
وكما قلنا في حديثنا عن غزوة بدر في ذيل الآيات الخاصّة بها ، أن نزول هذه الجنود غير المرئية كان لشدّ أزر المسلمين وتقوية معنوياتهم ، وإيجاد روح الثبات والاستقامة في نفوسهم وقلوبهم ، ولا يعني ذلك اشتراك الملائكة والقوى الغيبية في المعركة «2».
ويذكر القرآن النتيجة النهائية لمعركة حنين الحاسمة فيقول {وعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ} .
وكان هذا العذاب والجزاء أن قتل بعض الكافرين ، وأسر بعضهم ، وفرّ بعضهم إلى مناطق بعيدة عن متناول الجيش الاسلامي.
ومع هذا الحال فإنّ اللّه يفتح أبواب توبته للأسرى والفارين من الكفّار الذين يرغبون في قبول مبدأ الحق «الإسلام» لهذا فإنّ الآية الأخيرة من الآيات محل البحث تقول : {ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
وجملة «يتوب» التي وردت بصيغة الفعل المضارع ، والتي تدل على الاستمرار ، مفهومها أن أبواب التوبة والرجوع نحو اللّه مفتوحة دائما بوجه التائبين .
____________________________
1. تفسير الأمثل ، ج5 ، ص 183-185 .
2. لمزيد من الإيضاح يراجع تفسير الآيات 9- 12 من هذا الجزء نفسه .



|
|
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|