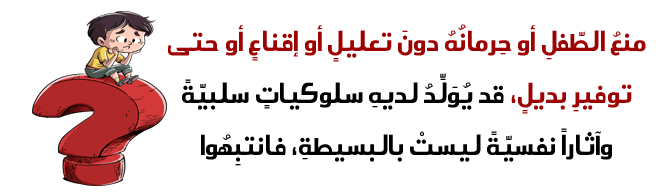
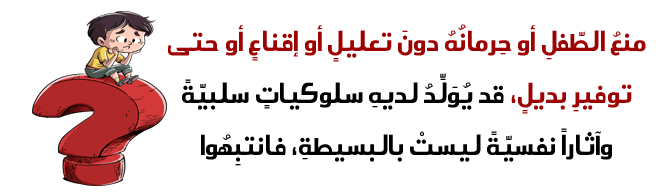

 التاريخ والحضارة
التاريخ والحضارة
 اقوام وادي الرافدين
اقوام وادي الرافدين 
 العصور الحجرية
العصور الحجرية 
 الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق 
 العهود الاجنبية القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق 
 احوال العرب قبل الاسلام
احوال العرب قبل الاسلام 
 مدن عربية قديمة
مدن عربية قديمة
 التاريخ الاسلامي
التاريخ الاسلامي 
 السيرة النبوية
السيرة النبوية 
 الخلفاء الاربعة
الخلفاء الاربعة
 علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
 الدولة الاموية
الدولة الاموية 
 الدولة الاموية في الشام
الدولة الاموية في الشام
 الدولة الاموية في الاندلس
الدولة الاموية في الاندلس
 الدولة العباسية
الدولة العباسية 
 خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
 خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
 عصر سيطرة العسكريين الترك
عصر سيطرة العسكريين الترك
 عصر السيطرة البويهية العسكرية
عصر السيطرة البويهية العسكرية
 عصر سيطرة السلاجقة
عصر سيطرة السلاجقة
 التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر
 التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
 تاريخ الحضارة الأوربية
تاريخ الحضارة الأوربية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-29
التاريخ: 2024-11-07
التاريخ: 2024-01-09
التاريخ: 27-4-2018
|
قد تكلمنا على الدولة العباسية منذ نشأتها إلى اضمحلالها في العراق، فحان لنا أن ننظر إلى ما أدَّى خلفاؤها من الخِدَم إلى الحضارة والعلم والرُّقي. وقبل أن نحوض عُباب هذا البحث، لا بد أن نعرف حالة العلم عند العرب في بداوتهم وجاهليتهم، لنعرف ونُقَدِّر ما صاروا إليه من التقدم بعد تلك الخلافة، فنقول: إن بداوة العرب أمرٌ غير مُنكَر، والعلوم التي كانوا يعرفونها في حالتهم تلك لا تتطلب عناءً عظيمًا ولا القبض على القلم، بل تتطلب ذاكرة رائقة، ومُلاحظة دقيقة، ومشاعر مُتنبهة، وشواعر مُتيقظة؛ ولذلك لم يكن لهم من العلوم يومئذٍ إلا علمُ الأنساب، وقرض الشعر والبلاغة، ورواية الأخبار، والنظر إلى القُبة الزرقاء، وعلم الأنواء وعلم نزول الأمطار، والقيافة، والعيافة، والريافة، والفراسة، والكهانة، والعرافة، والطب، والضرب في الفلوات، والرماية، والملاحة، وركوب الخيل، وأصول الحساب، ومبادئ تقويم بلدان جزيرتهم، إلى ما ضاهاها من العلوم التي تُؤخذ بظواهر الحواس، والتي لا يُبذَل في معرفتها من قوة الفكر شيءٌ يُذكر. ثم جاء الإسلام فكان معظم عناية الخلفاء الراشدين بنشر الدين وتمكين أُسسه في البلاد، وكبح جماح المرتدين، ثم ما لبث أن ظهر الأمويون، فلما أقاموا في ديار الشام — وكانت سابقًا مقر حضارات عديدة جليلة القدر — أخذوا ينتقلون من البداوة إلى الحضارة، فأصبحوا في حالةٍ لا هي بدوية محضة، ولا حضرية بحتة، فكانت بَين بَين، ولم تأتِ بنفعٍ للحضارة العصرية، ثم دالت الدولة، فظهر العباسيون في ميدان العمل، فكان جُل همهم توسيع ملكهم وتوثيق دعائمه، وتأييد سلالتهم على عرش الخلافة بحيث لا ينزعها أحد من أيديهم، ولا يطمح إليها طامح. وتحققوا أنهم لا يتوصلون إلى بُغيتهم هذه إلا بالعلم؛ إذ بالعلم ينال المرء كل ما يسعى إليه في هذه الدنيا، من قوة، ورئاسة، ومال، وجاه، وشُهرة، وصحة، وراحة، وطول عمر. وأول مَن عُنِي منهم بالعلوم هو الخليفة المنصور باني بغداد؛ فإنه كان أول خليفة قرَّب المنجمين، وكان أصحاب التنجيم من أقرب المقرَّبين من الملوك في ذلك العهد. وكان المنصور أيضًا أول خليفة تُرجمت له الكتب السريانية والأعجمية، ككتاب كليلة ودمنة، وكتاب إقليدس، وكتب اليونان، فنظر الناس فيها وتعلَّقوا بها. فلما رأى ذلك محمد بن إسحاق جمع المغازي والسِّيَر ودوَّنها، فكانت هذه المؤلَّفات أُمهات المصنفات التي أُنشئت بعدها، وأصبحت مثلًا يُحتذى عليها، ووسائل نشطت همم مَن أراد التقرُّب من الخليفة وأولاده، فنشأت في قلوب رعيته محبة العلم وأربابه. ثم جاء الرشيد فتمكَّن ذلك الحب في الصدور، فازداد في عهده عُشاقه والمعاونون له. وما جاء المأمون إلا وكان العلم قد أثمر أثمارًا بلغت أطايبها، وكان هو بنفسه مثالًا للجد والجهد والعلم الصادق. بَيْدَ أنه كَثُر في زمانه الزنادقة والملاحدة، فنسب الناس تكاثرهم وتبجُّحهم بالكفر إلى مطالعة الكتب الحديثة والتوغُّل فيها، فكان هذا الأمر سببًا لحطِّ العلم وعشاقه إلى دركاتٍ منعت كثيرين من المسلمين عن الاشتغال به؛ إذ رأوا أن الذين زاولوه حادوا عن سواء السبيل إلى ما لا تُحمد عقباه، ولا سيما بعد أن نظروا في الكتب التي كان قد صنَّفها ماني، وابن ديصان، ومرقيون، مما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وتُرجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية، وما صنَّفه في ذلك الوقت ابن أبي العرجاء، وحمَّاد عجرد، ويحيى بن زياد، ومطيع بن إياس تأييدًا للمانوية والديصانية والمرقيونية، فكَثُر بذلك الزنادقة، وظهرت آراؤهم في الناس وأفسدت كثيرين في آرائهم وعقائدهم حتى اشتهر هذا المثل: «مَن تمنطق تزندق.» وأصبح معنى الفلسفة عند أهل ذلك العصر وما بعده مرادفًا للكُفر والزندقة والإلحاد. على أن الأذكياء رأوا أن العلم الصحيح بريء من تُهمة الكفر؛ إذ قد وُجد الإلحاد — أو قُل التظاهر به — في الجَهلة كما وُجد في الأدباء، مع أنه قد ثبت أن العلم غير منافٍ للدين، ولو تنافيا لما وُجدا مجتمعَين في امرئ قط، ونحن نعلم أنهما قد اجتمعا في أُناسٍ كثيرين وقد اشتهروا بهما معًا. ومع ذلك فقد صنَّف الجدليون من أهل البحث من المتكلمين أسفارًا جليلة في رد الجاحدين والزنادقة ومَن لفَّ لفهم، فأقاموا البراهين على المعاندين، وأزالوا شُبَهَ الملحدين، فأوضحوا الحق للشاكِّين، فأخذ النفور يزول من صدور أولئك الذين كانوا قد استنكفوا من درس المنطق والفلسفة وأنواع العلوم الطبيعية وغيرها، فعادوا إليها قَريري العين. وقد ظهرت نتيجة هذا الاشتغال في عهد بني بُويه، فنبغ من العلماء والنُّحاة واللغويين والمؤرخين والشعراء والأدباء ووُصَّاف البُلدان ما يكسف نورهم نور شمس مَن كانوا في عهد الرشيد والمأمون، وبلغ هذا معظمه في عهد المستنصر؛ إذ وصلت العلوم نهايتها، ويشهد على صدق دعوانا تلك المدرسة التي شيَّدها ذلك الخليفة الكبير، وزيَّنها بالعلماء الأعلام على اختلاف طبقاتهم ومعارفهم، بيْدَ أنه لم تظهر ثمارها للعيون؛ لأن هولاكو وأبناءه هبطوا «أم العراق»، وعاثوا عيث الذئاب في الغنم، وتمادَوا في القتل والفتك، فكانت شمس تلك الحضارة شمس الأصيل، كما وقع مثل هذا الحادث في آخر الدولة الساسانية وآخر دولة الآشوريين العظيمة. هذا، وحصل من اشتغال العرب بعلوم الأوائل حضارة خاصة بهم، إلا أن أسسها ودعائمها بقيَت يونانية. نعم، إن أهالي أرض الرافدين أتقنوا لغة مواليهم العربية، واعتاضوا بها عن لسانهم الآرمي الذي كانوا يتكلمون به بصورة من الصور منذ عهد نبوكد نصر، والأسفار الجليلة التي كانوا قد نقلوها إلى الآرمية في عهد الدولة الرومانية النصرانية، وفي مواضيع مختلفة، كالرياضيات، والفلكيات، والبلدان، والحيوان، والنبات، والجماد، والكيمياء، والمنطق، وما وراء الطبيعة، نقلوها أيضًا إلى العربية في عهد العباسيين، فأخذ العرب يُجِلُّون أرسطوطاليس الفيلسوف الذي لا يَصْدُق هذا الاسم إلا عليه، وأكَبُّوا على دراسته في ديارهم كلها من آسية الوسطى إلى الأوقيانوس الأتلنتيكي، ولعلهم فهموه في بلخ وسمرقند أحسن مما فهمه دارسوه في أوروبة في ذلك العهد. والخواطر التي بدت لهم من مطالعة المصنفات اليونانية أنتجت آدابًا علمية وفلسفية عربية فاقت كل آدابٍ سواها كانت تُعرف يومئذٍ في الغرب. وأغلب هذه الآداب لم تكن نتاج أُناس عربيِّي النِّجَار والعنصر، بل نتاج أفكار السريان، وأفكار المنتسبين إلى العنصر الفارسي القديم المعروف في هذه الديار، وقد أصبح لسانهم عربيًّا بعد الفتوحات الإسلامية، ويدعم رأينا هذا مشاهير ذلك العصر؛ ففي القرن الحادي عشر مثلًا كان ابن سينا يُوغل في أبحاثه العلمية في خزائن كتب بُخارى، وكان البيروني يُنعم النظر في ثقل المعادن النوعي وهو في خيوق (خيوا). فالفكر الفلسفي الذي جاء به اليونان إلى عالم العلم أثَّر كل التأثير على فلسفة العرب وعُلمائهم على اختلاف عناصرهم وديارهم ونزعاتهم. فنرى مما تقدَّم بسطه أن الناطقين بالضاد انتحلوا بسهولة معارف الأقدمين ووسَّعوها، لكنهم — والحق يُقال — لم يزيدوا عليها علمًا جديدًا جديرًا بالذكر، ومع ذلك فلهم أعظم فضل على العلم والعالم؛ لأنهم حفظوا وديعة نور العقل في عهدٍ كانت دول الغرب مرتبكة بأمورها الداخلية، وغزوات الأقوام الهمجية لهم، فكان انتقال معظم تلك المعارف إلى تلك الديار الغربية بواسطتهم، فمنها ما وصلتهم عن طريق الحروب الصليبية التي وقعت بين القبيلين، ومنها عن طريق المدارس التي أُنشئت في الأندلس، ولا سيما في إشبيلية وقرطبة وطليطلة، يدلنا على ذلك الألفاظ التي دخلت لغاتهم في مواضيع مختلفة، كالكيمياء، والفلك، وعلم المواليد وغيرها، عند ترجمة كتبهم العربية إلى ألسنتهم الأعجمية. ومما أخذه أهل الغرب عن العرب: بعض الأعمال المتعلقة بالصنائع، كعمل الكاغد، والبارود، والخزف، والسكر، وتركيب الأدوية، وتقطير الأرواح والمشروبات. وتعلموا منهم أيضًا: نسج ضروب مختلفة من الثياب، وأدخلوا بلادهم أيضًا دود القز بعد أن تعلموا منهم تربيته، وأخذوا منهم بذر كثير من الحبوب كالأرز، وغرس كثير من متنوع الأشجار، كقصب السكر، والزعفران، والقطن، والإسبانخ، والرمان، والتين. وتعلموا منهم دباغة الأديم وتجفيفه ودلكه وتلوينه؛ إلى غير ذلك مما يطول سرده ولا يُحصى تعداده.



|
|
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يطلق الامتحانات النهائية لمتعلِّمات مجموعة العميد التربوية للبنات
|
|
|