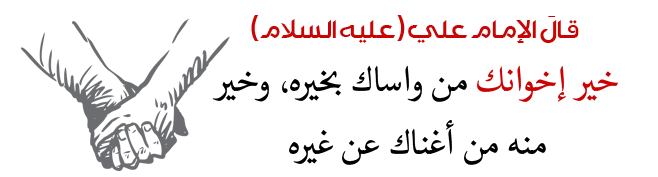
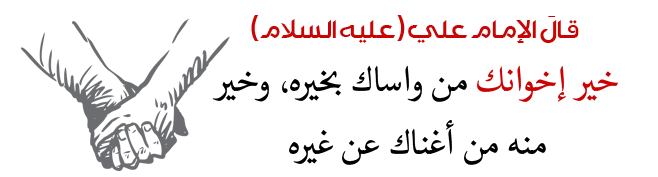

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-3-2017
التاريخ: 30-11-2016
التاريخ: 10-5-2017
التاريخ: 10-5-2017
|
قال تعالى : {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ } [البقرة : 253] .
{تلك} بمعنى أولئك إلا أنه أراد به الإشارة إلى الجماعة فأتى بلفظ الإفراد الذي يكون للمؤنث المفرد كما يقال القوم خرجت أي أولئك الذين تقدم ذكرهم من الأنبياء في الكتاب {فضلنا بعضهم على بعض} إنما ذكر الله تفضيل بعض الرسل على بعض لأمور ( أحدها ) لأن لا يغلط غالط فيسوي بينهم في الفضل كما استووا في الرسالة ( وثانيها ) أن يبين أن تفضيل محمد عليهم كتفضيل من مضى من الأنبياء بعضهم على بعض ( وثالثها ) أن الفضيلة قد تكون بعد أداء الفريضة وهذه الفضيلة المذكورة هاهنا هي ما خص كل واحد منهم من المنازل الجليلة نحو كلامه لموسى بلا سفير وكإرساله محمدا إلى الكافة من الجن والإنس وقيل أراد التفضيل في الآخرة لتفاضلهم في الأعمال وتحمل الأثقال وقيل بالشرائع فمنهم من شرع ومنهم من لم يشرع والفرق بين الابتداء بالفضيلة وبين المحاباة أن المحاباة اختصاص البعض بالنفع على ما يوجبه الشهوة دون الحكمة وليس كذلك الابتداء بالفضيلة لأنه قد يكون للمصلحة التي لولاها لفسد التدبير وأدى إلى حرمان الثواب للجميع فمن حسن النظر لهذا الإنسان تفضيل غيره عليه إذا كان في ذلك مصلحة له فهذا وجه تدعو إليه الحكمة وليس كالوجه الأول الذي إنما تدعو إليه الشهوة .
{منهم من كلم الله} أي كلمة الله وهو موسى {ورفع بعضهم درجات} قال مجاهد أراد به محمدا (صلى الله عليه وآله وسلّم) فإنه تعالى فضله على جميع أنبيائه بأن بعثه إلى جميع المكلفين من الجن والإنس وبأن أعطاه جميع الآيات التي أعطاها من قبله من الأنبياء وبان خصه بالقرآن الذي لم يعطه غيره وهو المعجزة القائمة إلى يوم القيامة بخلاف سائر المعجزات فإنها قد مضت وانقضت وبأن جعله خاتم النبيين والحكمة تقتضي تأخير أشراف الرسل لأعظم الأمور .
{وآتينا عيسى بن مريم البينات} أي الدلالات كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار عما كانوا يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم {وأيدناه بروح القدس} قد مر تفسيره في الآية الخامسة والثمانين من هذه السورة {ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم} أي من بعد الرسل وقال قتادة والربيع من بعد موسى وعيسى وأتى بلفظ الجمع لأن ذكرهما يغني عن ذكر المتبعين لهما كما يقال خرج الأمير فنكوا في العدو نكاية عظيمة معناه ولوشاء الله لم يقتتل الذين من بعد الأنبياء بأن يلجئهم إلى الإيمان ويمنعهم عن الكفر إلا أنه لم يلجئهم إلى ذلك لأن التكليف لا يحسن مع الضرورة والإلجاء والجزاء لا يحسن إلا مع التخلية والاختيار عن الحسن وقيل معناه لوشاء الله ما أمرهم بالقتال {من بعد ما جاءتهم البينات} من بعد وضوح الحجة فإن المقصد من بعثة الرسل قد حصل بإيمان من آمن قبل القتال {ولكن اختلفوا فمنهم من آمن} بتوفيق الله ولطفه وحسن اختياره {ومنهم من كفر} بسوء اختياره {ولوشاء الله ما اقتتلوا} كرر ذلك تأكيدا وتنبيها وقيل الأول مشيئة الإكراه أي لوشاء الله اضطرهم إلى حال يرتفع معها التكليف والثاني الأمر للمؤمنين بالكف عن قتالهم {ولكن الله يفعل ما يريد} ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحكمة .
___________________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج2 ، 153-155 .
{ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ } . خاطب اللَّه نبيه محمدا ( صلى الله عليه واله ) في آخر الآية السابقة بقوله : {وإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } وعقبه من غير فاصل بقوله :
{ تِلْكَ الرُّسُلُ } وعليه يتعين أن يكون المراد بالرسل جميع الرسل الذين منهم محمد ، لا جماعة خاصة منهم ، كما قال كثير من المفسرين ، ومع العلم بأن الأنبياء جميعا مستوون في أصل النبوة ، واختيار اللَّه لهم لتبليغ رسالته ، وهداية خلقه فإنهم يتفاوتون في الخصائص ، وعلى الأصح ان بعض الأنبياء اشتهر ببعض الخصائص دون بعض لأن اللَّه سبحانه قد نعته بها في كتابه . . فإبراهيم اشتهر بأنه خليل اللَّه ، لقوله تعالى : {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء : 125] .
واشتهر موسى بأنه كليم اللَّه ، لقوله سبحانه : {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء : 164] . واشتهر عيسى بروح اللَّه ، لقوله : {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ } [النساء : 171] . واشتهر محمد بخاتم النبيين ، لقوله عز وجل : {رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } [الأحزاب : 40] .
وقد ذكر اللَّه سبحانه بعض الأنبياء المفضلين ، أو بعض الخصائص لبعض الأنبياء بقوله : {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ} . وهو موسى بن عمران بالاتفاق .
{ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ} .
قال صاحب تفسير المنار : ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد به نبينا . .
وقال الرازي : أجمعت الأمة على ان محمدا أفضل الأنبياء ، واستدل على ذلك بتسعة عشر دليلا . . منها ان علي بن أبي طالب ظهر من بعيد ، فقال النبي ( صلى الله عليه واله ) :
هذا سيد العرب ، فقالت عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ . فقال : أنا سيد العالمين ، وهو سيد العرب .
وخير ما يستدل به على أفضلية الرسول على جميع الأنبياء والمصلحين شريعته في سعتها وسماحتها وانسانيتها ( 2 ) .
{ وآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ } . البينات هنا الدلائل التي تظهر الحق ، كإحياء الموتى ، وشفاء المرضى ، وخلق الطير من الطين ، وما إليه . . والمراد بروح القدس هنا الروح الطيبة المقدسة ، ومر تفسيرها في الآية 87 .
{ولَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ } .
أي ان الرسل بعد أن جاؤوا بالبينات ، وأوضحوا الحقائق بالدلائل والبراهين اختلف أقوامهم من بعدهم { فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ومِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ } .
وتسأل : ان قوله تعالى : {ولَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا} يدل على ان الإنسان مسير غير مخير . . وان في تكرار هذه الجملة تأكيدا لنسبة الاقتتال إلى مشيئته سبحانه ؟ .
الجواب : ان اللَّه سبحانه منح القدرة للعبد ، وبيّن له الخير والشر ، ونهاه عن هذا ، وأمره بذاك ، قال عز من قائل : {واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ولا تَفَرَّقُوا} فإذا سلك طريق الألفة والمحبة صح أن ينسب سلوكه هذا إلى العبد ، لأنه صدر عنه بإرادته واختياره ، وفضّله على طريق الشقاق والنزاع ، وأيضا يصح أن ينسب إلى اللَّه ، لأنه أقدره عليه ، وأمره به ، أما إذا سلك طريق البغض والتناحر فان هذا السلوك ينسب إليه وحده ، ولا ينسب إلى اللَّه ، لأن العبد قد فعله برضاه وفضّله على طريق الاتفاق ، ولا تجوز إطلاقا نسبته إلى اللَّه ، لأنه نهاه عنه .
وان قال قائل : لما ذا أقدر اللَّه العبد على الشر والتفرقة ، وكان ينبغي أن يرغمه ويلجئه إلى عمل الخير والوفاق ، ولا يمكّنه من الشر والاختلاف إطلاقا ؟ .
قلنا في جوابه : لو فعل اللَّه هذا لم يبق للإنسان من فضل ، ولم تتصف أفعاله بخير أو بشر ، ولا بحسن أو قبح ، لأن هذا الوصف منوط بإرادة الإنسان واختياره ، بل لو ألجأه اللَّه سبحانه إلجاء إلى الفعل لم يبق من فرق بين الإنسان وبين الجماد ، ولا بينه وبين ريشة في مهب الريح . . ومن أجل هذا ، من أجل أن تبقى للإنسان انسانيته لم يشأ اللَّه أن يكره الناس على الوفاق ، ولو شاء ما اقتتلوا .
واختصارا ان الاقتتال الذي حصل بين الناس لم يقع مخالفا لمشيئة اللَّه التكوينية المعبر عنها {بكن فيكون } . وانما وقع مخالفا لمشيئته التشريعية التي هي عبارة عن مجرد البيان والإرشاد ، وقد شاءت حكمته جل جلاله ان يمنح الإنسان الاستعداد الكافي لعمل الخير والشر معا ، ليختار هو بنفسه لنفسه الهدى والخير ، ويصبح باختياره إنسانا يفترق عن الجماد والحيوان .
_______________________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص387-389 .
2- تكلموا كثيرا عن سبب انحلال المسلمين ، وضعف الإسلام في نفوسهم ، وألفوا في ذلك العديد من الكتب ، وذكروا لذلك أكثر من سبب ، والذي نراه نحن ان السبب الأول والأخير هو إهمال الشريعة الإسلامية دراسة وعملا ، وقد أدرك الاستعمار هذه الحقيقة ، وعمل منذ وضع أقدامه في بلاد المسلمين على تنحية الشريعة الإسلامية عن المدارس ودور المحاكم ، وأحل محلها الشرائع الوضعية والأجنبية ، وبهذا أبعد المسلمين عن دينهم ، وقرآنهم وسنة نبيهم . . وربما تعرضنا لذلك بصورة أوسع حين تدعو الحاجة .
سياق هذه الاية والآية التي بعدها لا يبعد كل البعد من سياق الآيات السابقة التي كانت تأمر بالجهاد وتندب إلى الإنفاق ثم تقص قصة قتال طالوت ليعتبر به المؤمنون ، وقد ختمت القصة بقوله تعالى : {وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } [البقرة : 252] الآية ، وافتتحت هاتان الآيتان بقوله : {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض} ، ثم ترجع إلى شأن قتال أمم الأنبياء بعدهم ، وقد قال في القصة السابقة أعني : قصة طالوت : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى} [البقرة : 246] ، فأتى بقوله : {مِنْ بَعْدِ مُوسَى } [البقرة : 246] ، قيدا ، ثم ترجع إلى الدعوة إلى الإنفاق من قبل أن يأتي يوم ، فهذا كله يؤيد أن يكون هاتان الآيتان ذيل الآيات السابقة ، والجميع نازلة معا .
وبالجملة الآية في مقام دفع ما ربما يتوهم : أن الرسالة وخاصة من حيث كونها مشفوعة بالآيات البينات الدالة على حقية الرسالة ينبغي أن يختم بها بلية القتال : إما من جهة أن الله سبحانه لما أراد هداية الناس إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية بإرسال الرسل وإيتاء الآيات البينات كان من الحري أن يصرفهم عن القتال بعد ، ويجمع كلمتهم على الهداية فما هذه الحروب والمشاجرات بعد الأنبياء في أممهم وخاصة بعد انتشار دعوة الإسلام الذي يعد الاتحاد والاتفاق من أركان أحكامه وأصول قوانينه؟ وإما من جهة أن إرسال الرسل وإيتاء بينات الآيات للدعوة إلى الحق لغرض الحصول على إيمان القلوب ، والإيمان من الصفات القلبية التي لا توجد في القلب عنوة وقهرا فما ذا يفيده القتال بعد استقرار النبوة؟ وهذا هو الإشكال الذي تقدم تقريره والجواب عنه في الكلام على آيات القتال .
والذي يجيب تعالى به : أن القتال معلول الاختلاف الذي بين الأمم إذ لولا وجود الاختلاف لم ينجر أمر الجماعة إلى الاقتتال ، فعلة الاقتتال الاختلاف الحاصل بينهم ولوشاء الله لم يوجد اختلاف فلم يكن اقتتال رأسا ، ولوشاء لأعقم هذا السبب بعد وجوده لكن الله سبحانه يفعل ما يريد ، وقد أراد جري الأمور على سنة الأسباب ، فوجد الاختلاف فوجد القتال فهذا إجمال ما تفيده الآية .
قوله تعالى : {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض} ، إشارة إلى فخامة أمر الرسل وعلو مقامهم ولذلك جيء في الإشارة بكلمة تلك الدالة على الإشارة إلى بعيد ، وفيه دلالة على التفضيل الإلهي الواقع بين الأنبياء (عليهم السلام) ففيهم من هو أفضل وفيهم من هو مفضل عليه ، وللجميع فضل فإن الرسالة في نفسها فضيلة وهي مشتركة بين الجميع ، ففيما بين الرسل أيضا اختلاف في المقامات وتفاوت في الدرجات كما أن بين الذين بعدهم اختلافا على ما يدل عليه ذيل الآية إلا أن بين الاختلافين فرقا ، فإن الاختلاف بين الأنبياء اختلاف في المقامات وتفاضل في الدرجات مع اتحادهم في أصل الفضل وهو الرسالة ، واجتماعهم في مجمع الكمال وهو التوحيد ، وهذا بخلاف الاختلاف الموجود بين أمم الأنبياء بعدهم فإنه اختلاف بالإيمان والكفر ، والنفي والإثبات ، ومن المعلوم أن لا جامع في هذا النحو من الاختلاف ، ولذلك فرق تعالى بينهما من حيث التعبير فسمى ما للأنبياء تفضيلا ونسبه إلى نفسه ، وسمى ما عند الناس بالاختلاف ونسبه إلى أنفسهم ، فقال في مورد الرسل {فضلنا} ، وفي مورد أممهم {اختلفوا} .
ولما كان ذيل الآية متعرضا لمسألة القتال مرتبطا بها والآيات المتقدمة على الآية أيضا راجعة إلى القتال بالأمر به والاقتصاص فيه لم يكن مناص من كون هذه القطعة من الكلام أعني قوله تعالى : {تلك الرسل فضلنا إلى قوله بروح القدس} مقدمة لتبيين ما في ذيل الآية من قوله : {ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم} إلى قوله تعالى : {ولكن الله يفعل ما يريد} .
وعلى هذا فصدر الآية لبيان أن مقام الرسالة على اشتراكه بين الرسل (عليهم السلام) مقام تنمو فيه الخيرات والبركات ، وتنبع فيه الكمال والسعادة ودرجات القربى والزلفى كالتكليم الإلهي وإيتاء البينات والتأييد بروح القدس ، وهذا المقام على ما فيه من الخير والكمال لم يوجب ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم .
وبعبارة أخرى محصل معنى الآية أن الرسالة على ما هي عليه من الفضيلة مقام تنمو فيه الخيرات كلما انعطفت إلى جانب منه وجدت فضلا جديدا ، وكلما ملت إلى نحو من أنحائه ألفيت غضا طريا ، وهذا المقام على ما فيه من البهاء والسناء والإتيان بالآيات البينات لا يتم به رفع الاختلاف بين الناس بالكفر والإيمان ، فإن هذا الاختلاف إنما يستند إلى أنفسهم فهم أنفسهم أوجدوا هذا الاختلاف كما قال تعالى في موضع آخر : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ } [آل عمران : 19] ، وقد مر بيانه في قوله تعالى : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} [البقرة : 213] .
ولوشاء الله لمنع من هذا القتال الواقع بعدهم منعا تكوينيا ، لكنهم اختلفوا فيما بينهم بغيا وقد أجرى الله في سنة الإيجاد سببية و مسببية بين الأشياء والاختلاف من علل التنازع ، ولوشاء الله تعالى لمنع من هذا القتال منعا تشريعيا أولم يأمر به؟ ولكنه تعالى أمر به وأراد بأمره البلاء والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين .
وبالجملة القتال بين أمم الأنبياء بعدهم لا مناص عنه لمكان الاختلاف عن بغي ، والرسالة وبيناتها إنما تدحض الباطل وتزيل الشبه .
وأما البغي واللجاج وما يشابههما من الرذائل فلا سبيل إلى تصفية الأرض منها ، وإصلاح النوع فيها إلا القتال ، فإن التجارب يعطي أن الحجة لم تنجح وحدها قط إلا إذا شفع بالسيف ، ولذلك كان كلما اقتضت المصلحة أمر الله سبحانه بالقيام للحق والجهاد في سبيل الله كما في عهد إبراهيم وبني إسرائيل ، وبعد بعثة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد مر بعض الكلام في هذا المعنى في تفسير آيات القتال سابقا .
قوله تعالى : {منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات} ، في الجملتين التفات من الحضور إلى الغيبة ، والوجه فيه والله أعلم - أن الصفات الفاضلة على قسمين : منها ما هو بحسب نفس مدلول الاسم يدل على الفضيلة كالآيات البينات ، وكالتأييد بروح القدس كما ذكر لعيسى (عليه السلام) فإن هذه الخصال بنفسها غالية سامية ، ومنها : ما ليس كذلك ، وإنما يدل على الفضيلة ويستلزم المنقبة بواسطة الإضافة كالتكليم ، فإنه لا يعد في نفسه منقبة وفضيلة إلا أن يضاف إلى شيء فيكتسب منه البهاء والفضل كإضافته إلى الله عز اسمه ، وكذا رفع الدرجات لا فضيلة فيه بنفسه إلا أن يقال : رفع الله الدرجات مثلا فينسب الرفع إلى الله ، إذا عرفت هذا علمت : أن هذا هو الوجه في الالتفات من الحضور إلى الغيبة في اثنتين من الجمل الثلاث حيث قال تعالى : {فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات} ، فحول وجه الكلام من التكلم إلى الغيبة في الجملتين الأوليين حتى إذا استوفى الغرض عاد إلى وجه الكلام الأول وهو التكلم فقال تعالى : {وآتينا عيسى بن مريم} .
وقد اختلف المفسرون في المراد من الجملتين من هو؟ فقيل المراد بمن كلم الله : موسى (عليه السلام) لقوله تعالى : { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء : 164] ، وغيره من الآيات ، وقيل المراد به رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لما كلمه الله تعالى ليلة المعراج حيث قربه إليه تقريبا سقطت به الوسائط جملة فكلمه بالوحي من غير واسطة ، قال تعالى : {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم : 9 ، 10] ، وقيل المراد به الوحي مطلقا لأن الوحي تكليم خفي ، وقد سماه الله تعالى تكليما حيث قال : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى : 51] ، وهذا الوجه لا يلائم من التبعيضية التي في قوله تعالى : {منهم من كلم الله} .
والأوفق بالمقام كون المراد به موسى (عليه السلام) لأن تكليمه هو المعهود من كلامه تعالى النازل قبل هذه السورة المدنية ، قال تعالى : {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ } [الأعراف : 143] إلى أن قال : {قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي} [الأعراف : 144] ، وهي آية مكية فقد كان كون موسى مكلما معهودا عند نزول هذه الآية .
وكذا في قوله : {ورفع بعضهم درجات} ، قيل المراد به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن الله رفع درجته في تفضيله على جميع الرسل ببعثته إلى كافة الخلق كما قال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ : 28] ، وبجعله رحمة للعالمين كما قال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء : 107] ، وبجعله خاتما للنبوة كما قال تعالى : {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب : 40] ، وبإيتائه قرآنا مهيمنا على جميع الكتب وتبيانا لكل شيء ومحفوظا من تحريف المبطلين ، ومعجزا باقيا ببقاء الدنيا كما قال تعالى : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } [المائدة : 48] ، وقال تعالى : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل : 89] ، وقال تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9] وقال تعالى : {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء : 88] ، وباختصاصه بدين قيم يقوم على جميع مصالح الدنيا والآخرة ، قال تعالى : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ } [الروم : 43] ، وقيل المراد به ما رفع الله من درجة غير واحد من الأنبياء كما يدل عليه قوله تعالى في نوح : {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ } [الصافات : 79] ، وقوله تعالى في إبراهيم (عليه السلام) : {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا } [البقرة : 124] ، وقوله تعالى فيه {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} [الشعراء : 84] ، وقوله تعالى في إدريس (عليه السلام) {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا } [مريم : 57] ، وقوله تعالى في يوسف : {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} [الأنعام : 83] ، وقوله في داود (عليه السلام) : {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} [النساء : 163] ، إلى غير ذلك من مختصات الأنبياء .
وكذا قيل : إن المراد بالرسل في الآية هم الذين اختصوا بالذكر في سورة البقرة كإبراهيم وموسى وعيسى وعزير وأرميا وشموئيل وداود ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد ذكر موسى وعيسى من بينهم وبقي الباقون ، فالبعض المرفوع الدرجة هو محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى الباقين ، وقيل : لما كان المراد بالرسل في الآية هم الذين ذكرهم الله قبيل الآية في القصة وهم موسى وداود وشموئيل ومحمد ، وقد ذكر ما اختص به موسى من التكليم ثم ذكر رفع الدرجات وليس له إلا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ويمكن أن يوجه التصريح باسم عيسى على هذا القول : بأن يقال : إن الوجه فيه عدم سبق ذكره (عليه السلام) فيمن ذكر من الأنبياء في هذه الآيات .
والذي ينبغي أن يقال : إنه لا شك أن ما رفع الله به درجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مقصود في الآية غير أنه لا وجه لتخصيص الآية به ، ولا بمن ذكر في هذه الآيات أعني أرميا وشموئيل وداود ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا بمن ذكر في هذه السورة من الأنبياء فإن كل ذلك تحكم من غير وجه ظاهر ، بل الظاهر من إطلاق الآية شمول الرسل لجميع الرسل (عليهم السلام) وشمول البعض في قوله تعالى : {ورفع بعضهم درجات} ، لكل من أنعم الله عليه منهم برفع الدرجة .
وما قيل : إن الأسلوب يقتضي كون المراد به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن السياق في بيان العبرة للأمم التي تقتتل بعد رسلهم مع كون دينهم دينا واحدا ، والموجود منهم اليهود والنصارى والمسلمون فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر ، وقد ذكر منهم موسى وعيسى بالتفصيل في الآية ، فتعين أن يكون البعض الباقي محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) .
فيه : أن القرآن يقضي بكون جميع الرسل رسلا إلى جميع الناس ، قال تعالى : {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} [البقرة : 136] ، فإتيان الرسل جميعا بالآيات البينات كان ينبغي أن يقطع دابر الفساد والقتال بين الذين بعدهم لكن اختلفوا بغيا بينهم فكان ذلك أصلا يتفرع عليه القتال فأمر الله تعالى به حين تقتضيه المصلحة ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر المبطلين ، فالعموم وجيه في الآية .
كلام في الكلام
ثم إن قوله تعالى : {منهم من كلم الله} ، يدل على وقوع التكليم منه لبعض الناس في الجملة أي أنه يدل على وقوع أمر حقيقي من غير مجاز وتمثيل وقد سماه الله في كتابه بالكلام ، سواء كان هذا الإطلاق إطلاقا حقيقيا أو إطلاقا مجازيا ، فالبحث في المقام من جهتين : الجهة الأولى : أن كلامه تعالى يدل على أن ما خص الله تعالى به أنبياءه ورسله من النعم التي تخفى على إدراك غيرهم من الناس مثل الوحي والتكليم ونزول الروح والملائكة ومشاهدة الآيات الإلهية الكبرى ، أو أخبرهم به كالملك والشيطان واللوح والقلم وسائر الآيات الخفية على حواس الناس ، كل ذلك أمور حقيقية واقعية من غير مجاز في دعاويهم مثل أن يسموا القوى العقلية الداعية إلى الخير ملائكة ، وما تلقيه هذه القوى إلى إدراك الإنسان بالوحي ، والمرتبة العالية من هذه القوى وهي التي تترشح منها الأفكار الطاهرة المصلحة للاجتماع الإنساني بروح القدس والروح الأمين ، والقوى الشهوية والغضبية النفسانية الداعية إلى الشر والفساد بالشياطين والجن ، والأفكار الرديئة المفسدة للاجتماع الصالح أو الموقعة لسيئ العمل بالوسوسة والنزعة ، وهكذا .
فإن الآيات القرآنية وكذا ما نقل إلينا من بيانات الأنبياء الماضين ظاهرة في كونهم لم يريدوا بها المجاز والتمثيل ، بحيث لا يشك فيه إلا مكابر متعسف ولا كلام لنا معه ، ولو جاز حمل هذه البيانات إلى أمثال هذه التجوزات جاز تأويل جميع ما أخبروا به من الحقائق الإلهية من غير استثناء إلى المادية المحضة النافية لكل ما وراء المادة ، وقد مر بعض الكلام في المقام في بحث الإعجاز .
ففي مورد التكليم الإلهي لا محالة أمر حقيقي متحقق يترتب عليه من الآثار ما يترتب على التكلمات الموجودة فيما بيننا .
توضيح ذلك : أنه سبحانه عبر عن بعض أفعاله بالكلام والتكليم كقوله تعالى : {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } [النساء : 164] ، وقوله تعالى : {منهم من كلم الله} الآية ، وقد فسر تعالى هذا الإطلاق المبهم الذي في هاتين الآيتين وما يشبههما بقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ } [الشورى : 51] ، فإن الاستثناء في قوله تعالى : {إلا وحيا} "إلخ" ، لا يتم إلا إذا كان التكليم المدلول عليه بقوله : أن يكلمه الله ، تكليما حقيقة ، فتكليم الله تعالى للبشر تكليم لكن بنحو خاص ، فحد أصل التكليم حقيقة غير منفي عنه .
والذي عندنا من حقيقة الكلام : هو أن الإنسان لمكان احتياجه إلى الاجتماع والمدنية يحتاج بالفطرة إلى جميع ما يحتاج إليه هذا الاجتماع التعاوني ، ومنها التكلم وقد ألجأت الفطرة الإنسان أن يسلك إلى الدلالة على الضمير من طريق الصوت المعتمد على مخارج الحروف من الفم ، ويجعل الأصوات المؤلفة والمختلطة أمارات دالة على المعاني المكنونة في الضمير التي لا طريق إليها إلا من جهة العلائم الاعتبارية الوضعية ، فالإنسان محتاج إلى التكلم من جهة أنه لا طريق له إلى التفهيم والتفهم إلا جعل الألفاظ والأصوات المؤتلفة علائم جعلية وأمارات وضعية ، ولذلك كانت اللغات في وسعتها دائرة مدار الاحتياجات الموجودة ، أعني : الاحتياجات التي تنبه لها الإنسان في حياته الحاضرة ، ولذلك أيضا كانت اللغات لا تزال تزيد وتتسع بحسب تقدم الاجتماع في صراطه ، وتكثر الحوائج الإنسانية في حياته الاجتماعية .
ومن هنا يظهر : أن الكلام أعني تفهيم ما في الضمير بالأصوات المؤتلفة الدالة عليه بالوضع والاعتبار إنما يتم في الإنسان وهو واقع في ظرف الاجتماع ، وربما لحق به بعض أنواع الحيوان مما لنوعه نحو اجتماع وله شيء من جنس الصوت ، على ما نحسب وأما الإنسان في غير ظرف الاجتماع التعاوني فلا تحقق للكلام معه ، فلوكان ثم إنسان واحد من غير أي اجتماع فرض لم تمس الحاجة إلى التكلم قطعا لعدم مساس الحاجة إلى التفهيم والتفهم ، وكذلك غير الإنسان مما لا يحتاج في وجوده إلى التعاون الاجتماعي والحياة المدنية كالملك والشيطان مثلا .
فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد ما يصدر الكلام منا أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس من الفم المنضمة إليه ، الدلالة الاعتبارية الوضعية ، فإنه تعالى أجل شأنا وأنزه ساحة أن يتجهز بالتجهيزات الجسمانية ، أو يستكمل بالدعاوي الوهمية الاعتبارية وقد قال تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } [الشورى : 11] .
لكنه سبحانه فيما مر من قوله : {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [الشورى : 51] ، يثبت لشأنه وفعله المذكور حقيقة التكليم وإن نفي عنه المعنى العادي المعهود بين الناس ، فالكلام بحده الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلهي لكنه بخواصه وآثاره ثابت له ، ومع بقاء الأثر والغاية يبقى المحدود في الأمور الاعتبارية الدائرة في اجتماع الإنسان نظير الذرع والميزان والمكيال والسراج والسلاح ونحو ذلك ، وقد تقدم بيانه .
فقد : ظهر أن ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام حقيقة ، وهو سبحانه وإن بين لنا إجمالا أنه كلام حقيقة على غير الصفة التي نعدها من الكلام الذي نستعمله ، لكنه تعالى لم يبين لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه أن هذا الذي يسميه كلاما يكلم به أنبياءه ما حقيقته؟ وكيف يتحقق؟ غير أنه على أي حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه آثاره وهي تفهيم المعاني المقصودة وإلقاؤها في ذهن السامع .
وعلى هذا فالكلام منه تعالى كالإحياء والإماتة والرزق والهداية والتوبة وغيرها فعل من أفعاله تعالى يحتاج في تحققه إلى تمامية الذات قبله لا كمثل العلم والقدرة والحياة مما لا تمام للذات الواجبة بدونه من الصفات التي هي عين الذات ، كيف ولا فرق بينه وبين سائر أفعاله التي تصدر عنه بعد فرض تمام الذات! وربما قبل الانطباق على الزمان قال تعالى : {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي} [الأعراف : 143] ، وقال تعالى { وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا} [مريم : 9] ، وقال تعالى : {فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ } [البقرة : 243] ، وقال تعالى : {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } [الأنعام : 151] ، وقال تعالى : {الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه : 50] ، وقال تعالى : { ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} [التوبة : 118] ، فالآيات كما ترى تفيد زمانية الكلام كما تفيد زمانية غيره من الأفعال كالخلق والإماتة والإحياء والرزق والهداية والتوبة على حد سواء .
فهذا هو الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى ، والبحث التفسيري المقصور على الآيات القرآنية في معنى الكلام ، أما ما يقتضيه البحث الكلامي على ما اشتغل به السلف من المتكلمين أو البحث الفلسفي فسيأتيك نبأه .
واعلم : أن الكلام أو التكليم مما لم يستعلمه تعالى في غير مورد الإنسان ، نعم الكلمة أو الكلمات قد استعملت في غير مورده ، قال تعالى : {وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} [النساء : 171] ، أريد به نفس الإنسان ، وقال تعالى : {وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا } [التوبة : 40] ، وقال تعالى : {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام : 115] ، وقال تعالى : {مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ } [لقمان : 27] ، وقد أريد بها القضاء أو نوع من الخلق على ما سيجيء الإشارة إليه .
وأما لفظ القول فقد عم في كلامه تعالى الإنسان وغيره فقال تعالى في مورد الإنسان : {فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ} [طه : 117] ، وقال تعالى في مورد الملائكة : {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة : 30] ، وقال أيضا : {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ} [ص : 71] ، وقال في مورد إبليس {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص : 75] ، وقال تعالى في غير مورد أولي العقل : {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ } [فصلت : 11] ، وقال تعالى : { قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء : 69] ، وقال تعالى : {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي} [هود : 44] ، ويجمع الجميع على كثرة مواردها وتشتتها قوله تعالى : { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس : 82] ، وقوله تعالى : {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [آل عمران : 47] .
والذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى حيث يستعمل القول في الموارد المذكورة مما له سمع وإدراك بالمعنى المعهود عندنا كالإنسان مثلا ، ومما سبيله التكوين وليس له سمع وإدراك بالمعنى المعهود عندنا كالأرض والسماء ، وحيث إن الآيتين الأخيرتين بمنزلة التفسير لما يتقدمهما من الآيات أن القول منه تعالى إيجاد أمر يدل على المعنى المقصود .
فأما في التكوينيات فنفس الشيء الذي أوجده تعالى وخلقه هو شيء مخلوق موجود ، وهو بعينه قول له تعالى لدلالته بوجوده على خصوص إرادته سبحانه فإن من المعلوم أنه إذا أراد شيئا فقال له كن فكان ليس هناك لفظ متوسط بينه تعالى وبين الشيء ، وليس هناك غير نفس وجود الشيء ، فهو بعينه مخلوق وهو بعينه قوله ، كن ، فقوله في التكوينيات نفس الفعل وهو الإيجاد وهو الوجود وهو نفس الشيء .
وأما في غير التكوينيات كمورد الإنسان مثلا فبإيجاده تعالى أمرا يوجب علما باطنيا في الإنسان بأن كذا كذا ، وذلك إما بإيجاد صوت عند جسم من الأجسام ، أو بنحو آخر لا ندركه ، أولا ندرك كيفية تأثيره في نفس النبي بحيث يوجد معه علم في نفسه بأن كذا كذا على حد ما مر في الكلام .
وكذلك القول في قوله تعالى للملائكة أو الشيطان ، لكن يختص هذان النوعان وما شابههما لوكان لهما شبيه بخصوصية ، وهي أن الكلام والقول المعهود فيما بيننا إنما هو باستخدام الصوت أو الإشارة بضميمة الاعتبار الوضعي الذي يستوجبه فينا فطرتنا الحيوانية الاجتماعية ، ومن المعلوم على ما يعطيه كلامه تعالى أن الملك والشيطان ليس وجودهما من سنخ وجودنا الحيواني الاجتماعي وليس في وجودهما هذا التكامل التدريجي العلمي الذي يستدعي وضع الأمور الاعتبارية .
ويظهر من ذلك : أن ليس فيما بين الملائكة ولا فيما بين الشياطين هذا النوع من التفهيم والتفهم الذهني المستخدم فيه الاعتبار اللغوي والأصوات المؤلفة الموضوعة للمعاني ، وعلى هذا فلا يكون تحقق القول فيما بينهم أنفسهم نظير تحققه فيما بيننا أفراد الإنسان بصدور صوت مؤلف تأليفا لفظيا وضعيا من فم مشقوق ينضم إليه أعضاء فعالة للصوت من واحد ، والتأثر من ذلك بإحساس أذن مشقوق ينضم إليها أعضاء آخذة للصوت المقروع من واحد آخر وهو ظاهر ، لكن حقيقة القول موجودة فيما بين نوعيهما بحيث يترتب عليه أثر القول وخاصته وهو فهم المعنى المقصود وإدراكه فبين الملائكة أو الشياطين قول لا كنحو قولنا ، وكذا بين الله سبحانه وبينهم قول لا بنحو إيجاد الصوت واللفظ الموضوع وإسماعه لهم كما سمعت .
وكذلك القول في ما ينسب إلى نوع الحيوانات العجم من القول في القرآن الكريم كقوله تعالى : {قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ } [النمل : 18] ، وقال تعالى فقال أحطت بما لم تحط به {وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ } [النمل : 22] ، وكذا ما يذكر فيه من قول الله تعالى ووحيه إليهم كقوله تعالى : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ} [النحل : 68] .
وهناك ألفاظ أخر ربما استعمل في معنى القول والكلام أو ما يقرب من معناهما كالوحي ، قال تعالى : {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء : 163] ، والإلهام ، قال تعالى : {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } [الشمس : 7 ، 8] ، والنبأ ، قال تعالى : {قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ } [التحريم : 3] ، والقص ، قال تعالى : {يَقُصُّ الْحَقَّ} [الأنعام : 57] ، والقول في جميع هذه الألفاظ من حيث حقيقة المعنى هو الذي قلناه في أول الكلام من لزوم تحقق أمر حقيقي معه يترتب عليه أثر القول وخاصته سواء علمنا بحقيقة هذا الأمر الحقيقي المتحقق بالضرورة أولم نعلم بحقيقته تفصيلا ، وفي الوحي خاصة كلام سيأتي التعرض له في سورة الشورى إن شاء الله .
وأما اختصاص بعض الموارد ببعض هذه الألفاظ مع كون المعنى المشترك المذكور موجودا في الجميع كتسمية بعضها كلاما وبعضها قولا وبعضها وحيا مثلا لا غير فهو يدور مدار ظهور انطباق العناية اللفظية على المورد ، فالقول يسمى كلاما نظرا إلى السبب الذي يفيد وقوع المعنى في الذهن ولذلك سمي هذا الفعل الإلهي في مورد بيان تفضيل الأنبياء وتشريفهم كلاما لأن العناية هناك إنما هو بالمخاطبة والتكليم ، ويسمى قولا بالنظر إلى المعنى المقصود إلقاؤه وتفهيمه ولذلك سمي هذا الأمر الإلهي في مورد القضاء والقدر والحكم والتشريع ونحو ذلك قولا كقوله تعالى : {قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ} [ص : 84 ، 85] ، ويسمى وحيا بعناية كونه خفيا عن غير الأنبياء ولذلك عبر في موردهم (عليهم السلام) بالوحي كقوله : {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء : 163] .
الجهة الثانية : وهي البحث من جهة كيفية الاستعمال فقد عرفت أن مفردات اللغة إنما انتقل الإنسان إلى معانيها ووضع الألفاظ بحذائها واستعملها فيها في المحسوسات من الأمور الجسمانية ابتداء ثم انتقل تدريجا إلى المعنويات ، وهذا وإن أوجب كون استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المحسوس في المعنى المعقول استعمالا مجازيا ابتداء لكنه سيعود حقيقة بعد استقرار الاستعمال وحصول التبادر ، وكذلك ترقي الاجتماع وتقدم الإنسان في المدنية والحضارة يوجب التغير في الوسائل التي ترفع حاجته الحيوية ، والتبدل فيها دائما مع بقاء الأسماء فالأسماء لا تزال تتبدل مصاديق معانيها مع بقاء الأغراض المرتبة ، وذلك كما أن السراج في أول ما تنبه الإنسان لإمكان رفع بعض الحوائج به كان مثلا شيئا من الدهن أو الدهنيات مع فتيله متصلة بها في ظرف يحفظها فكانت تشتعل الفتيلة للاستضاءة بالليل ، فركبته الصناعة على هذه الهيئة أولا وسماه الإنسان بالسراج ، ثم لم يزل يتحول طورا بعد طور ، ويركب طبقا عن طبق ، حتى انتهت إلى هذه السرج الكهربائية التي لا يوجد فيها ومعها شيء من أجزاء السراج المصنوع أولا ، الموضوع بحذائه لفظ السراج من دهن وفتيلة وقصعة خزفية أو فلزية ، ومع ذلك نحن نطلق لفظ السراج عليها وعلى سائر أقسام السراج على حد سواء ، ومن غير عناية ، وليس ذلك إلا أن الغاية والغرض من السراج أعني الأثر المقصود منه المترتب على المصنوع أولا يترتب بعينه على المصنوع أخيرا من غير تفاوت ، وهو الاستضاءة ، ونحن لا نقصد شيئا من وسائل الحياة ولا نعرفها إلا بغايتها في الحياة وأثرها المترتب ، فحقيقة السراج ما يستضاء بضوئه بالليل ، ومع بقاء هذه الخاصة والأثر يبقى حقيقة السراج ويبقى اسم السراج على حقيقة معناه من غير تغير وتبدل ، وإن تغير الشكل أحيانا أو الكيفية أو الكمية أو أصل أجزاء الذات كما عرفت في المثال ، وعلى هذا فالملاك في بقاء المعنى الحقيقي وعدم بقائه بقاء الأثر المطلوب من الشيء على ما كان من غير تغير ، وقلما يوجد اليوم في الأمور المصنوعة ووسائل الحياة - وهي ألوف وألوف - شيء لم يتغير ذاته عما حدث عليه أولا ، غير أن بقاء الأثر والخاصة أبقى لكل واحد منها اسمه الأول الذي وضع له .
وفي اللغات شيء كثير من القسم الأول وهو اللفظ المنقول من معنى محسوس إلى معنى معقول يعثر عليه المتتبع البصير .
فقد تحصل أن استعمال الكلام والقول فيما مر مع فرض بقاء الأثر والخاصة استعمال حقيقي لا مجازي .
فظهر من جميع ما بيناه : أن إطلاق الكلام والقول في مورده تعالى يحكي عن أمر حقيقي واقعي ، وأنه من مراتب المعنى الحقيقي لهاتين اللفظتين وإن اختلف من حيث المصداق مع ما عندنا من مصداق الكلام ، كما أن سائر الألفاظ المشتركة الاستعمال بيننا وبينه تعالى كالحياة والعلم والإرادة والإعطاء كذلك .
واعلم : أن القول في معنى رفع الدرجات من قوله تعالى : {ورفع بعضهم درجات} ، من حيث اشتماله على أمر حقيقي واقعي غير اعتباري كالقول في معنى الكلام بعينه فقد توهم أكثر الباحثين في المعارف الدينية : أن ما اشتملت عليه هذه البيانات أمور اعتبارية ومعاني وهمية نظير ما يوجد بيننا معاشر أهل الاجتماع من الإنسان من مقامات الرئاسة والزعامة والفضيلة والتقدم والتصدر ونحو ذلك ، فلزمهم أن يجعلوا ما يرتبط بها من الحقائق كمقامات الآخرة من جنة ونار وسؤال وغير ذلك مرتبطة مترتبة نظير ترتب الآثار الخارجية على هذه المقامات الاجتماعية الاعتبارية ، أي أن الرابطة بين المقامات المعنوية المذكورة وبين النتائج المرتبة عليها رابطة الاعتبار والوضع ، ولزمهم - اضطرارا - كون جاعل هذه الروابط وهو الله تعالى وتقدس ، محكوما بالآراء الاعتبارية ومبعوثا عن الشعور الوهمي كالإنسان الواقع في عالم المادة ، والنازل في منزل الحركة والاستكمال ، ولذلك تراهم يستنكفون عن القول باختصاص المقربين من أنبيائه وأوليائه بالكمالات الحقيقية المعنوية التي تثبتها لهم ظواهر الكتاب والسنة إلا أن تنسلخ عن حقيقتها وترجع إلى نحو من الاعتباريات .
قوله تعالى : {وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس} ، رجوع إلى أصل السياق وهو التكلم دون الغيبة كما مر .
والوجه في التصريح باسم عيسى مع عدم ذكر غيره من الرسل في الآية : أن ما ذكره له (عليه السلام) من جهات التفضيل وهو إيتاء البينات ، والتأييد بروح القدس مشترك بين الرسل جميعا ليس مما يختص ببعضهم دون بعض ، قال تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ} [الحديد : 25] ، وقال تعالى : {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا} [النحل : 2] ، لكنهما في عيسى بنحو خاص فجميع آياته كإحياء الموتى وخلق الطير بالنفخ وإبراء الأكمه والأبرص ، والإخبار عن المغيبات كانت أمورا متكئة على الحياة مترشحة عن الروح ، فلذلك نسبها إلى عيسى (عليه السلام) وصرح باسمه إذ لولا التصريح لم يدل على كونه فضيلة خاصة كما لو قيل : وآتينا بعضهم البينات وأيدناه بروح القدس ، إذ البينات وروح القدس كما عرفت مشتركة غير مختصة ، فلا يستقيم نسبتها إلى البعض بالاختصاص إلا مع التصريح باسمه ليعلم أنها فيه بنحو خاص غير مشترك تقريبا ، على أن في اسم عيسى (عليه السلام) خاصة أخرى وآية بينة وهي أنه ابن مريم لا أب له ، قال تعالى : {وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ } [الأنبياء : 91] ، فمجموع الابن والأم آية بينة إلهية وفضيلة اختصاصية أخرى .
قوله تعالى : {ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات} ، العدول إلى الغيبة ثانيا لأن المقام مقام إظهار أن المشية والإرادة الربانية غير مغلوبة ، والقدرة غير باطلة ، فجميع الحوادث على طرفي إثباتها ونفيها غير خارجة عن السلطنة الإلهية ، وبالجملة وصف الألوهية هي التي تنافي تقيد القدرة وتوجب إطلاق تعلقها بطرفي الإيجاب والسلب فمست حاجة المقام إلى إظهار هذه الصفة المتعالية أعني الألوهية للذكر فقيل : {ولوشاء الله ما اقتتل} ، ولم يقل : ولو شئنا ما اقتتل ، وهذا هو الوجه أيضا في قوله تعالى في ذيل الآية : {ولوشاء الله ما اقتتلوا} ، وقوله : {ولكن الله يفعل ما يريد} ، وهو الوجه أيضا في العدول عن الإضمار إلى الإظهار .
قوله تعالى : {ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر} ، نسب الاختلاف إليهم لا إلى نفسه لأنه تعالى ذكر في مواضع من كلامه : أن الاختلاف بالإيمان والكفر وسائر المعارف الأصلية المبينة في كتب الله النازلة على أنبيائه إنما حدث بين الناس بالبغي ، وحاشا أن ينتسب إليه سبحانه بغي أو ظلم .
قوله تعالى : {ولوشاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد} ، أي ولوشاء الله لم يؤثر الاختلاف في استدعاء القتال ولكن الله يفعل ما يريد وقد أراد أن يؤثر هذا الاختلاف في سوقه الناس إلى الاقتتال جريا على سنة الأسباب .
ومحصل معنى الآية والله العالم : أن الرسل التي أرسلوا إلى الناس عباد لله مقربون عند ربهم ، مرتفع عن الناس أفقهم وهم مفضل بعضهم على بعض على ما لهم من الأصل الواحد والمقام المشترك ، فهذا حال الرسل وقد أتوا للناس بآيات بينات أظهروا بها الحق كل الإظهار وبينوا طريق الهداية أتم البيان ، وكان لازمه أن لا ينساق الناس بعدهم إلا إلى الوحدة والألفة والمحبة في دين الله من غير اختلاف وقتال لكن كان هناك سبب آخر أعقم هذا السبب ، وهو الاختلاف عن بغي منهم وانشعابهم إلى مؤمن وكافر ، ثم التفرق بعد ذلك في سائر شئون الحياة والسعادة ، ولوشاء الله لأعقم هذا السبب أعني الاختلاف فلم يوجب الاقتتال وما اقتتلوا ، ولكن لم يشأ وأجرى هذا السبب كسائر الأسباب والعلل على سنة الأسباب التي أرادها الله في عالم الصنع والإيجاد ، والله يفعل ما يريد .
قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا} "إلخ" ، معناه واضح وفي ذيل الآية دلالة على أن الاستنكاف عن الإنفاق كفر وظلم .
____________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج2 ، ص262-272 .
دور الأنبياء في حياة البشر :
هذه الآية تشير إلى درجات الأنبياء ومراتبهم وجانباً من دورهم في حياة المجتمعات البشرية ، تقول الآية : {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض} .
«تلك» اسم إشارة للبعيد . والإشارة إلى البعيد ـ كما نعلم ـ تستعمل أحياناً لإضفاء الإحترام والتبجيل على مقام الشخص أو الشيء المشار إليه ، هنا أيضاً أُشير إلى الرسل باسم الإشارة «تلك» لتبيان مقام الأنبياء الرفيع .
واختلف المفسّرون في المقصود بالرسل هنا ، هل هم جميع الرسل والأنبياء ؟
أم هم الرسل الذين وردت أسماؤهم أو ذكرت حكاياتهم في ما سبق من آيات هذه السورة فقط ، مثل إبراهيم ، موسى ، عيسى ، داود ، اشموئيل ؟ أم هم جميع الرسل الذين ذكرهم القرآن حتّى نزول هذه الآية ؟
ولكن يبدو أنّ المقصود هم الأنبياء والمرسلون جميعاً ، لأنّ كلمة «الرسل» جمع حلّيَ بالألف واللام الدالّتين على الاستغراق ، فتشمل الرسل كافّة .
{فضّلنا بعضَهم على بعض} .
يتّضح جليّاً من هذه الآية أنّ الأنبياء ـ وإن كانوا من حيث النبوّة والرسالة متماثلين ـ هم من حيث المركز والمقام ليسوا متساوين لاختلاف مهمّاتهم ، وكذلك مقدار تضحياتهم كانت مختلفة أيضاً .
{منهم من كلّم اللهُ} .
هذه إشارة إلى بعض فضائل الأنبياء ، وواضح أنّ المقصود بالآية موسى (عليه السلام)المعروف باسم «كليم الله» ، كما أنّ الآية 163 من سوره النساء تقول عنه {وكلّم الله مُوسى تكليماً} .
أمّا القول بأنّ المقصود هو نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنّ التكليم المنظور هنا هو التكليم الذي كان في ليله المعراج مع الرسول ، أو أنّ المراد هو الوحي الإلهي الذي ورد في آية 51 من سورة الشورى {وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلاّ وحي . . .) حيث اُطلق عليه عنوان التكلّم ، فإنّه بعيد جدّاً ، لأنّ الوحي كان شاملاً لجميع الأنبياء ، فلا يتلائم مع كلمة «منهم» لأنّ (من) تعبضيّة .
ثمّ تضيف الآية {ورفع بعضهم درجات}
ومع الإلتفات إلاّ أنّ الآية أشارت إلى التفاضل بين الأنبياء بالدّرجات والمراتب ، فيمكن أن يكون المراد في هذا التكرار إشارة إلى أنبياء معيّنين وعلى رأسهم نبيّ الإسلام الكريم لأنّ دينه آخر الأديان وأكملها ، فمن تكون رسالته الابلاغ أكمل الأديان لابدّ أن يكون هو نفسه أرفع المرسلين ، خاصّةً وأنّ القرآن يقول فيه في الآية 41 من سورة النّساء { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء : 41] .
والشاهد الآخر على هذا الموضوع ، وهو أنّ الآية السابقة تشير إلى فضيلة موسى (عليه السلام) ، والآية التالية تبيّن فضيلة عيسى (عليه السلام) ، فالمقام يتطلّب الإشارة إلى فضيلة رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء الأنبياء الثلاثة كان صاحب أحد الأديان الثلاثة العظيمة في العالم . فإذا كان اسم نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جاء بين اسميهما ، فلا عجب في ذلك ، أوَليس دينه الحدّ الوسط بين دينيهما وأنّ كلّ شيء قد جاء فيه بصورة معتدلة ومتعادلة ؟ ألا يقول القرآن : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة : 143]!
ومع ذلك ، فإنّ العبارات المتقدّمة في هذه الآية تدلّ على أنّ المقصود من {رفع بعضهم درجات} هم بعض الأنبياء السابقين ، مثل إبراهيم إذ يقول سبحانه في الآية التالية : {ولوشاءَ اللهُ ما اقتتل الذين من بعدهم} أي لوشاء الله ما أخذت اُمم هؤلاء الأنبياء تتقاتل فيما بينها بعد رحيل أنبيائها .
{وآتينا عيسى بن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس} .
أي أنّنا وهبنا عيسى (عليه السلام) براهين واضحة مثل شفاء المرضى المزمنين وإحياء الموتى والمعارف الدينيّة الساميّة .
أمّا المراد من (روح القدس) هل هو جبرئيل حامل الوحي الإلهي ، أو قوى اُخرى غامضة موجودة بصورة متفاوتة لدى أولياء الله ؟ تقدّم البحث مشروحاً في الآية 87 من سورة البقرة ، وعندما تؤكّد هذه الآية على أنّ عيسى (عليه السلام) كان مؤيّداً بروح القدس فلأنّه كان يتمتّع بسهم أوفر من سائر الأنبياء من هذه الرّوح المقدّسة .
وتشير الآية كذلك إلى وضع الاُمم والأقوام السالفة بعد الأنبياء والإختلافات التي جرت بينهم فتقول : {ولوشاء الله ما اقتتل الّذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيّنات} فمقام الأنبياء وعظمتهم لن يمنعا من حصول الإختلافات والإقتتال والحرب بين أتباعهم لأنّها سنّة إلهيّة أن جعل الله الإنسان حرّاً ولكنّه أساء الإستفادة من هذه الحريّة (ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) .
ومن الواضح أنّ هذا الإختلاف بين الناس ناشىءٌ من اتّباع الأهواء والشّهوات وإلاّ فليس هناك أيّ صراع واختلاف بين الأنبياء الإلهيّين حيث كانوا يتّبعون هدفاً واحداً .
ثمّ تؤكّد الآية أنّ الله تعالى قادرٌ على منع الإختلافات بين النّاس بالإرادة التكوينيّة وبالجبر ، ولكنّه يفعل ما يريد وفق الحكمة المنسجمة مع تكامل الإنسان ولذلك تركه مختاراً {ولوشاء الله ما أقتتلوا ولكنّ الله يفعل ما يريد} .
ولا شكّ في أنّ بعض الناس أساء استخدام هذه الحريّة ، ولكنّ وجود الحريّة في المجموع يُعتبر ضروريّاً لتكامل الإنسان ، لأنّ التكامل الإجباري لا يُعدّ تكاملاً .
وضمناً يُستفاد من هذه الآية الّتي تعرّضت إلى مسألة الجبر مرّة اُخرى بطلان الإعتقاد بالجبر ، حيث تثبت أنّ الله تعالى ترك الإنسان حرّاً فبعضٌ آمن وبعضٌ كفر .
_______________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج2 ، ص73-75 .



|
|
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|