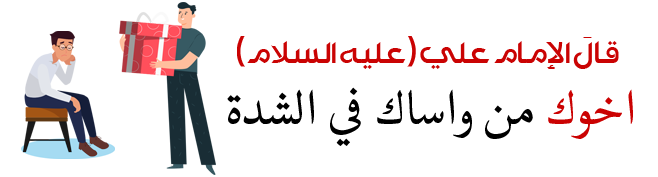
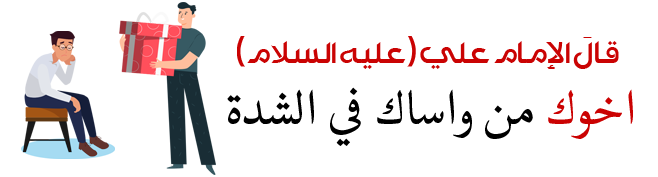

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
التاريخ: 23-8-2016
التاريخ: 12-5-2020
التاريخ: 1-8-2016
|
الشك فى التكليف
...المهمّ هنا بيان الحال في الشكّ وهو إمّا في حقيقة التكليف وأصل الإلزام، سواء كان في نوعه أيضا أم لا، بأن كان النوع على تقدير الجنس معلوما، وإمّا في المكلّف به.
والمقصود بالبحث هنا القسم الأوّل أعني الشكّ في حقيقة التكليف، وهو إمّا أن يكون في الحكم الكلّي الإلهي كالشكّ في حكم شرب التتن أنّه الحليّة أو الحرمة، ومعياره ما كان رفعه بيد الشارع ومن وظيفته، وإمّا في الحكم الجزئي كالشكّ في حرمة مائع خاص لأجل الشكّ في كونه خمرا أو ماء، ومعياره ما لم يكن رفعه من وظيفة الشارع.
ثمّ كلّ من القسمين إمّا يكون الاشتباه والترديد فيه بين الحرمة وغير الوجوب، وإمّا يكون بين الوجوب وغير الحرمة، والمبحوث عنه في مبحث البراءة الذي هو محلّ النزاع بين الاصوليين والأخباريين إنّما هو الشبهة في الحكم الكلّي بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل مع تردّد الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، أو الوجوب مع غير الحرمة مع عدم الحالة السابقة التكليفية. وأمّا الشبهة في الحكم الجزئي فإنّما يذكر تطفّلا.
ثمّ الشكّ في الحكم الكلّي المردّد بين الحرمة وغير الوجوب أو العكس منشائه أحد امور ثلاثة، إمّا فقد النص، وإمّا إجماله، وإمّا تعارض النّصين، والكلام في كلّ من هذه الأقسام إنّما هو في مقتضى القاعدة الأوّليّة العقليّة مع قطع النظر عن الثانويّة التعبديّة، ولا شكّ أنّ الكلام من هذه الجهة أعني من حيث حكم العقل من البراءة أو الاحتياط لا يتفاوت فيه الحال بحسب هذه الأقسام الثلاثة حتّى نحتاج لكلّ إلى عقد باب على حدة والتكلّم في كلّ على انفراده.
نعم غاية ما في الباب أنّه بعد الفراغ عن القاعدة الأوّليّة المشتركة بين الجميع ينفرد الأخير منها، وهو ما كان منشأ الشكّ فيه تعارض النصّين بوجود القاعدة الثانويّة التعبديّة فيه على خلاف القاعدة الأوّليّة وهو الرجوع إلى أرجحهما سندا لو كان، وإلّا فإلى أحد المتعارضين على سبيل التخيير.
وحينئذ نقول: من المسلّم عند من قال بالحسن والقبح من الأخباري والاصولي هو أنّ العقاب على مخالفة التكليف بدون بيان للتكليف قبيح (1).
[هل يكون فى البين بيان]
فالكلام في هذا المقام إنّما هو في أنّه مع احتمال التكليف الثابت في هذه الشبهة هل يكون في البين بيان للتكليف الواقعي على تقدير ثبوته، فلا يكون العقاب على مخالفته بلا بيان، أو لا يكون حتى يكون العقاب بلا بيان؟، فالمهمّ بيان هذا المطلب.
فاعلم أنّ ما توهّم أو يمكن أن يتوهّم في تصوير البيان امور.
الأوّل: أنّ دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل، فإذا احتمل التكليف كان الحجّة عليه موجودا، وهو الاحتمال بضميمة هذا الحكم العقلي.
والجواب أنّ الضرر على ضربين، الأوّل: ما يكون تابعا للتكليف، والتكليف متبوعا ومنشأ له وهو العقاب، والآخر ما يكون التكليف تابعا له وهو متبوع ومنشأ للتكليف وهو المفسدة والمصلحة المترتبتان على ذات الشيء كسكر الخمر وبرودة الماء ونحوها، والأوّل يدور مدار علم المكلّف ومخالفته وعصيانه، والثاني لا مدخل للعلم والجهل فيه، بل هو مترتّب مطلقا كخواص جميع الأشياء.
وإذن فالضرر الذي يحكم بوجوب دفعه في هذا المقام إن كان المراد به هو الذي يكون فرع العلم بالتكليف في حصول المخالفة والعصيان ويكون معلولا للتكليف أعني العقاب، فلا يمكن كون هذه القاعدة بيانا إلّا على وجه يستلزم الدور؛ فإنّ هذه القاعدة بل كلّ قاعدة لا يمكن أن يكون حكمها محدثا وسببا وعلّة لموضوعها، وإلّا لدار، فحكم وجوب دفع الضرر المحتمل فرع وجود احتمال الضرر الذي هو الموضوع، ووجوده فرع وجود سببه وهو البيان، ووجود هذا السبب قد فرض أنّه فرع ثبوت الحكم بالوجوب، وهذا معنى الدور.
وبعبارة اخرى: نحن نتكلّم مع المستدلّ في هذا المقام بتلك القاعدة في الصغرى وهي قوله: نحن نحتمل الضرر، قبل أن نحكم عليها بالكبرى وهي قوله:
وكلّ ضرر محتمل واجب الدفع، ونقول: ما السبب لحدوث هذا الضرر المحتمل ومن أين جاء؟ فإن قال: سببه نفس التكليف بوجوده الواقعي، فهو ليس بسبب، بل السبب هو البيان، وإن قال: هو البيان، فنقول: أين البيان؟، فإن قال: هو الحكم الذي يترتّب على هذا الموضوع، فهذا معنى تحقّق الموضوع من قبل الحكم، وهو الدور.
وإذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على هذه القاعدة، بمعنى أنّ احتمال الضرر مفقود بعد فرض توقّف وجوده على البيان وعدم صلاحيّة الحكم المزبور للبيانيّة، ويصير الضرر مقطوع العدم بقضيّة القاعدة، ولا عكس، يعني لا يكون الحكم المذكور واردا على قاعدة القبح المذكورة؛ لما ذكرنا من أنّ الحكم المذكور يكون موجدا لموضوعه وهو محال.
ولكن القاعدة لا يكون حكم القبح فيها موجدا لعدم البيان الذي هو موضوعه، بل يكفي في تحقّقه عدم صلاحيّة الحكم المذكور للبيانيّة، بل نقول: إنّ الحكم المذكور ليس من شأنه إيجاد احتمال الضرر حتى على قول من يجوّز العقاب بلا بيان، فإنّ مفاده إنّما هو أنّ احتمال العقوبة الذي تحقّق أسبابه في موضوع يجب عليك أن تدفعها من نفسك، لا أن يكون نفس هذا الحكم محدثا للاحتمال.
وإن كان المراد بالضرر هو ما يكون التكليف معلولا له أعني المفسدة التي هي من خاصيّة الشيء ولا مدخل فيها لعلم المكلّف وجهله، فهو وإن كان محتملا لعدم حاجته إلى البيان، ولكن- بعد تسليم الصغرى من كون هذا من أفراد الضرر المحتمل- لنا أن نمنع الكبرى، وهو أنّ الضرر المحتمل واجب الدفع، ويمكن نفي وجوب دفع الضرر بمعنى أن يكون فعله حسنا وتركه قبيحا عند العقل، فإنّ معيار الحسن والقبح العقليين أن يكون فاعل الفعل علاوة على خاصيّة نفس الفعل موردا لشيء آخر من مدح العقلاء أو ذمّهم.
فمن يفعل الظلم فهو علاوة على ابتلائه بأثر الظلم- وهو ظلمة الباطن مثلا- يذمّه العقلاء ويرونه مستحقّا للضرب والشتم، وهذا بخلاف دفع الضرر؛ فإنّه أمر قد جبلت النفوس عليه، فإنّ النفوس مجبولة على دفع المكاره عن أنفسها لحبّها بها، حتى الحيوانات.
فلو فرض أنّ أحدا تحمّل الضرر وأوقع نفسه في مظانّه غير مبال بتضرّره، فليس في هذا العمل سوى نفس هذا الضرر الذي أوقع نفسه في مظنّته، وليس ورائه شيء آخر من ذمّ العقلاء والاستحقاق لسياسة المولى، كيف ولا ضرر أعظم من دخول النار، فلو فعل أحد ما يوجبه فدخل النار فليس في هذا الفعل إلّا نفس هذا الضرر، لا أنّه مستحقّ لدخول نار آخر عقوبة على إقدامه على العمل الذي عاقبته دخول النار.
فتحصّل أنّ الضرر الأخروي تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان دافعا له، والضرر الدنيوي وإن لم تكن القاعدة دافعا له، ولكنّ الإقدام عليه لا يورث العقاب كما يورثه الإقدام على الافعال القبيحة في نظر العقل، بل نقول على تقدير الإيراث أيضا لا يجدي بالمدّعى، فإنّه مستحقّ حينئذ للعقوبة من جهة هذا القبيح الذي ارتكبه أعني الإقدام على محتمل المفسدة، وأين هو من الاستحقاق على القبيح الواقعي المحتمل.
ولا يخفى أنّ ما ذكرنا من عدم إيراث الإقدام على الضرر للعقاب إنّما هو مع قطع النظر عن تحريم الشرع إيّاه وأنّ العقل بنفسه لا يستقلّ على الاستحقاق، بل يستقلّ على عدمه، وأمّا مع النظر إلى (2) حكم الشرع بتحريم بعض أقسام الضرر فلا شكّ في كون ارتكاب هذا البعض مورثا للعقاب شرعا وعقلا أيضا من باب مخالفة المولى.
والحاصل أنّه يمكن أن يقال بأنّ من أتلف نفسه لملالته من حياة الدنيا فلو لا تنصيص الشرع على تحريم عمله لم يكن للعقل حكم بتحريمه، فعلى فرض تسليم كون احتمال المفسدة الذات الشيئيّة احتمال الضرر، لا نسلّم حكم العقل حتى نستكشف به حكم الشرع، ويكون هو البيان في مورد احتمال التكليف.
ثمّ بعد تسليم حكم العقل الذي هو كبرى المطلب يمكن منع الصغرى وهو قيام احتمال الضرر في مورد احتمال التكليف من حيث إنّ المفاسد الكائنة في ذوات الأشياء ليست إلّا عبارة عن الحسن والقبح العقليين، بمعنى حبّ العقل للشيء متى تصوّره أو بغضه له، وليس وراء محبوبيّة نفس الشيء ومكروهيّته لدى العقل أمر آخر، فلا يلزم وجود ضرر في الشيء لتكون المفسدة والقبح باعتباره، بل هو ذاتا قبيح ولا يقبل قبحه السؤال ب «لم» ولهذا قبح الظلم يدركه من لا يتديّن بدين ولا يعتقد بالعقوبة الاخرويّة كالدهريّة، وإلّا فمع قطع النظر عن القبح الذاتي في الشيء القبيح فربّما لا يتضرّر فاعله، بل ينتفع كالظالم، نعم ربّما تكون المنفعة أو المضرّة مناطا للحكم شرعا وعقلا.
وأمّا الكلام في نفس المفسدة مع قطع النظر عن الضرر فلا شكّ أنّها مع العلم بها واضح أنّ العقل مستقبح، وهو مستتبع لحكم الشرع وهو يكون بيانا، وأمّا مع احتمالها كما هو فرض المقام فهنا ثلاث مراتب من الكلام.
الأوّل: إنّ من ارتكب محتمل المفسدة فهو على تقدير إصابة احتماله للواقع ووجود المفسدة واقعا لا يحصل له إلّا الوقوع في تلك المفسدة، ولا يلزمه شيء علاوة عليها.
والثاني: أن يقال: إنّ العقل يستقبح هذا العنوان- أعني محتمل المفسدة- كاستقباحه سائر الأشياء ذات المفسدة من حيث إنّه هذا العنوان مع قطع النظر عن المفسدة المحتملة ووجودها وعدمها، فيلزم من ارتكابه- على هذا- الوقوع في المفسدة الاخرى علاوة على المفسدة المحتملة على تقدير الإصابة، والوقوع في المفسدة الاولى فقط على تقدير الخطاء.
والثالث: أن يقال بأنّ حاله عند العقل حال الأوامر الطريقيّة التي جعلها الشارع احتياطا واهتماما بالواقعيات، فيكون المقدم على تقدير الإصابة واقعا في المفسدة المحتملة ومفسدة الإقدام على محتمل المفسدة، وعلى تقدير الخطاء لا يلزمه شيء.
فالكلام الأوّل لا منكر له ولا يقبل للنزاع، فلا بدّ أن يكون مدّعى الأخباري أحد الأخيرين، وحاصلهما أنّ المقدم على ما فيه احتمال المفسدة على تقدير تحقّق المفسدة واقعا يقع زائدا على هذه المفسدة في شيء آخر وهو تقبيح العقلاء وتذميمهم إيّاه على ارتكاب محتمل المفسدة، وهذا يمكن القطع بعدمه وأنّ الإقدام المذكور ليس فيه على تقدير الواقعيّة سوى هذه المفسدة وليس معه وجدان قبح آخر للعقل.
والحاصل أنّ في ارتكاب محتمل المفسدة لا يكون حكم عقلي حتى يكون مستتبعا للشرعي حتى يكون احتمال التكليف من هذه الجهة بيانا، هذا مع أنّه بعد تسليم الحكم العقلي يمكن إخراج احتمال المفسدة عن الاحتماليّة إلى الوهميّة، وذلك لأنّ العدليّة في قبال الأشعري قائلون بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ولا فرق عند المشهور من العدليّة بين كون المصالح والمفاسد في متعلّقات الأحكام أو في نفس الأحكام.
وإذن فيصير الاحتمال في محتمل التكليف ثلاثة، الأوّل: عدم التكليف رأسا، والثاني: وجوده مع المصلحة أو المفسدة في متعلّقة، والثالث: وجوده مع المصلحة في نفس الحكم، فيكون احتمال المصلحة أو المفسدة في نفس الفعل موهوما، إلّا أن يقال بأنّ المفسدة لكونها عظيمة يكون موهومها أيضا واجب الدفع عند العقل، هذا.
وأمّا الخدشة في الاستدلال بقاعدة دفع الضرر على فرض إرادة المفسدة الذات الشيء مع الإغماض عن عدم كون المفسدة مستلزما للضرر وتسليم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بأنّ المقام من باب الشبهة الموضوعيّة التي تكون موردا للبراءة باتفاق الأخباريين، وذلك لأنّ من جملة المحرّمات الشرعيّة إلقاء النفس في المضارّ الدنيويّة والاقتحام في الشبهة المذكورة يشكّ في أنّه مصداق للمفهوم المذكور أو لا؟.
فالإنصاف عدم إمكان إلزام الخصم بها؛ إذ له أن يجيب بأنّ الشبهة الموضوعيّة التي قد انعقد اتّفاقنا فيه على البراءة إنّما هي خصوص التي لم يكن رفعها وظيفة للشرع وكان منشؤها الامور الخارجية كالشبهة في أنّ المائع خمر أو ماء لأجل ظلمة الهواء مثلا، دون الشبهة التي رفعها وظيفته، كما في المقام، فإنّه بعينه محلّ الكلام.
[هل نفس احتمال التكليف بيان]
والثاني من وجوه تقرير البيان على مسلك الأخباري وإن لم يوجد تعرّض له في كلماتهم أن يقال: بأنّ نفس احتمال التكليف بيان، من دون حاجة إلى ضميمة القاعدة المزبورة، وتقريره أن يقال: إنّ حجّة المولى على العبد يصير تماما بمجرّد احتماله وجود التكليف في الواقع، وأن يكون عدم وصوله إليه لأجل إخفاء الظالمين، فلو ارتكبه مع ذلك يحتمل أن يكون التكليف في الواقع متحقّقا، فيقع في مقام مؤاخذة المولى، فيقول له: أما كنت تحتمل كون هذا الفعل محبوبا لي أو مبغوضا لي، فلم تركته أو جئت به، أ لم تكن في محبوبات نفسك ومبغوضاتك تعامل مع محتملاتها معاملة المعلومات؟ فلو وضع عندك إناء تحتمل بعد الفحص كونه سمّا لكنت تجتنبه، فلم صار محبوبي ومبغوضي عندك أهون من محبوبك ومبغوضك؟.
وبعبارة اخرى: أ لم أكن لك مالكا وأنت مملوكا لي؟ وأ ليس المملوك بمنزلة اليد للمالك، فإنّ من ليس له مملوك لا بدّ أن يصلح اموره بمعاونة يده، وأمّا من له المملوك فيده مملوكه؟ فإذا كنت في مقام المحبوبات والمبغوضات الشخصيّة لنفسك مراعيا للاحتمال كالعلم، فلا بدّ أن تعامل مع محبوباتي ومبغوضاتي حيث كنت مالكا لك أيضا كذلك، فلم صرت مجتنبا عن محتمل مبغوضك ومرتكبا لمحتمل مبغوضي، وأتيت بمحتمل محبوبك وتركت محتمل محبوبي، والإنصاف أنّ العبد يصير ملزما ومفحما بهذا الاحتجاج، وليس له جواب في قبال مولاه.
ومن جهة هذا التقرير يشكل الأمر على الاصولي غاية الإشكال، فإنّ الشيخ المرتضى قدّس سرّه يعوّل في ردّ الاستدلال بأخبار التوقّف والاحتياط على تقييدها بالشبهة التي يكون فيها البيان، والعمدة في صرفه إيّاها عن المقام هو التعويل على هذه القاعدة العقليّة أعني قبح العقاب بلا بيان، فإذا اخذت هذه القاعدة من يد الاصولي لأجل وجود البيان يصير أمره صعبا، فالعمدة الاهتمام في دفع هذا.
فنقول وباللّه التوكيل: الحقّ جريان هذه القاعدة في المقام وعدم كون نفس الاحتمال بيانا ومنجّزا، وبيان ذلك أنّا نرى العرف إذا كان في الفعل احتمال الخطر ونفع قطعي يقدمون عليه، مع أنّ هذا الخطر لو كان قطعيّا أيضا لم يكونوا مقدمين، كما لو كان شرب الدواء المخصوص نافعا لتصفية المزاج واستقامة الاشتهاء بطريق القطع، واحتمل إيجابه للصداع الشديد، فإنّهم يقدمون عليه مع أنّ الصداع الشديد لو كان مقطوعا لما أقدموا عليه، وأمثال ذلك كثيرة، وليس إلّا لأنّ الاحتمال البدوي بعد الفحص ليس عندهم منجّزا وبيانا، نعم لو كان الخطر المحتمل ممّا يكون الاهتمام به كثيرا كالخطر النفسي أو العرضي كان احتماله أيضا منجّزا وموجبا لعدم الإقدام ولو مع ترقّب نفع قطعي.
وحينئذ فجواب العبد للمولى أن يقول: ليس قضيّة العبوديّة وخالقيّة المولى إلّا أن يرجّح العبد ميل مولاه وإرادته في مقام التزاحم على ميل نفسه وإرادته، ويجعل غرض المولى أعلى بالنسبة إلى غرض نفسه، فكلّما تزاحم الميلان وكان كلاهما مقطوعين بحيث اقتضى أحدهما الوقوع والآخر اللاوقوع اختار جانب إرادة المولى، فلو كان في شرب الخمر غرض نفساني اقتضى وقوعه، والفرض أنّ ميل المولى وغرضه مقتض للّاوقوع وجب عليه تقديم اللاوقوع.
وكذا كلّما وصل إليه من المولى كبرى مهتمّة وجب أيضا مراعاة محتمله وتقديمه على الغرض القطعي لنفسه كما في باب الدماء والفروج.
ولهذا لو كان شخص مردّدا بين مهدور الدم ومحقونه حرم قتله، ولو تردّد امرأة بين كونها زوجته أو أجنبيّة حرم وطئها، وأمّا في غير ذلك ممّا يكون للعبد غرض قطعي يقتضي الوقوع مثلا، وللمولى غرض احتمالي يقتضي عدمه ولم يصل منه كبرى اهتماميّة- كما هو محلّ الكلام- فلا حجّة للمولى على عبده؛ إذ لم يعامل مع أغراض المولى إلّا مثل معاملته مع أغراض نفسه، ولو كان للمولى غرض اهتمامي كان عليه البيان، فحيث ما بيّن ليس له حجّة، لما عرفت من أنّ العبد يقدّم الغرض الأدنى المقطوع على الأعلى المحتمل ما لم يكن اهتماميّا.
لا يقال: ليس في مقامنا وهو الإقدام على الشبهات نفع شخصي قطعي للعبد في قبال ما يحتمل من غرض المولى.
لأنّا نقول: لا يعقل أن يصدر من العاقل عمل بدون غرض إليه، بمعنى أنّه وإن كان يمكن الاختلاف شدّة وضعفا في الدواعي إلّا أنّه ما لم ينقدح في نفسه الإرادة الحتميّة والشوق المؤكّد لا يمكن أن يصدر عنه العمل.
لا يقال: سلّمنا الغرض القطعي لنفسه، لكنّ الغرض المحتمل للمولى مردّد بين الاهتمامي وغيره، ولا شكّ أنّه في أغراض نفسه لو تردّد الخطر المحتمل بين المهتمّ وغيره لما كان مقدما(3).
لأنّا نقول: نعم الأمر كما ذكرت في أغراض نفسه، ولكنّه من جهة أنّ ما يحتمله من الخطر الاهتمامي يكون من بين كبريات معلومة من قطع الرأس وشقّ البطن وهتك العرض وغير ذلك، وأمّا في المقام فليس كبرى اهتماميّة معلومة في البين أصلا، وأمّا العقاب والدخول في النار فاحتماله فرع وجود المنجّز والبيان، فإذا فرضنا أنّ نفس الاحتمال ليس ببيان فلا وجه لاحتماله.
فتحقّق أنّه وإن كان الشبهة البدويّة قبل الفحص والشبهة المحصورة بيانا، لكن الشبهة البدويّة بعد الفحص لا يكون بيانا، فاحفظ هذا واغتنمه، فإنّه العمدة لاستقامة مطلب الاصولي.
[وجوب الاحتياط من الآيات]
والوجه الثالث: أنّ هناك قاعدة ظاهرية جارية على لسان الشرع مفيدة لتحريم الشبهات ووجوب الاحتياط فيها، وهي مستفادة من الآيات والأخبار، أمّا الآيات الدالّة فطائفتان:
الاولى: ما تدلّ على حرمة القول بغير علم.
والجواب أنّ الاستدلال بها مبنيّ على كون الاصولي مفتيا وقائلا في الشبهة على طرف الإباحة بأن يقول بأنّ هذا حكم الواقعة بحسب الواقع، ومن المعلوم خلافه وأنّ قوله بالإباحة إنّما هو في مرحلة الظاهر؛ لاستناده على قبح العقاب بلا بيان، فما يقوله الاصولي من الإباحة الظاهريّة لا يكون قولا بغير علم، وما يكون قولا بغير علم من الإباحة الواقعيّة لا يقوله الاصولي، فالآية لا ترتبط به أصلا.
الثانية: الآيات الآمرة بالتقوى، وتقريب الاستدلال أنّ للتقوى مراتب يصدق على كلّ منها هذا الإسم، الاولى: هو الإتيان بالواجبات المعلومة والاجتناب عن المحرّمات المعلومة، والمرتبة الأعلى من هذا هو التجنّب عن المحرّمات المحتملة والإتيان بالواجبات المحتملة، وإذا كان اللفظ مطلقا فهو ظاهر في كلتا مرتبتيه، فإذا تعلّق الوجوب بهذا المفهوم على ما هو قضيّة ظاهر الهيئة ثبت وجوب التقوى بجميع مراتبه.
والجواب أنّ للتقوى مرتبة اخرى أعلى من المرتبتين المتقدّمتين وهي الإتيان بالمستحبّات والتجنيب عن المكروهات، ودعوى عدم صدق التقوى على هذه المرتبة وأنّه في ذلك على حذو لفظة الخشية من اللّه في عدم الصدق إلّا على خصوص المرتبتين السابقتين، مدفوعة بملاحظة مرادفه في اللغة الفارسيّة أعني «پرهيزكارى» حيث يساوي نسبته إلى جميع المراتب الثلاث.
وإذن فإبقاء كلّ من الهيئة والمادّة في هذه الأوامر غير ممكن، لعدم الوجوب بالنسبة إلى المرتبة الأخيرة، فلا بدّ من ارتكاب أحد أمرين، إمّا التصرّف في الهيئة وحملها على مطلق الرجحان الذي هو قدر مشترك بين الوجوب والندب، فيكون بالنسبة إلى كلّ مرتبة على حسبها، فيكون بالنسبة إلى الواجب وجوبا وإلى المستحب استحبابا.
وإمّا من إبقاء الهيئة على ظاهرها والتصرّف في المادّة بتقييدها بغير المرتبة الأخيرة، وقاعدة التعارض بين الظهورين هو الأخذ بالأظهر لو كان، وإلّا فالتوقّف، ولا نسلّم أظهريّة الهيئة في الوجوب من المادّة في جميع المراتب، وذلك لشيوع استعمال الهيئة في غير الوجوب حتى أنكر صاحب المعالم أصل ظهورها فيه، لكون استعماله في الندب كثيرا شايعا، ونحن وإن لم نسلّم ذلك وقلنا بظهوره في الوجوب، لكن في خصوص ما إذا لم يعارض بظهور المادّة ولم يوجب تقييدها، وأمّا في هذا المورد فإن لم نقل بأرجحيّة المادّة، فلا أقلّ من التكافؤ والإجمال والسقوط عن قابليّة الاستدلال.
[الأخبار ثلاث طوائف]
وأمّا الأخبار فما كان منها بمضمون الآيات من النهي عن القول بغير علم، أو الأمر بالتقوى فقد ظهر جوابها، وبعد ذلك يكون هنا ثلاث طوائف من الأخبار:
الاولى: الطائفة الآمرة بالوقوف عند الشبهة
في مقابل المضيّ معلّلا بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وهي كثيرة بالغة حدّ القطع، والمراد بالتوقّف مقابل المضيّ الذي هو بمعنى المرور والحركة سمت العمل، فيختصّ بالشبهات التحريميّة؛ إذ هي التي يكون الاحتياط فيها التوقّف المذكور، بخلاف الشبهات الوجوبيّة، فإنّ الاحتياط فيها مقتض للحركة، فيكون موضوعها مساوقا لمحلّ الكلام بناء على ما نسب إلى الأخباريين من القول بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة.
وكيف كان فتقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو أنّ هذا النهي مفيد للتحريم بقرينة التعليل المذكور في بعض تلك الأخبار من أنّ الوقوف يكون بقباله الاقتحام في الهلكة، وظاهر الهلكة هي الهلاكة الاخرويّة، ومن المعلوم أنّ ما يترتّب عليه الهلاك الاخروي لا يكون إلّا طلبا إلزاميّا.
لا يقال: إنّ هذا النهي على ما يظهر من بعض الأخبار- حيث عبّر عن الشبهات بحول الحمى- إنّما هو بملاحظة خوف انجرار الأمر إلى ارتكاب المحرّمات المعلومة التي هي الحمى، وإلّا فدخول الحول الذي هو ارتكاب المشتبهات من حيث هو ليس فيه حرمة.
لأنّا نقول: ينافي هذا ما في حديث التثليث من قوله: «و هلك من حيث لا يعلم»؛ إذ على هذا لا تكون الهلاكة إلّا لأجل ارتكاب المحرّمات المعلومة، وهذا هلاك من حيث يعلم، لا من حيث لا يعلم، فالمراد بالهلاكة هي المترتّبة على نفس ارتكاب الشبهة، ووجه كونها من حيث لا يعلم عدم العلم بمصادفة العمل الذي فيه احتمال الحرمة واحتمال الحليّة مع الحرمة واقعا.
وقد يجاب عن الاستدلال بهذه الطائفة بأنّ التعليل بالهلاكة يوجب تقييد موضوع هذه الأخبار بالشبهة التي تحقّق فيها البيان، وهي الشبهة البدويّة قبل الفحص والشبهة المحصورة؛ إذ هي التي يترتّب عليه الهلاك، وأمّا الشبهة البدويّة بعد الفحص التي هي محلّ الكلام فحيث لا بيان فيها فلا هلكة بمقتضى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وتحقّق البيان بنفس هذا الأمر المتعلّق بالوقوف مستلزم لكون الحكم محقّقا لموضوعه وهو دور، فيكون خارجا عن موضوع الأمر بالتوقّف والاحتياط، فإنّ الحكم دائر مدار العلّة عموما وخصوصا.
فما نحن فيه نظير قول القائل: لا تأكل الرمّان لأنّه حامض، فإنّ الموضوع وهو الرمّان وإن كان عامّا من حيث نفسه، لكنّه خاص بالأفراد الحامضة بالنظر إلى التعليل المذكور، والتعليل وإن لم يكن بمنزلة التقييد حتى لا يجوز التمسّك بالمعلّل عند الشكّ في تحقّق العلّة في بعض الأفراد، ويكون من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة، بل عند الشكّ يرفع الشكّ بعموم العلّة، ولكنّه عند العلم بعدم العلّة في الفرد ينتج نتيجة التقييد، فيوجب رفع اليد عن الحكم المعلّل في هذا الفرد، وفي مقامنا في مورد الشبهات البدويّة بعد الفحص نقطع بعدم جريان العلّة، لعدم البيان فيها من غير جهة هذه الأخبار.
ولا يمكن تحقّقه من قبلها أيضا؛ لأنّ ظاهرها أنّ الأمر بالوقوف مسبّب عن الهلكة المتحقّقة في الشبهة على تقدير ثبوت التكليف، فلا بدّ أن يكون تحقّق الهلكة التي هي العقاب من غير قبل هذه الأخبار وببيان خارجي؛ إذ بيانيّتها مستلزمة للدور.
فإن قلت: الأمر بالوقوف متعلّق بطبيعة الشبهة من غير تقييد بقيد كونها بدويّة أو غيرها، قبل الفحص أو بعده، والتعليل بثبوت الهلكة أيضا وارد على نفس هذه الطبيعة على الإطلاق، وحيث إنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان مخصّص لبّي ونقطع بعدم أمر الشارع بالوقوف مع عدم نصب البيان في الشبهة البدويّة بعد الفحص نستكشف بأصالة الإطلاق المعمول بها في الشبهة المصداقيّة في المخصّصات اللبيّة أنّ الشارع نصب على الواقع المحتمل في مورد الشبهة بيانا منفصلا عن هذه الأخبار وهو جعل إيجاب الاحتياط.
قلت: المصحّح للعقاب ليس مجرّد وجود البيان الواقعي ولو لم يصل إلى العبد، بل هو خصوص الواصل، ولا يكفي وصوله بهذا الأمر بالوقوف أيضا لما مرّ، فإنّه كما لا يمكن تحقّق أصل البيان بهذا الأمر للزوم تحقيق الحكم لموضوعه، فكذلك لا يمكن تحقّق قيده الذي هو الوصول لعين تلك الجهة.
ويمكن دفعه بأنّ الظاهر المتبادر من تعليق حكم على طبيعة ثمّ تعليل هذا الحكم بعلّة هو سريان هذه العلّة إلى جميع أفراد هذه الطبيعة، فحال العلّة حال نفس الحكم في الظهور المزبور، فإذا قيل: كل الدواء الفلاني لأنّه مزيل للصفراء فهو من حيث نفسه ظاهر في اتّصاف جميع أفراد هذه الطبيعة بهذه الخاصيّة، نعم لو علمنا من الخارج بعدم ثبوتها لفرد خاص، علم خروجه عن تحت الحكم.
وإذن فنقول: تعليل الأمر بالتوقّف المعلّق على موضوع الشبهة بالوقوع في الهلاك ظاهر في ثبوت هذه العلّة في جميع أفراد الشبهة، غاية ما في الباب أنّ المانع عن ذلك بالنسبة إلى بعض الأفراد هي القاعدة العقليّة المذكورة، فلو كان الجمع بينها وبين الظهور المذكور ممكنا تعيّن، والجمع بينهما ممكن.
بيانه: أن يكون مخاطبة الإمام في تلك الروايات للسائلين ونهيهم عن ارتكاب الشبهات لأنّ فيها الاقتحام في الهلكة مبنيّة على ثبوت البيان من الشارع بغير هذه الروايات بالنسبة إلى هؤلاء السائلين وأنّه كان الشارع قد بيّن لهم قانونا ظاهريّا بإيجاب الاحتياط في جميع الشبهات.
والحاصل أنّ هذه الروايات- بعد عدم إمكان كون نفسها بيانا، لأنّ الظاهر منها التهلكة الخارجية الثابتة مع قطع النظر عن هذه الروايات دون الجائية من قبل نفسها، مضافا إلى لزوم الدور من جعل نفسها بيانا، كما مرّ بيانه في ما تقدّم- تكون كاشفة بطريق الإنّ عن ثبوت حكم مولوي كان هو البيان بالنسبة إلى المشافهين.
وهذا نظير ما لو أخبر المتكلّم الذي نعلم بأنّه لا يتكلّم هزوا ولغوا بأنّ ارتكاب الشبهات باعث للهلاكة، فإنّ سماع هذا الإخبار من هذا المتكلّم مع الالتفات إلى الحكم العقل القطعي بقبح العقاب بلا بيان يكون كاشفا بطريق الإنّ عن وجود بيان وحجّة في حقّ المخاطب وراء هذا الكلام يصحّ بملاحظته مؤاخذته، كما يكشف عن جامعيّته لسائر الشرائط العقليّة للتكليف من العقل والقدرة.
وبالجملة، فالأخبار المذكورة حكم إرشادي نستكشف منها الحكم المولوي بطريق الإنّ بالنسبة إلى المشافهين، فإذا ثبت هذا الحكم الظاهري لهم بهذا الطريق يثبت لنا بدليل الشركة في التكليف، ويكفي هذا المقدار في البيانية في حقّنا أيضا.
ولا يخفى أنّه لا يمكن دعوى أنّه لعلّ الإطلاق كان من جهة إحراز القيد؛ فإنّ ذلك العصر كان عصر التمكّن من المعصوم عليه السلام، فالشبهات كانت شبهة قبل الفحص، وجه عدم الإمكان أنّ جميع أفراد الشبهة في حقّ السائل لم يكن محصورة في ما يمكن السؤال عن حكمها عن المعصوم؛ إذ لعلّ شبهة وقعت له وكان المسافة بينه وبين بلد الإمام بعيدة لا يمكن الوصول بأقلّ من شهر مثلا، وهو قبل مضيّ الشهر محتاج إلى العمل، ومثل هذا لم يكن نادرا.
وبالجملة منع إطلاق الشبهة في غاية المنع، إلّا أن يقال: إنّ ايجاب الاحتياط الذي استكشفتموه من الإطلاق وجعلتموه مصحّحا للعقاب وبيانا على الواقع لا يصلح لهذا، بيانه أنّ المتداول على الألسنة في باب طريقيّة الطرق والأمارات بناء على ما هو التحقيق من عدم الموضوعيّة والنفسيّة أحد المبنيين.
الأوّل: أنّ الطريقيّة بنفسها أمر قابل للجعل، وهي جعل غير العلم بمنزلة العلم في كونه منجّزا عند الإصابة ومعذّرا عند الخطاء، وحينئذ يكون التكليف المستتبع لهذا الوضع إرشاديّا صرفا، نظير الأمر باتّباع العلم.
والثاني: أنّ الشارع يوجد موضوع الإطاعة وهو الأمر المولوي باتّباع مؤدّى الأمارة، ومن المعلوم أنّ مخالفة الأمر المولوي يستتبع صحّة العقوبة، لكن حيث إنّ هذا الأمر كان لأجل رعاية الواقع والاهتمام بشأنه فلا محالة لا عقوبة على مخالفته من حيث نفسه، بل من حيث أدائه إلى مخالفة الواقع الذي هو المطلوب الواقعي، فلا عقوبة مع عدم الأداء المذكور.
وبالجملة، هذا أيضا سنخ من الأمر في قبال النفسي والغيري وشأنه الاتّحاد مع الأمر الواقعي لدى المصادفة معه، وهذا معنى كونه جديّا حينئذ، ويصير أمرا صرفا بلا ملاك في متعلّقه عند عدم الإصابة، وهذا معنى صوريّته حينئذ، فلا عقوبة مع عدم الإصابة، وتكون العقوبة على مخالفة الواقع مع وجودها، ومن هذا القبيل أيضا إيجاب الاحتياط إذا كان طريقيّا، هذا ما تداول في الألسن.
ويمكن الخدشة فيه بأنّه إن كان مرجع هذا الأمر الذي سمّوه طريقيّا إلى أنّ الشارع لكثرة اهتمامه بالواقعيّات لم يرفع اليد عنها في حال الشكّ أيضا وأنّه بصدد استيفائها من العبد في هذا الحال أيضا، فمعناه أنّه العياذ باللّه يعاقب العبد من دون بيان، ويرتكب ما استقلّ العقل بقبحه.
وإن كان مرجعه إلى أمر مردّد بين الجدّي والصوري كما ذكروه في هذا لم يفدنا إلّا الاحتمال بالنسبة إلى الأمر الجدّي الذي هو المناط في حكم العقل، وقد كان موجودا قبل هذا الأمر أيضا ولم يوجب التنجيز.
وإن قلت: إنّه بعمومه وإطلاقه ظاهر في الجديّة، وحيث إنّه يتوقّف على وجود الواقع، والتمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة في المخصّصات اللبيّة جائز، نستكشف وجود الواقع في كلّ مورد مورد قام عليه الأمر الطريقي.
قلت: هذا خلاف المفروض في مقامنا أعني إيجاب الاحتياط، فإنّه ربّما يكون نفس الآمر- في غير الشارع- أيضا جاهلا بثبوت التكليف الواقعي.
وإن كان مرجعه إلى أمر مستقلّ متعلّق بإتيان تمام الأطراف فهذا أمر نفسي لوحظ فيه المصلحة في نفس الأمر دون متعلّقه على ما هو التحقيق من إمكان ذلك، فيلزمه استحقاق العقوبة على مخالفة نفسه حتّى عند عدم الإصابة، وأين هذا من تنجيز الواقع والعقوبة على مخالفته على تقدير إصابته وعدم العقوبة أصلا على تقدير العدم.
ويمكن أن يقال: بين الأوامر المتعلّقة بالطرق والمتعلّق بعنوان الاحتياط فرق، فحال الآمر في القسم الأوّل حال العامل، فكما أنّ العامل حين عمله بخبر الثقة مثلا لا يرى جانب عدم إصابته وعدم وثاقته ولو كان هو بحسب معتقده مصيبا في نوع الموارد مع التخلّف في البعض، لكنّه بحسب البناء القلبي والتجزّم حين العمل يلغي جانب الكذب ويأخذ بالصدق ويعمل في هذا النظر، كذلك الآمر أيضا لا يرى في حال أمره باتّباع خبر الثقة مثلا إلّا جانب مصادفته، ويدفع عن ذهنه احتمال الخلاف.
ففي هذا النظر إذا أمر ليس لأمره إطلاق شامل لصورة المخالفة؛ لأنّه لم ير إلّا الموافقة، فالعبد إن أحرز علما أنّ الطريق على خلاف الواقع فلا عقوبة عليه لفرض عدم إطلاق الأمر حال المخالفة، وإنّ شكّ في أنّه مصادف أو مخالف فهذا الأمر صالح لتحريكه، بمعنى أنّه لو لم يتحرّك وكان في الواقع مصادفا كان للمولى حقّ أن يؤاخذه ويقول له: قد شخّصت مصادفته بنفسي ولم أجعله في عهدتك، بل أمرتك بمتابعته مطلقا، فما عذرك في الترك؟
فهذا نظير أن يشخّص المولى الظاهري صداقة شخص ويأمر بإكرامه مبنيّا على هذا التشخيص، فإنّ العبد إذا علم بأنّ المولى أخطأ في التشخيص لا يجب عليه الإكرام، وأمّا عند الشكّ فحجّة المولى عليه تامّة، هذا حال الطرق.
وأمّا عنوان الاحتياط فحيث إنّه متقوّم بالشكّ ومعنى الشكّ كونه ذا طرفين وكون احتمال المصادفة والعدم متطرّقا بالسويّة فحينئذ إن خصّ الآمر أمره بتقدير المصادفة يصير لغوا؛ إذ ما دام الشكّ لا يحرّك، وإذا ارتفع ينقلب الموضوع؛ إذ لا الاحتياط مع العلم، فلا محالة يصير ملاك المصادفة حكمة موجبة لتسرية الحكم إلى صورتي المصادفة والمخالفة، فإن صادف فليس وراء التكليف الواقعي شيء، وهذا الظاهري أيضا منطبق عليه، فلهذا يكون الثواب والعقاب على الواقع وإن لم يصادف، فيصير قهرا أمرا مستقلّا ذا ثواب وعقاب مستقلّين.
والحقّ في الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار أن يقال:
أمّا أوّلا فلأنّه كما قلنا في أخبار القرعة في محلّه أنّ المشكل غير المشكوك والمحتمل، فالأوّل خصوص ما إذا انسدّ الطريق من كلّ جهة من الأمارات والأصول عقليّة وشرعيّة، بخلاف الأخيرين، فإنّهما أعمّ من ذلك، وعلى هذا فالقاعدة سالمة عن التخصيص، كذلك يمكن أن يقال بنظير ذلك في عنوان المشتبه الواقع في هذه الأخبار وأنّه عرفا مغاير للمحتمل مفهوما، فالأوّل خاصّ بالمحتمل الذي لم يعلم أنّ عاقبته خير أم شرّ، والثاني عام منه ومن صورة العلم بعدم شريّة العاقبة.
وعلى هذا فيصير هذا العنوان بنفسه متقيّدا بالشبهة التي يكون فيها البيان، لأنّ ما ليس فيه البيان نعلم بعدم شريّة عاقبته ولا نحتاج في ذلك إلى تقييده بسبب التعليل وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتكون الشبهة البدويّة قبل الفحص والشبهة المحصورة داخلتين فيه، وأمّا الشبهة البدويّة بعد الفحص فكونها من مصاديق المشتبه فرع إحراز وجود البيان في هذه الشبهة بالنسبة إلى السائلين وهو غير معلوم، واستكشاف ذلك بدليل الإنّ إنّما هو في صورة مفروغيّة مصداقيّتها كما لو كان بدل عنوان المشتبه عنوان المحتمل، ثمّ لو شككنا في كون المشتبه مرادفا للمحتمل أو أخصّ منه كفى في المطلوب وهو عدم الإطلاق أيضا.
وأمّا ثانيا: فهذه الكبرى المتداولة في هذه الأخبار أعني قولهم عليهم السلام:
«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» يكون من جملة مصاديقها الشبهة الغير اللازمة الاجتناب بنصّ مولانا الصادق صلوات اللّه عليه حيث فسّر قول النبي صلّى اللّه عليه وآله: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة» بما إذا احتمل كون المرأة اختا رضاعيّا للرجل وأنّه قد رضع من لبنها، ثمّ علّل الاجتناب عن تزويجه بهذه القضيّة، ومن المعلوم أنّ هذه الشبهة موضوعيّة غير لازمة الاجتناب باعتراف الأخباريّين أيضا.
والظاهر أنّ هذه الكبرى قد استعملت في جميع مواقفها من هذه الأخبار على نسق واحد، بمعنى أن يكون المراد بالهلكة فيها أعمّ من الهلكة الاخرويّة اللازمة الاجتناب، ومن الهلكة الاخروية الغير اللازمة الاجتناب، ويكون المراد بالخيريّة فيها أعمّ من الوجوب والاستحباب وإن كان يحتمل أن يستعمل في خصوص المورد الذي يكون مصداقه لازم الاجتناب في الوجوب وفي خصوص ما كان مصداقه فيه غير لازم الاجتناب في الندب، إلّا أنّه خلاف الظاهر، وبالجملة، فعلى هذا تكون قاصرة عن الدلالة على وجوب الاحتياط في ما نحن فيه، وأمّا مطلق الرجحان وإن كان يدلّ عليه، لكنّه ممّا لا نزاع فيه.
وأمّا ثالثا: فلأنّ الشبهة في هذه الأخبار شاملة للشبهة الموضوعيّة وهي مجرى للبراءة بلا كلام، فلا يمكن حفظ ظهور هذا اللفظ في العموم مع ظهور كلمة «خير» ولفظ الهلكة في الوجوب والهلكة الاخروية اللازمة الاجتناب، فلا بدّ إمّا من التصرّف في هذه الكلمة وهذا اللفظ بإرادة مطلق الرجحان من الاولى وإرادة مطلق الهلكة من الثاني، وإمّا التقييد في كلمة الشبهة بتخصيصها بالشبهة الحكمية، فيكون من باب تعارض الأحوال، ونحن إن لم نقل بأقوائيّة ظهور لفظ الشبهة فلا أقلّ من تكافؤ الظهورين وتساويهما، وبذلك يسقط هذه الأخبار عن قابليّة الاستدلال.
هذا هو الكلام في هذه الطائفة التي موردها خصوص الشبهة التحريميّة، وقد كانت هي العمدة لأساس الأخباريين لقوّتها سندا ودلالة، وقد حصل الاستراحة منها بحمد اللّه تعالى، وعلم أنّه لا محيص عن حمل القضيّة المذكورة على مطلق الرجحان، فيكون الأمر فيها للإرشاد.
والطائفة الثانية من الأخبار هي الطائفة الآمرة بالاحتياط في موارد خاصة
وهي روايتان:
الاولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد، فقلت إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال: إذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا»
والثانية: موثّقة عبد اللّه بن وضّاح «قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى عنّا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون، فاصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو انتظر حتّى يذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليه السلام إلىّ: أرى لك أن تنتظر حتّى يذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك» الخبر.
تقريب الاستدلال أنّ الرواية الاولى دالّة على وجوب الاحتياط في كلّ واقعة مشتبهة الحكم، لأنّها المماثلة لمسألة جزاء الصيد. والثانية أيضا يظهر منها مطلوبيّة الاحتياط في كلّ شبهة حكميّة من دون مدخليّة لخصوص المورد أعني مسألة تعيين الغروب، والشبهة في كلتا الروايتين حكميّة لا موضوعيّة.
أمّا الاولى فواضح، وأمّا الثانية فكون الشبهة فيها موضوعيّة معناه أن يكون السائل عالما بأنّ الغروب الذي هو آخر وقت الصوم وأوّل وقت الصلاة عبارة عن استتار القرص من دون مدخليّة لذهاب الحمرة المشرقيّة فيه، ولكن كان سؤاله عن الاشتباه في الموضوع الخارجي أعني تحقّق استتار في الخارج لأجل المانع عن حصول القطع كوجود الجبال والتلال أو الغيم أو نحو ذلك، وهذا المعنى يمكن القطع بعدم إرادته من كلام السائل، فإنّه قال: يتوارى عنّا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة، ومن الواضح أنّ هذه أمارات واضحة الدلالة على حصول الاستتار، ويفيد القطع لكلّ من وجدت له، فليس السؤال إلّا عن الاشتباه في الحكم الكلّي مع العلم بالموضوع الخارجي، بمعنى كون الشكّ في أنّ الغروب الذي هو حدّ الإفطار والصلاة هل هو الاستتار ولا يلزم الصبر إلى ذهاب الحمرة، أو أنّه ذهاب الحمرة؟ وهذه شبهة حكميّة حكم فيه الإمام بوجوب الاحتياط.
والجواب: أمّا عن الرواية الاولى فبأنّ قوله عليه السلام: «إذا اصبتم بمثل هذا» يحتمل فيه وجهان، الأوّل: أن تكون كلمة «هذا» إشارة إلى السؤال، ويكون محصّل المعنى أنّكم أهل العلم إذا سألوا عنكم عن حكم مسألة لا تدرونه فيجب عليكم الاحتياط، والثاني: أن تكون إشارة إلى الواقعة، يعني إذا ابتليتم بمثل هذه الواقعة المشكوك في حكمها فيجب عليكم الاحتياط فيها، وفي كلّ من الوجهين احتمالان.
أمّا على الوجه الأوّل فالاحتمال الأوّل أن يكون المراد بالاحتياط هو الاحتياط الواجب على المفتي في مقام الإفتاء، يعني إذا سألوا عنكم عن حكم مسألة لا تعلموه وجب عليكم أن تحتاطوا ولا تبادروا بالإفتاء، بل تكفّوا عنه ولا تفتوا بشيء حتى بوجوب الاحتياط.
والثاني أن يكون المراد الاحتياط الواجب على المستفتي في مقام العمل، يعني يجب عليكم أهل العلم إذا سألوكم عن المسألة التي لا تدرون حكمها أن تفتوا سائلكم بوجوب الاحتياط.
وأمّا على الوجه الثاني وهو أن تكون الإشارة راجعة إلى الواقعة، فالحيثيات الموجودة في الواقعة المفروضة في الرواية كثيرة، ولكنّ المحتمل الدخل منها في الحكم بوجوب الاحتياط اثنان، فالاحتمال الأوّل أن تكون الحيثيّة الدخيلة هي حيثيّة كونها واقعة مشتبهة، فقوله: إذا اصبتم بمثل هذه الواقعة يعني إذا اصبتم بالواقعة المشتبهة.
والثاني أن تكون الحيثيّة الدخيلة حيثيّة كونها مشتبهة بالشبهة المردّدة بين الأقلّ والأكثر، فإنّ السائل كان قاطعا في مسألة رجلين أصابا جميعا صيدا واحدا بثبوت نصف الجزاء على كلّ منهما، وكان شكّه في النصف الآخر، فكان شكّه من باب الشكّ بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين، فيكون المفاد وجوب الاحتياط في كلّ واقعة حصل الاشتباه فيها بين الأقلّ والأكثر، والبناء في الشبهة بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين، بل والارتباطيين أيضا- كما ياتي في محلّه- وإن كان على البراءة بحسب القاعدة العقليّة إلّا أنّه يكون مفاد الرواية على هذا الاحتمال تعبّدا شرعيّا في القسمين على وجوب الاحتياط.
فهذه أربعة احتمالات، والمفيد منها بحال الأخباري اثنان:
الأوّل: أن تكون الإشارة راجعة إلى السؤال وكان المراد بالاحتياط الاحتياط الواجب مراعاته على المستفتين في مقام العمل بأن يكون المعنى: إذا اصبتم أيّها العلماء بالسؤال عن حكم تجهلون به فيجب عليكم أن تفتوا الناس بوجوب الاحتياط، إذ يعلم منه أنّ التكليف في الواقع المشكوك في حكمها هو وجوب الاحتياط على الجميع من المفتي والمستفتي.
والثاني أن تكون الإشارة راجعة إلى الواقعة، وكانت الخصوصيّة الدخيلة مجرّد كونها واقعة مشتبهة، ويكون المعنى إذا ابتليتم بالواقعة المشتبهة وجب عليكم الاحتياط.
وأمّا الاحتمالان الآخران فأجنبيّان عن مرام الأخباري كما هو واضح، إذ المفاد على أحدهما الاحتياط عن الإفتاء عند عدم العلم، والاصولي لا يفتي بما لا يعلمه، وما يفتي به يعلمه، وعلى الآخر وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة بين الأقلّ والأكثر، فلا بدّ لصحّة تمسّك الأخباري بهذه الرواية من إثبات أظهريّة أحد الاحتمالين الأولين من الأخيرين، ودونه خرط القتاد.
واحتمال كون المراد وجوب الاحتياط عند الابتلاء بالواقعة المشتبهة وإن سلّم أظهريّته بالنسبة إلى بعض الاحتمالات، ولكن لا نسلّم أظهريّته من احتمال كون المراد احتياط المفتي عن الإفتاء بشيء أصلا عند إصابته بالسؤال عن حكم لا يعلمه.
بيان ذلك أنّ السائل في هذه الرواية قد سأل الإمام عن حكم مسألة الصيد المذكورة، وأعطاه الإمام جواب مسألته هذه عقيبها بلا فصل، ثمّ بعد مضيّ هذا السؤال والجواب وتماميّتها يقول السائل: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فعند ذلك قال له الإمام: إذا اصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط، وهذا يقرب كمال التقريب أن تكون الإشارة إلى السؤال.
وأمّا احتمال أن يكون المراد بالاحتياط على هذا التقدير احتياط المستفتي والمراد أنّ عليكم الإفتاء بوجوب الاحتياط، فلا يخفى بعده واحتياجه إلى مئونة زائدة، بل الظاهر جعل الاحتياط على نفس المفتي.
وبالجملة، ملاحظة ذلك إمّا يوجب أظهريّة الاحتمال الثاني من الأوّل ولا أقلّ من التساوي والإجمال، فتسقط الرواية عن قابلية الاستدلال، وإذن فلا نحتاج إلى التمسّك في الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية بأنّ موردها من الشبهة الوجوبيّة، والأخباريون متّفقون على البراءة فيها كالشبهة الموضوعيّة، إذ الحاجة إلى ذلك إنّما هي بعد تسلّم الأظهريّة المذكورة، فتدبّر.
وأمّا عن الرواية الثانية فانّها مضطربة المتن؛ إذ لو حملناها على الشبهة الموضوعيّة بأن كان السائل عالما بأنّ الغروب عبارة عن الاستتار، ولكن شكّ في حصوله في الخارج من جهة الجبال والتلال أو الغيم ونحو ذلك، فالحكم بالاحتياط المذكور في جواب الإمام يكون في محلّه؛ إذ هو قضيّة القاعدة في هذه الشبهة؛ لأنّ مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب بقاء النهار هو الاحتياط (4) حتى يحصل العلم بدخول الوقت، ولكن هذا الحمل ينافيه، بل ينادي على خلافه صدر الرواية والأمارات التي فرضها السائل من تواري القرص واستتار الشمس وظهور ظلمة الليل وشروعه في الازدياد، فإنّها ناصّة في عدم الشبهة في حصول الاستتار.
ولو حملناها على الشبهة الحكميّة ناسب مع صدر الرواية، ولكن يشكل حينئذ حكم الإمام بالاحتياط؛ إذ ليس الحكم بالاحتياط في الشبهة الحكميّة من منصب الإمام، وإنّما هو شأن من لا يعرف الحكم، فكان شأن الإمام أن يحكم إمّا بالصبر، وإمّا بالإفطار.
إلّا أن يقال: إنّ وجه حكم الإمام عليه السلام بالاحتياط هو التقيّة عن المخالفين القائلين بكون الغروب هو الاستتار، فكان الإمام قد ألقى الحكم الواقعي إلى السائل من كون الغروب هو ذهاب الحمرة على نحو راعى التقيّة (5) أيضا من جهة إظهاره بكلامه هذا أنّه قد فهم من كلام السائل أنّ غرضه السؤال عن الشبهة الموضوعيّة والاشتباه في حصول موضوع الاستتار، فلهذا أجابه بالاحتياط حتّى يعلم بهذا الموضوع، ومن المعلوم أنّه على هذا لا يبقى محلّ للاستدلال.
وفي الرواية احتمال آخر قال الاستاد دام ظلّه: لم أر من تعرّضه، وهو أن يكون غرض الإمام هو الافتاء بكون الغروب هو ذهاب الحمرة، وأراد بقوله: «أرى لك» الخ الفتوى دون إراءة الاحتياط، ويكون المراد بقوله: «و تأخذ بالحائطة لدينك» إعلام السائل على مراعاة التقيّة من المخالفين، يعني ولكن لا بدّ أن لا تظهر دينك هذا للمخالفين، ولا تفعل عملا يظهر لهم أنّ هذا دينك، مثل أن تصعد على السطح لأجل استعلام أنّ الحمرة قد ذهبت أولا، حتّى يعلموا أنّك تتفحّص عن حال الحمرة وأنّ مذهبك وراء مذهبهم.
وعلى هذا يكون المراد بالحائطة هو الحائط المعمول للدار والبستان دون الاحتياط المصطلح وإن كان هو أيضا مأخوذا منه باعتبار أنّ المحتاط كأنّه يعمل حائطا لنفسه يحفظه عن الوقوع في المهلكة، والمراد في المقام التصدّي لإخفاء الدين وستره عن أنظار المعاندين، يعني كما أنّ الحائط للدار والبستان يخفي ويستر ما فيها عن الأنظار، كذلك لا بدّ لك أن تعامل معاملته مع دينك، كأنّك تبني حوله حائطا يحجبه عن الأبصار، وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبيّة عن مدّعى الأخباري بالمرّة كما هو واضح.
والطائفة الثالثة: خبر التثليث الوارد في الخبرين المتعارضين وعدّة أخبار أخر الآمرة بالاحتياط
، من قبيل قوله عليه السلام: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» وسند خبر التثليث لكونه مرويّا بطرق متعدّدة ممّا لا يقبل الخدشة، والإمام عليه السلام في هذه الرواية بعد ما يحكم في الخبرين المتعارضين بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ النادر ويعلّل ذلك بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه يقول:
«إنّما الامور ثلاثة، أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّة فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه ورسوله، ثم يستشهد بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله ويقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم»
تقريب الاستدلال بهذه الرواية يكون من ثلاثة أوجه: الأوّل بحكمه بترك الشاذ معلّلا بكونه ممّا فيه الريب، وهذا التعليل وإن كان غير مذكور في كلام الإمام، إلّا أنّه يستفاد من تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بكونه ممّا لا ريب فيه أنّ وجه ترك الشاذ هو كونه ممّا فيه الريب، وأيضا يستفاد ذلك من الاستشهاد بحديث التثليث، إذ لو كان الشاذ من أفراد بيّن الغيّ لعلّله بهذا المطلب ولم يحتج إلى هذا التفصيل. وبالجملة، فيستفاد من الرواية وجوب ترك كلّ ما فيه ريب بقضيّة عموم التعليل.
والثاني بالتثليث المذكور في كلام الإمام الحاكم بوجوب ردّ حكم الأمر المشكل إلى اللّه ورسوله، ومعناه وجوب الاحتياط.
والثالث بالتثليث النبوي.
والجواب أمّا عن الوجه الأخير(6) فبأنّ مساقه مساق الروايات المتقدّمة في الطائفة الاولى الآمرة بالوقوف عند الشبهة لكونه خيرا من الاقتحام في الهلكة، فيكون الجواب عنه هو الجواب عنها.
وحاصله أن يقال تارة بأنّ الشبهة عبارة عن خصوص المحتمل الذي يكون في عاقبته احتمال الصعوبة، فيختصّ بالشبهات التي يكون فيها البيان، فلا يشمل ما نحن فيه، لكونه فاقد البيان.
واخرى بأنّ الشبهة تشمل الشبهة الموضوعيّة أيضا ولا يجب فيه الاحتياط بالاتّفاق، فلا محيص عن حمل الرواية على الإرشاد والمعنى الأعمّ من الوجوب والاستحباب وهو مطلق الرجحان، فيكون تابعا للموارد في الوجوب والاستحباب.
وأمّا عن الوجه الثاني فبأنّ مفاده أنّ حكم الأمر المشكل مردود إلى اللّه ورسوله، ومعنى ذلك عدم جواز القول والفتوى بغير علم، وهذا أجنبيّ عن الاصولي، إذ هو أيضا معترف بعدم جواز القول بما لم يعلم وجواز القول بما يعلم.
وأمّا عن الثالث فبأنّ وجوب ترك ما فيه الريب في مورد الرواية متعيّن، فإنّ موردها الخبران المتعارضان، فالأخذ بكلّ منهما إنّما هو يكون بعنوان الحجيّة، وشرط جواز ذلك هو العلم بالحجيّة من قبل الشارع، فما لم يعلم من الشرع حجيّة الخبر يكون البناء على حجيّته حراما.
وبعبارة اخرى: الشكّ في الحجيّة كاف في عدم الحجيّة، فالشاذ الذي هو مشكوك الحجيّة لا محالة يكون بخلاف المشهور المجمع عليه، فإنّه لكونه لا ريب فيه يكون حجّة، فالتعارض يكون بين الحجّة واللاحجّة، ومن المعلوم أنّ وجوب الأخذ بالحجّة وترك اللاحجّة حينئذ متعيّن.
وأمّا عن الروايات الآمرة بالاحتياط فبأنّه مضافا إلى شهادة سياقها على كون مدلولها حكما إرشاديّا يرد عليها ما تقدّم في بعض الأدلّة المتقدّمة من الإجمال، فإنّ مادّة الاحتياط عام يشمل الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة، وهي مجرى للبراءة بإطباق من الأخباري، فلا بدّ من تقييد المادّة أو التصرّف في الهيئة، فتكون مجملة، هذا تمام الكلام في التمسّك بالمنقولات للأخباري.
_______________
(1) فإنّ من المركوز في ذهن كلّ أحد السؤال عن علّة الضرب و الإيلام الوارد من الغير عليه و أنّه لأيّ جهة، و لو لم يكن قبيحا من دون جهة لما كان للسؤال عن الوجه وجه. منه قدّس سرّه الشريف.
(2) وحاصل هذا الكلام إمكان التّمسك بالأدلّة الشرعية الواردة في تحريم إلقاء النفس في الضرر مثل آيةi« وَ لا تُلْقُوا»E و أمثالها، و حاصل الجواب أنّ الضرر و التهلكة التي يكون الإلقاء فيها بمقتضى الآية محرّما إن كانت هو العقاب الاخروي فهو لا بيان عليه، و الحكم المذكور في الآية أيضا لا يمكن أن يحقّق موضوع نفسه، و إن كانت هو المصلحة و المفسدة اللتين يقول بهما العدليّة فأوّلا لا نسلّم كون كل مفسدة و مصلحة راجعة إلى الضرر و النفع، و ثانيا أنّ الآية محمولة على ما هو التهلكة بنظر العرف و العامّة، و أمّا مثل هذا الذي لا يخطر بأذهان العوام، بل الخواص مختلفون، فبين من يعتبر المصالح و المفاسد في نفس المتعلّقات و بين من يكتفي بوجودها في نفس الأحكام و الإنشاءات، فيمكن دعوى القطع بخروجه عن مدلول الآية، منه قدّس سرّه الشريف.
(3) حاصل الإشكال أنّه لو بنينا على ما ذكر من وجوب تحصيل أغراض المولى على وجه أكمل من أغراض نفسه، فنقول: لا شبهة أنّ الإنسان كما يحتاط في مورد إحراز كون كبرى الغرض على تقدير انطباقها على المورد اهتماميّة، كذلك لو دار أمرها بين الاهتماميّة و غيرها، و مجرّد كون الاهتمام حينئذ يصير محتملا في محتمل حيث إنّه محتمل على تقدير محتمل لا يوجب الفرق؛ إذ بالأخرة هو يحتمل كون هذا الشرب مثلا مورثا لهلاكه، فلا محالة يحتاط منه.
وحينئذ نقول هذا المعنى موجود فى كل مقام شك فى تطبيق كبرى شرعية ملزمة عليه إلّا اذا احرز انها على تقدير الوجود و الانطباق غير اهتمامية و إلّا فبعد القطع بانّ للشارع كسائر ذوى الاغراض قسمين من الاغراض اهتماميّا و غيره فلا محالة فى كل مورد شبهة يحتمل كون الغرض على تقدير الوجود من كل واحد من القسمين.
فالإنصاف عدم تماميّة هذا الوجه لحسم المادّة، فالوجه أن يقال: لا بدّ من ملاحظة الطريقة المسلوكة بين الموالي و العبيد الظاهريّة، و إذا راجعناهم نراهم يتمسّكون في قبال الموالي بقول:« ما علمت بارادتك»، فيجعلون الحجّة مطلقا هو العلم، فإن كان التكليف معلوما فهو، و إن قام عليه طريق علمي فهو أيضا منته إلى العلم، و إن لم يكن شيء منهما لكن علم أنّ التكليف على تقدير ثبوته اهتمامي يستكشف إيجاب الاحتياط و يكون هو الحجّة العلميّة، لا أنّ نفس الشكّ و الاحتمال حجّة، و إن علم أنّ على تقدير الثبوت غير اهتمامي فيقطع بعدم الحجّة، و إن كان مردّدا بين الأمرين فإيجاب الاحتياط الذي هو الحجّة لا يكون حينئذ علميّة، و قد فرضناه المعيار دون نفس الاحتمال حتى يقال: المحتمل في المحتمل محتمل.
وأمّا دعوى أنّه مع فرض كون المعيار إيجاب الاحتياط أيضا و هو في هذا الفرض موجود، فيكذّبه مراجعة ما هو المتعارف بين الموالي و العبيد، فإنّهم في موارد احتجاجاتهم بعدم العلم كثيرا ما يحتملون بين الكبريات المحتمل انطباقها وجود الاهتمامي، و ليس كلّ مورد معلوم الحال عندهم.
ومن هنا يظهر وجه اندفاع أنّ احتجاجهم إنّما هو في مورد الغفلة و عدم الالتفات رأسا، فإنّه أيضا يكذّبه الوجدان و العيان، و كذلك اندفاع دعوى اختصاص ذلك بالموالي و العبيد المتجاورين، حيث إنّ السكوت مع كونه حاضرا واصل اليد إلى العبد طريق عقلائي إلى عدم الإرادة، و أمّا العبيد البعيدون عن الموالي إذا احتملوا أنّ المولى لو كان حاضرا لما سكت، بل كان يأمر أو ينهى، فليس لهم طريق عقلائي إلى العدم، و حالنا مع الشارع هكذا، لأنّا نحتمل صدور التكليف منه واقعا و اختفائه علينا، فإنّ ذلك أيضا يكذّبه الوجدان، فإنّ صريح احتجاجهم بقول:« ما علمت» في العربيّة و« چه مىدانستم» في الفارسيّة أنّ المعيار هو العلم لا مجرّد الاحتمال. منه قدّس سرّه.
(4) ويمكن حمله على هذا التقدير على الوجوب نظرا إلى ذلك، و على الاستحباب نظرا إلى وجود الأمارات التي ذكرها. منه قدس سره الشريف.
(5) ويمكن أيضا أن يكون قد راعى التقيّة في تطبيق الكبرى على المورد مع كون الكبرى هي أنّ كلّ شبهة حكميّة يجب فيها أن تأخذ بالحائطة، فالتطبيق و إن كان تقيّة، لكنّ الكبرى يعلم على هذا مفروغيّتها من كلام الإمام عليه السلام، و لا يقال: إنّه على هذا لا يتأدّى التقيّة، فإنّ الاحتياط ليس بمثابة الجزم بمخالفتهم و مراتب التقيّة مختلفة، فيمكن أن يكون إظهار الحكم بصورة الفتوى و الجزم مخالفا لها، و إظهاره بصورة الاحتياط ملائما معها، و على هذا يتمّ تقريب استدلال الأخباري بهذا الخبر، و ينحصر الجواب حينئذ بظهور قوله عليه السلام:« أرى لك» في الاستحباب، و معارضة هذا المعنى مع ما ذكره الاستاد دام بقاه من عدم كون قوله:« و تأخذ» متمّما للسابق وبمنزلة العلّة له، بل كان جملة مستقلّة بعد الإفتاء بوجوب الانتظار مضمونها وجوب ستر هذا الفتوى عن العامّة. منه قدس سره الشريف.
(6) اعلم أنّ الفقرات الثلاث لو كانت متفرّقة بعضها عن بعض لكان الجواب بما في المتن صحيحا، فإنّ تثليث النبي صلّى اللّه عليه و آله حاله حال أخبار الوقوف المتقدّمة، والكلام المتقدّم فيها جار فيه حرفا بحرف، و تثليث الإمام ناظر بمقام الحكم و الإفتاء، والتعليل بمقام أخذ الحجّة و العمل بالمضمون على أنّه حكم اللّه، و كلّ ذلك أجنبي عن مرام الاصولي، و لكنّ الإشكال كلّه من جهة اجتماع هذه الفقرات في كلام واحد، ووقوع البعض علّة للآخر، وجه الإشكال أنّا لو أغمضنا عن أنّ ظاهر تثليث الإمام حرمة الإفتاء بحكم المشكل و رفعنا اليد عن هذا الظهور بواسطة أظهريّة التعليل أعني تثليث النبي صلّى اللّه عليه و آله في حرمة العمل؛ إذ العكس لا يحتمل و إرجاع المشكل في كلام الإمام إلى الحرام البيّن في كلام النبي صلّى اللّه عليه و آله أيضا بعيد غايته، لكن نقول: إنّ في مقامنا موضوعين و ثلاث كبريات.
أمّا الموضوعان فهما الشاذ الذي فيه الريب و المجمع عليه الذي لا ريب فيه، و لا إشكال في اندراج الثاني تحت كبرى بيّن الرشد و الحلال البيّن، فيدور الأمر في الأوّل بين تطبيق بيّن الغيّ و الحرام البيّن عليه و قد عرفت انه خلاف الظاهر و بين تطبيق المشكل و الشبهة، و قد عرفت حملهما على مقام العمل و مقصود الإمام حرمة الأخذ والتديّن بما فيه الريب.
وإذن فيقرب كمال القرب أن يكون الكبرى هو وجوب استناد الإنسان قولا و عملا إلى حكم الشارع و عدم الاكتفاء في شيء من المقامين بما هو عند نفسه و حكم عقله، و الاستناد يمكن بثلاثة أنحاء الأوّل أن يحصّل من الشرع حكم العنوان الأوّلي للواقعة، مثل حكم شرب التتن بما هو شرب التتن، و الثاني أن يحصّل من الشرع حكمه بعنوانه الثانوي أعني كونه مشتبه الحكم، و الثالث أن يكون غير محرز لحكم بشيء من الوجهين، و لكن كان أحد طرفي الواقعة من الوجود و العدم مقطوع الموافقة مع حكم الشرع، كما أنّ اختيار الترك في ما نحن فيه أعني الشبهة التحريميّة التي لا احتمال للوجوب في البين كذلك، و على هذا فيتّسق جميع أجزاء الكلام، فإنّ مفاد قوله: يردّ حكمه إلى اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله هو عين ما ذكرنا من تحصيل الحكم و الاستناد مطلقا في مقام العمل و الإفتاء، و مفاد التعليل بيان صغرى ذلك و أنّه عند الأخذ بما في وجوده الريب ينتقض هذا المعنى، و أمّا عند طرحه و تركه فيقطع بكونه موافقا لحكم الشارع، و هكذا ينطبق على ذلك قول النبي صلّى اللّه عليه و آله حيث قال صلّى اللّه عليه و آله: من أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم، و من ترك الشبهات نجى من المحرّمات، و على هذا فيكون خروج الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة الوجوبيّة من باب التخصيص، و ذلك لقيام الإجماع على البراءة فيهما، فقد علم حكمهما الشرعي بالعنوان الثانوي، و الجواب عن تقريب الاستدلال بهذا النحو منحصر في ورود أدلّة البراءة التي سيأتي إن شاء اللّه. منه قدس سره الشريف.



|
|
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|