

|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-08-2015
التاريخ: 25-03-2015
التاريخ: 30-09-2015
التاريخ: 27-7-2017
|
لغة الشعر
إن اللغة هي تراث الشاعر فإلى أي مدى ارتبط بهذا تراث ؟ ثم ماذا أضاف اليه نتيجة لتكوينه الثقافي الجديد وكيف أثرى لغته الأساليب التي انبثقت عن الحياة المعاصرة ، واذا كان الواقع الذي يحياه الشاعر قد تلقى بظلاله على لغة الشعر فهل أسهم الموضوع والتجربة الشعرية في خلق لغة ملائمة لهما ، هذه كلها أسئلة يطمح هذا الفصل أن يجيب عنها ، أو يلقي الضوء عليها ، بقدر ما يسعفه حظه من النجاح وقلنا في الصفحات الأولى من هذا البحث أن نتاج الشعراء الرومانسيين - مدرسة الديوان وأبوللو وشعراء المهجر - كان يصل الى الشعراء الشباب في العراق ويؤثر فيهم ومن هنا فان أغلب نتاج نازك الملائكة والسياب والبياتي وبلند الحيدري وشاذل طاقه ، في سنوات نشأتهم وتكوينهم الشعري كان نتاجا رومانسيا استلهم الشيء الكثير من انجازات تلك المدرسة ، لغة وصورا وتراكيب ، ويتضح ذلك لمن يتصفح مجموعات شعرية كأزهار ذابلة وخفقة الطين ، والمساء الأخير ، وملائكة وشياطين وشظايا ورماد ولكي تتضح لنا صورة القصيدة العربية الرومانسية فاننا نشير ـ باختصار - الى قول الدكتور احسان عباس من أن الحركة المشعرية في جميع أنحاء العالم العربي كانت في تلك الفترة تتقلب على مهاد الأحلام وتسبح في الأضواء والعطور كان محمود حسن اسماعيل قد بنی کوخه الريفي الجميل فجذب اليه كثيرا من الشبان الذين يؤثرون الحياة الريفية وكان المهندس علي محمود طه يتنقل تائها في زورقه بين عوالم تتدفق فيها الفتنة ويعج فيها السحر (1)
ويجد قارئ الشعر العراقي الحديث أن أغلب قصائد الشعراء ابان تلك المرحلة انما هي قصائد حب تتأرجح بين التوق الى امتلاك الحبيبة ، والتوسل اليها ، وبين الحزن والبكاء الناتج عن فقدان المرأة ، وهذه الموضوعات تبدو امتدادا أيضا لموضوعات الشعراء الرومانسيين العرب الذين لم يتخلص مضمون أشعارهم - كما يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر - 1 من التركيز تركيزا شديدا على علاقة الرجل بالمرأة المرأة الحلم والمرأة الملاك (2) ومن هنا فان لغة شعر تلك الحقبة كانت - بشكل عام - مما ينبثق عن الفاظ الحب والعشق وما ينتج عنه من عواطف كالأسى والفرح والبكاء ، أو مما يتأتى من معجم الطبيعة - ان . صح هذا التعبير - لأن الشاعر الرومانسي الشاب غالبا ما كان يوحد بين المرأة والطبيعة ، ويتوق لامتلاك حبيبته والتفرد بها بعيدا عن هذا العالم في كوخ هادئ بعيد وسط غابة خضراء لم تطأها أقدام بشر تعالى نشيد بأحلامنا على شاطئ الحب كوخا جميل نوافذه من دموع الضحى وأستاره من لهاث الأصيل وموقده قبل يصطلي عليها ملاك هوانا النبيل (3)واذا كانت تلك الألفاظ والتراكيب من نوع الغابة والشاطئ الأخضر والنجم الوضاء والنهر الحزين، والكوخ النسائي والنهر الهادئ ، والزوارق والنخيل ، والبسمة الحالمة ، والغروب والأصيل والغمام والدجى المسحور ، والليل المخمور ، والسكون الحالم ، والريف والورد والياسمين والأفق الملبد هي جزء من مكونات لغة الشاعر الرومانسي العراقي آنذاك ، فاننا لا نستطيع أن نقول إن مثل تلك المفردات أو التراكيب هي مفردات رومانسية ، فالمفردة اللغوية أو التركيب البسيط للجملة تنعدم فيه تلك الصفة التي تربطه بمذهب أدبي معين لأن المفردة انما هي المادة الأولى التي لا تحتمل مثل هذه المزايا ، وانما يجيء وصفها بأنها رومانسية من خلال المضمون والتركيب اللغوي الشامل للقصيدة ، وحين يقول الباحث ان هذا المعجم هو معجم أن هذه اللغة انما اللغة الرومانسية فانه يعني انبثقت عن الموقف الرومانسي للشاعر أو رؤية الشاعر الرومانسية للواقع ، ولقد كان الشاعر العراقي المعاصر في بداياته ينظر الى ما حوله نظرة ذاتية تعني بمشكلاته الشخصية قبل أن تتوجه إلى الواقع الشامل، ويكتب أشعارا غنائية تصور عواطفه ولواعجه وأحزانه غير أن هذه النزعة الرومانسية التي وصلت الى الشاعر العراقي الجديد لم تكن بذلك التوهج ، وتلك الحدة التي شهدها الشاعر العربي منذ العقد الأول من هذا القرن حينما كانت سمة مرحلة شعرية كبيرة لها شعراؤها الكثيرون ونتاجها الغزير (4) ، يقول عبد الجبار عباس « أما الجيل التالي جيل السياب ونازك الملائكة والبياتي وبلند، فلم يكن تبينهم لها في مجاميعهم الشعرية الأولى تمثيلا لمرحلة حضارية عاصروها كما كانت عند جيل أبوللو ، لأن هذه المرحلة من حياة المجتمع العربي بدأت بالانحسار على اثر انفتاح هذا المجتمع بعد الحرب العالمية الثانية على ملامح واقع جديد ، وتيارات فكرية ، وفنية جديدة ، وانما كان تبنيهم لها تمثيلا المرحلة ذاتية كان يمر بها هؤلاء الشعراء الشباب ، وتكاد هذه الملاحظة تصدق على جيل الشعراء الشباب لا في العراق فحسب بل وفي الوطن العربي عامة (5) أي أن الشعراء الشباب تبنوا الرومانسية وهي في فترة ذبولها ، ولم يصلهم منها غير الاهتمام الشديد بعواطف الحب وتصوير الطبيعة بلغة ناعمة منمقة منتقاة بعناية ، كما يقول صلاح عبد الصبور
(6)
واذا آمنا بأن لغة الشعر شديدة الارتباط بموقف الشاعر من الحياة ورؤيته لها فاننا نستطيع القول إن تلك النزعة الرومانسية التي غطت مجمل الشعر العراقي الحديث إبان نشأته أخذت تخفت تدريجيا ، ويزداد هذا الخفوت كلما ازداد اهتمام الشاعر بقضايا الانسان والواقع العربي والعراقي ، وهكذا نرى الشعر في الخمسينات وفي السنوات اللاحقة لها يلتصق التصاقا حميما بالمشكلات الجماعية ، ويطرح المضمون الواقعي الانساني في الشعر ولقد أدى تغير موقف الشاعر ونظرته الى الحياة ، الى تغير مضمونه الشعري وبالتالي تغير لغته الشعرية التي لم تعد سيلا من الفاظ الحب التي تؤله المرأة ، وتضفي على الطبيعة - من خلالها - بهاء وجمالا لا نظير له وسيرى متابع الشعر العراقي والعربي أيضا منذ منتصف الخمسينات التغير الكبير في نظرة الشاعر الى المرأة نفسها التي تحولت من ملاك هائم بين الزهور والفراشات الى بشر يحيا الواقع ويتحد به ، صارت جزءا من الوطن والقضية والمشكلة احببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه (7)وليست الدعوة الى استخدام لغة الحياة اليومية بالجديدة ، وانما هي جزء من معطيات الحركة الرومانسية في الأدب العالمي فعلى خلاف وجهة النظر الكلاسيكية التي تعتد بأسلوب الطبقات الارستقراطية وتقسم الألفاظ الى نبيلة وغير نبيلة كما هي حال طبقات الشعب مثلاً وترى أن لغة الشعر الحق والنموذج الصادق للشعر الصحيح يتمثلان في لغة الملك والحاشية والنبلاء (8) على خلاف هذا قبل الرومانسيون كل الكلمات ، حتى تلك التي تبدو عامية أو مهملة وربما كان الخلاف والنقاش الذي نشأ بين شاعرين رومانسيين كبيرين هما ورد زورث وكولرج ، منذ نشر الأول منهما آراءه في مقدمته الشعرية لمجموعته الأقاصيص الشعرية الوجدانية عام 1890 ودعا فيها الى أن تكون اللغة مأخوذة من أفواه الناس في الحياة الحقيقية هي لغة الشعر(9) نقول ربما كانت تلك مناقشات من أهم وأقدم ما وصل الينا بهذا الخصوص ثم تلقف الشعراء تلك لدعوة ، ووصلت الى الحد الذي تبناها شاعران كبيران من شعراء هذا العصر هما را باوند الذي كان يقول بتضمين الشعر الحديث العادي واليوت المؤمن علاقة بين الشعر والكلام المحكي ) (10) والذي جعل مقطعا كاملا من قصيدته الأرض الخراب يجري بلغة محلية عامية (11) وليس صوابا القول ان توجه الشاعر العراقي المعاصر الى لغة الحياة اليومية ، حلالها محلا في قصائده قد جاء بتأثير مباشر من آراء ورد زورث أو اليوت غير أنه من لأمور المؤكدة ان وعي الشاعر الجديد وموقفه الواقعي واهتمامه بما يدور حوله مشكلات اجتماعية وسياسية والتصاقه الشديد بالقضايا التي تهم المجتمع ككل هيأه الى الاقتراب من لغة الناس وتوظيفها في القصيدة ، أما ما ترجم بعد دورة تموز 1958 في مجال الأدب الواقعي والاشتراكي رواية وقصة وشعرا دراسات نقدية فقد أسهم في تأكيد هذه النظرة الى اللغة في الشعر في محاولة
لتقريبه من مدارك الناس ولردم الهوة بين الشعر والقارئ الذي كثيرا ما شكا من صعوبة الشعر الحديث، وتعقيد تراكيبه وصوره ومع هذا كله فان عبارات مثل الكلام المحكي أو لغة الحياة العادية : لغة الناس اليومية تحتاج الى وقفة متأملة ، لأنها تبدو غائمة ، وغير واضحة تماما ، أيراد منها توجه الشاعر الى لغة الناس المتداولة التي تنبثق عن حياتهم وشؤونهم اليومية ؟ ليجعلها مادة قصيدته اللغوية، وكيف يتأتى له ذلك ، ومثل هذه اللغة ليس لها حظ كبير من الجمال ، وصلتها بلغة الكتابة الفنية واهية لأن لغة الكتابة ، وكتابة الشعر بالذات لا بد أن تكون أكثر اشراقا وصفاء وذات قدرات خاصة على تحمل المعاني والرؤى التي يمتلكها الفنان ويحاول التعبير عنها بشكل فني متميز أم يراد بتلك العبارات لغة العصر الأدبي الجديد ، الذي اتسعت فيه المفردة وتمكنت أن تكتسب مدلولات معاصرة ليست بعيدة جدا عن فهم الانسان الذي لا يمتلك ثقافة لغوية عالية ، ان هذا الافتراض هو الأقرب الى المنطق ، أو الى ما يراد لن أن نفهمه من مثل تلك العبارات ولعل في مقال اليوت الذي ترجمه الدكتور النويهي في « قضية الشعر الجديد » ما يفيد في توضيح هذا الاشكال ، يقول اليوت اننا لا نريد من الشاعر أن يقتصر على المحاكاة الحرفية لطريقته هو في الكلام العادي، وطريقة أسرته وأصدقائه لكن ما يجده في هذه البيئة هو المادة الغفل التي يجب أن يصنع منها شعره (12) وهذا لا يعني استلهام لغة الناس استلهاما مباشرا ، وانما يشير الى أن تلك اللغة والألفاظ بما تحمله من دلالات وايحاءات ينبغي أن تكون مادة أولى ، قابلة للتشكيل وللصياغة التي تمنحها - ضمن الجملة الشعرية وأسلوب الشاعر ـ كيانها الأدبي المتميز الذي بقدر ما يقترب من اللغة كما هي عند الناس فانه ينأى بها ويحلق ليكسبها جمالا وتفردا أدبيا ، ويضيف في مكان آخر من مقاله قائلا « يجب أن يكون بين الشعر ولغة الحديث في عصره عصر الشاعر ما يجعل سامعه يقول هكذا كنت أتحدث لو استطعت أن أتحدث شعرا (13) وهذا يدلل بوضوح على أن اليوت يرى أن
هناك بونا بين اللغة كما يستخدمها الانسان في حياته وبين لغة الشعر التي تظل أسلوبا خاصا ، طموحا وأمنيات بعيدة عن الانسان غير الشاعر والذي لا يستطيع أن يتحدث بطريقة شعرية أبدا ، ولذا يقول أرشيبالد ماكلش الكلمات في القصيدة تتخذ وزنا أثقل من الوزن الذي تحمله الكلمات نفسها عندما نصادفها في الكلام العادي أو في صفحة جريدة ، أو حتى في صفحة من الكتابة النثرية ، اننا نلمس تكثيفا لمعانيها (14) ولعل هذا الوزن الأثقل والتكثيف هو أولى مهام الشاعر البارع لأن عمله تنقية اللغة السائدة التي هي ثـ ثمرة الحياة العملية ، والارتفاع بها بجهوده الخاصة الى خلق مثالي كما يقال (15) ولقد قادت الشاعر العراقي قناعاته بضرورة الافادة من اللغة اليومية التي تنبثق عن شؤون حياة الناس العادية ، الى شيوع أنماط من اللغة العامية أو النثرية التي تسربت الى بنية القصيدة اللغوية ومن هذه الأنماط ، المفردة ، ومجموعة من المفردات ثم العبارة وأخيرا القصيدة كلها أو جزء كبير منها لأن هناك قصائد كاملة تجري بلغة توشك أن تكون عامية وسنأتي هنا على نماذج معدودة تمثل هذه الأنماط من التعبير اللغوي تجنبا للإفاضة ورغبة في تكثيف الحديث وقبل أن نعرض لهذه النماذج ينبغي أن نشير الى أننا لسنا ضد هذه الأنماط من الاستخدام . ، ولسنا معها أيضا ، لأننا نرى أن هذا التوجه ينبغي أن يكون حذرا ومشروطا ، بمعنى أن يكون مما تستدعيه الضرورة الموضوعية أو اللغوية أو الحالة لنفسية التي يكون الشاعر فيها وان لا يبدو رغبة شخصية غير مبررة لا تخضع ضوابط ، لأن هذا قد يقود الشاعر الى الابتذال الواضح والركاكة المخلة التي تسيء للغة القصيدة أكثر مما تنفعها ومع اهتمام وعناية السياب بلغته وتراكيبها التي تقترب بشكل أو بآخر من لغة تراث العربي وسنشير الى ذلك في هذا الفصل وفي فصل الصورة أيضا ، فان في شعره العديد من الألفاظ العامية وربما كان بعض هذه الألفاظ ينحدر من أصل لغوي فصيح ولكنه قد صار بتطور الحياة وتعاقب الأجيال جزءا من اللغة العامية ، ومن هذه الألفاظ مثلا ما جاء في قوله ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا ندية صفراء من ذل وحمى ، ذل شحاذ غريب بين العيون الاجنبية بين احتقار وانتهار وازورار أو خطيه والموت أهون من خطيه من ذلك الاشفاق تعصره العيون الأجنبية(16) و خطية كلمة اشفاق في اللهجة العراقية والكويتية الدارجة ويشار بها الى من هو في حالة مأساوية ، أورثه محزنة ويبدو أن السياب كثيرا ما سمع . هذه المفردة تطلق عليه أيام كان متغربا وجائعا باحثا عن عمل في الكويت ، فوظفها وكان التوظيف موفقا حقا ، وذلك لأكثر من سبب فالشاعر أراد أن ينقل للقارئ تلك الحالة المأساوية التي يقال له فيها خطية وهنا تصير المفردة قادرة على احتواء الموقف برمته ، والايحاء به وسیرى القارئ انه يندر حقا وجود بديل لغوي يستطيع أن يعبر بشكل تام عن المعنى الفاجع الذي تحمله لفظة خطية وأخيرا فان لهذه اللفظة ميزة أخرى وهي أنها تتساوق في الايقاع مع ندية التي تقدمت وهذا التوافق جهل منها قافية مناسبة وجميلة ، عفوية لا تحمل شيئا من التصنع والتكلف. من هنا تمتلك تلك المفردة الضرورات التي تحدثنا عنها، ففيها اتحدت ضرورتان هما الضرورة النفسية واللغوية واذا كان السياب قد وفق في خطية فانه قد أخفق اخفاقا ذريعا في توظيف مفردة أخرى في قصيدته سريروس في بابل
لكن سربروس بابل ، الجحيم
يجب في الدروب خلفها ويركض
يمزق النعال في اقدامها يعضعض
سيقانها اللدان ، ينهش اليدين أو يمزق الرداء(17)
والشاعر يتحدث عن الكلب الأسطوري المرعب سربروس الذي يصوره راكضا وراء عشتار ليمزق جسدها الجميل و يعضعض صيغة شعبية للفعل يعض ولا نجد لهذه المفردة ضرورة تحتم توظيفها وذلك لأسباب أيضا ، منها أن يعضعض لا توحي من ناحية الدلالة بتأكيد معنى العض القاسي الذي كان يطمح الشاعر الى تصويره العض الشديد الممزق وربما أوحت بالدلالة المضادة أعني أنها قد تطرح معنى الفعل الذي يدل على الألفة ، المداعبة التحبب أو شيء آخر قريب من هذه المعاني ثم انها ليست مما تستدعيه أو تحتمه الضرورة اللغوية لأن بإمكان الشاعر أن يجد البديل الأمثل عنها في اللغة الفصحى ، والذي يدل على قسوة الفعل ، أما كان يستطيع القول مثلا يمزق النعال في أقدامها يحرق سيقانها اللدان وسنرى هنا ان يحرق تبدو منسجمة مع فعل الكلب الأسطوري لأن الشاعر كان قد وصفه في أول القصيدة بأنه محرق أشداقه الثلاثة الرهيبة احتراق يؤج في العراق ولكن الذي منع السياب عنها هو حرصه الشديد على القافية لأن يحرق لا تتجاوب في الصدى مع يركض فلجأ الى يعضعض التي جاءت قافية نابية ومتكلفة ، واذ نتجاوز اللفظة الشعبية ومدى نجاح الشاعر في توظيفها فاننا سندرك أن الصورة الشعرية بشكل عام، أو المعنى كله هو معنى عادي ، غير مثير ولا يدل على مهارة والا فأية قيمة فنية يمكن أن تنشأ من أبيات تقول ان كلبا رمز للحاكم يركض وراء عشتار ويمزق نعالها ويعض رجلها الجميلة ويدها ويمزق ثوبها ويبدو بلند الحيدري معجبا اعجابا شديدا بالفعل داس يدوس دون أن نجد مبررا لهذا الاعجاب الذي دفع الشاعر الى ملاحقة هذا الفعل من مجموعة شعرية الى اخرى ورأى فجره جبينه (18) أو أيها الأنسان يامن دستني (19) أوبدلي النور بالظلام ودوسي تحت رجليك عمري المكدودا (20) واذا كنا في أبيات السياب أوبلند أو غيرهما (21) بعضا من هذه المفردات الشعبية وكثير منها ينتمي في أصوله الى اللغة الفصيحة فان هذه الظاهرة تتكرس في شعر حسين مردان تكريسا واضحا ولا تكاد تخلو قصيدة واحدة من تلك المفردات التي تتصف بأنها موغلة في الشعبية أي ليس لها أصل فصيح الامر الذي أضفى على لغة الشاعر ركاكة وشعبية واضحة ففي قصيدته الطابوحة نقرأ وأنت في نفنوفك الانيق طابوحة ترش في وجوهنا البريق وثغرك الصغير علبة حلقوم على شفاهنا تذوب ومن ترانيم العيون السود والدموع سالوفة ليس لها مثيل لاح له الجمار فوق كتفك الخليع فكل ما فيك من الورود ومن نزاكه الحديث(22) ولعل القارئ العربي سيجد صعوبة في فهم هذه الأبيات ، ولقد تنبه الشاعر نفسه الى أن القارئ غير العراقي لن يفهم حديثه ، فالحق في آخر المجموعة كشفا بالمعاني التي تحملها هذه المفردات الشعبية فقال مثلا الطابوحة حشرة صغيرة في مؤخرتها مادة فسفورية تضيء في الليل فتبدو كمصباح صغير يتألق في الفضاء انها اليراعة اذن الحباحب ولسنا ندري لم لم يقل وأنت في نفنوفك الأنيق يراعة ترش في وجوهنا البريق أما تعريف الشاعر لـ النفنوف و الجمار و النزاكة فسيقودنا - عبر القصيدة كلها - الى تقرير حقيقة قال النفنوف ثوب فيه خفة ويقصد أنه يشف عن جسد المرأة و النزاكة الرقة في أقصى درجاتها هذه المفردات اذن تلتصق عند حسين مردان بموضوعاته الغزلية ذات الحس الجنسي المباشر ولكن الشاعر كان يستطيع أن يقدم الاحساس بالجنس من خلال لغة فصحى كما رأينا في عدد غير قليل من قصائد نزار قباني ويبدو ان الذي صرفه عن هذا هو انه كان يحاول تقريب معانيه الشعرية من نساء عراقيات معينات تعلق هو بهن وقد لا نكون بعيدين عن الصواب لو أننا قلنا أيضا انهن أنصاف أميات أو أميات لأنهن بحاجة الى مثل هذه اللغة لكي يفهمن شعر شاعرهن، ان هذا هو التفسير الوحيد لشيوع هذه الظاهرة في شعر حسين مردان وفي شعره الغزلي بالذات
في نماذج شعرية أخرى يتسع حجم توظيف اللغة العامة ، وتجتمع المفردات لتشكل تركيبا أو عبارة ، ففي قصيدة السياب المومس العمياء يمر بائع الطيور وتستمع المومس الى صوته ، وتقترب منه وتوسلته فدى لعينك خلني بيدي أراها وتمس أجنحة مرقطة فتنشرها يداها وتظل تذكر ـ وهي تمسحهن ـ أجنحة سواها كانت تراها وهي تخفق ملء عينيها تراها (23) وفدى لعينك خلني » تعبير فصيح في الأصل ولكنه تحول على ألسنة الناس الى صيغة شعبية (24) كثيرا ما ترددها المرأة والتصقت بلغة النساء الشعبيات دون الرجال وتوظيف السياب لهذه العبارة توظيف موفق، فقصيدة الشاعر قصصية وانطاق البطلة بلغتها المحلية الخاصة أمر غير معيب في الرواية أو القصة والعبارة كما أوردها الشاعر تطرح موقفا نفسيا أيضا ، مشحونا بالأسى و التوسل ومن يتأمل العبارة فدى لعينك ويربط بينها وبين غياب ضوء عيني البطلة و بيدي أراها التي هي امتداد الحالة العمى ، وتعكس توق المرأة الى مجرد تلمس الطائر سيدرك ان هذه الكلمات الشعبية كفيلة بأن تخلق فينا الاحساس بالفاجعة الشخصية التي تعيشها بطلة القصيدة ويزاوج عبد الرزاق عبد الواحد في موضع من قصيدته المصادرة التي مرت بنا في الفصل الثاني من هذا البحث بين الاداء الفصيح والعبارات الشعبية كتوظيفه تلك الاهزوجة التي ترددها الأمهات العراقيات، والتي تصور فخرهن بأولادهن الذين صاروا أبطالا يقول بطل القصيدة وهو يتحدث عن موقفه أيام الحرب ، ويشرح لمن يحاكمه أفعاله كنت أدفع دبابتي في وجوه التماسيح ملغومة بالأهازيج
بالشعر ملغومة بالتي طرحت بعباءتها وهي تردس
هزيت ولوليت الهذا كنت هذا الذي زاحمت فيه كل الشماتة والموت (25) وتوظيف هذه العبارة الشعبية ، دليل مهارة وصنعة مقتدر لأنها مما يتطلبه لموقف ، كما انها جديرة بتفجير الغضب المحتدم في نفس البطل أثناء المعركة ، حيث يتخذ من اهزوجة أمه وفخرها به قوة جديدة تدفعه للثبات في مواقع القتال لأنه يعرف جيدا مدى ما تثيره هذه الكلمات في نفسه تردس وهزت ولولت (26) واذا كانت هذه الكلمات قد وظفت لإبراز الموقف النفسي فان لها وظيفة أخرى تتعلق بتوضيح بعض ملامح الشخصية داخل القصيدة ، فمن خلالها سيتعرف القارئ على بيئة البطل ، وسيتأكد له انه ينتمي الى بيئة ريفية جنوبية لأن الأم التي تطوح بعباءتها و تردس » هي أم من الجنوب العراقي بالتأكيد واذ نتجاوز المفردة الشعبية التي لا تشكل خللا كبيرا في لغة القصيدة الا اذا شاعت شيوعا واضحا كما هي عند حسين مردان أو بدت بدون وظيفة فنية ، فسنجد عددا غير قليل من القصائد ولدى أهم الشعراء لا يخلو من تراكيب نثرية أي جمل نثرية كاملة وهذه الجمل تشبه تلك الألفاظ لأن بعض مفرداتها ينتمي الى اللغة الفصحى ولكنها من خلال التركيب قد اكتسبت حسا وأداء شعبيا واضحا وهنا يتحول الأداء اللغوي - بخلوه من الصورة وقربه من التقرير - الى تعابير لا تفرق كثيرا عن لغة أي انسان على قسط بسيط من الثقافة اللغوية يقول البياتي فمهنة التمسيح في زماننا يبرع فيها العور والأذناب (27) ومهنة التمسيح اصطلاح شعبي يشار به لمن يمسح أ أكتاف الآخرين طمعا في نوالهم، وتدليلا على ضعته وتملقه وخلوه من الكرامة الشخصية وقارئ هذه الأبيات سيدرك أن عبارات من هذا النوع تبدو بلا وظيفة فنية ، وسيبحث دون جدوى عن المبرر المعقول لورودها أو عن الضرورة التي حتمت الافادة منها ويتسع الأداء النثري في قصائد أخرى للبياتي ويتجاوز المفردة أو المفردة وصفتها ليشمل تركيبا أوسع وسيقول لنا بلغة لا تسمو كثيرا على لغتي وأنا أكتب هذه الكلمات ، سيقول انه مر باستانبول ، لم ينزل بها لأنه كان على عجالة من أمره مررت باستانبول لا أقول نزلتها لأنني عجول (28)ولأن الشاعر العراقي ليس بعيدا عن السياسة وانما هو فيها دائما وجزء منها فقد انتقلت لغة السياسة والشعارات السياسية الى قصيدته وبدأ ينظم تلك العبارات التي هي شبه لافتات اعلامية ودعائية تؤكد انتماءه وموقفه السياسي ولا تخلو مجموعة شعرية من هذا النمط التعبيري ، وربما كان البياتي أكثرهم جميعا تعبيرا
عن مثل هذه الشعارات وبخاصة في فترة صدور أباريق مهشمة والمجد للأطفال والزيتون و عشرون قصيدة من برلين يقول البياتي في قصيدته فيت مين من مجموعته أباريق مهشمة لامجد تحت الشمس إلا مجد أبناء الحياة والخبز والحرية الحمراء والغد والمصير الموت للمستعمرين يا أنت يالاؤوس ياغاب العبير في قلب ماردنا الموت للمستعمرين (29) وترد في قصيدته أغنية خضراء الى سوريا هذه العبارات ولك النصر وللفاشست الموت الزؤام (30) أو يا يسقط دفاعهم يا يسقطون يا يسقط الأوغاد أعداء الحياة السارقون ربيعنا يا يسقطون (31) أو يا فقراء العالم المنهوب اتحدوا يا فقراء العالم المنهوب (32) وتقول نازك الملائكة في قصيدتها تحية الى الجمهورية العراقية التي نظمتها الشاعرة في الرابع عشر من تموز 1958 السوق صحا يا ورد حذار من نغمته الصهيونية ومخالبه الأمريكية جمهوريتنا عشت سلمت من الطغيان (33) ولا يخلو شعر بدر شاكر السياب من نظم مثل هذه العبارات النثرية ذات العلاقة بالموقف السياسي للشاعر كما حدث في قصيدتيه الى جميلة بوحريد و رؤيا في عام 56 هذه نماذج قليلة توضح لنا بشكل جلي نمطا من الأداء اللغوي الشعري الذي شاع في الشعر العراقي المعاصر بدعوى الواقعية واستلهام لغة الواقع والذي اساء الى البنية الشعرية إساءة واضحة وجعلها فنا للشعارات لا يرتضيه فنان او ناقد ، بل يرفضه حتى أرباب السياسة الكبار وهنا لا بد لنا أن نتذكر موقف ماركس وانجلز من هذا النمط من الفن اذ يقولان ان الفن الدعائي الصارخ هو فن سقيم وغير فعال على حين أن الفن ينطوي على حيوية وخيال وشكل ومهارة (34) وربما ذهب الشاعر الى أبعد من هذا وتجاوز المفردة الشعبية ، والعبارة ، والتراكيب النثرية الاخرى ، فكتب قصيدته كلها بأداء شعبي كما فعل صلاح نيازي في قصيدته التي لا يمكن لقارئ غير عراقي أن يفهم منها شيئا وأبو جبار من عام بحي الشاكرية دائخ الصدغين صافن وصراخ الناس سياراتها الكثر الطرية مسبحات خرزة في اثر خرزة لينات مثل شكوات حليب وهو يدري أن تسواهن تبيع الروبة الزينية في سوق المدينة كانت أم جبير- أح – تكرمون زوجة مستورة حسنى بهية حسها لا يطلع منذ أسبوع بعاشوراء جبار كبير يغبش الصبح على الريق وفي سرواله الخاكي أكلة انه صانع فيترجى صغير (35) ويعلق طراد الكبيسي على قصيدة صلاح نيازي قائلا ان هذه القصيدة مأساة من المآسي التي ارتكبت باسم الشعبية في الشعر العراقي بعد ثورة تموز 1958 (36) وليست قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد سطوح ببعيدة عن الأداء بالأمس مات أبو فلان أبناء هذا الوقت هه سحقا لهذا من زمان لم يبق الا عرضنا حتى كلام الله مات لم لم دعيهم يضحكون أفليست الدنيا لهم يتخيرون ويتركون يتزوجون وينجبون غدا يتدللون سنذوق لحما تفهمين وله قصيدة أخرى بعنوان من حياتنا تجري على هذا النهج من الأداء اللغوي الشعبي أيضا(37) ويزاوج ياسين طه حافظ في قصيدته النشيد بين البناء اللغوي الفصيح والاداء الذي أراد له أن يكون له عاميا وشعبيا في محاولة لخلق لغة مناسبة لموضوعه الذي يتغنى فيه بأمجاد الوطن فيقول تهدر مابين بيتي والأفق حفارة وقطار وحاصفة ومعمل اسمنت وشاحنة اثر أخرى تمر(38) مطعمة ومسورة بالمكائن تجهر بالقطع والطبع والقلع والردم والسحق والصب والفتح والغلق والضرب والصد (39) نفس تدور مع القايش في فرح الميكانيك نفسي تتسلق بمعناه الشامل أحد المصادر الأساسية البالغة الأهمية التي
تكون لغة الشاعر الحديث ، وتمنحها الأصالة والتدفق والالتصاق بمعطيات الأدب لذي هو جزء من تكوين الأمة وجزء من تاريخها ووجودها ، وهذا الموروث الأدبي و للغوي لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه اذا أراد الشاعر لأدبه ولغته النمو والامتداد و لتطور ولا يخلو أي شعر عظيم في أدب أية أمة من الأمم من هذه الرابطة التي نشد الشاعر الى أجداده الشعراء كما يقول اليوت (40) غير أن هذه الرابطة التي نشد الشاعر المعاصر الى أسلافه لا تعني المحاكاة ، أو المحاكاة الحرفية للغة الأقدمين مفردات وأساليب وبناء ولو فعل هذا لصار فريسة للماضي ، وصورة تقليدية منه أن الشاعر المقتدر انما يتمثل الموروث ويعيد خلقه خلقا جديدا يحمل خصائصه فردية وطابع عصره لا يبدو تقليدا منتميا الى عصور ماضية ، وليس هو شكلا منفلتا متحررا تماما لقد حاول يوسف الصائغ في دراسته لحركة الشعر الحر في العراق أن يتلمس مبررات التي تجعل من شاعر قريبا من عطاء أسلافه بينما يكون الآخر بعيدا أو أكثر بعدا عن اللغة العربية التي حملت الموروث الأدبي شعرا ونثرا ويرى الصائغ مرد ذلك يكمن تارة في مدى قرب الشاعر من دراسة الأدب العربي في الجامعة ، ويراه مرة أخرى نتيجة لموقف الشاعر السياسي ويقول في هذا المجال ان بعض شعراء أكمل دراسة الأدب في قسم اللغة العربية بدار المعلمين العالية أو في كلية لآداب ، وقد مكنت الدراسة هؤلاء الشعراء من أن يكونوا قريبين من الشعر العربي تقديم ومن الطبيعي أن ينعكس أثر ذلك بحدود متفاوتة في لغة القصائد التي نتجوها في تلك السنوات (41) ويقول في مكان آخر من بحثه ان اهتمام يساريين والماركسيين بايصال النتاج الأدبي للجماهير وتأكيدهم أهمية اللغة الشعبية - نطوى على قدر كبير من التحرر ازاء اللغة (42) ويضيف أما الاتجاه القومي فلقد ظل بشكل عام محافظا في نظرته الى اللغة باعتبارها تراثا مقدسا ، ولهذا ظ هذا الاتجاه خاضعا لضوابط اللغة القديمة، شاجبا كل خروج على هذه الضوابط والحدود باعتبار ذلك انتقاصاً من التراث (43) ومع أننا لا نعرف على وجه التحديد ما الذي يعنيه الصائغ بهذه الضوابط والحدود ، فاننا نرى أن قضية تخرج الشاعر من دار المعلمين العالية ليست ذات شأن كبير في كونه مقتربا من التراث مبتعدا عنه ومعطيات الشعر العراقي نفسه تؤكد هذا والصائغ يعرف أن البياتي مثلا وهو خريج قسم الأدب العربي وأحد كبار الشعراء العراقيين يخلو نتاجه الشعري حتى في السنوات التي كان قريبا فيها من أيام تخرجه في الجامعة من تلك الملامح اللغوية التي تشده الى التراث العربي ، أما السياب فلم يكمل دراسته في قسم الأدب هذا يفوق زملاءه كلهم اقترابا من الموروث الأدبي واللغوي العربي وهو مع تذكرنا أن السياب والبياتي كانا في تلك الحقبة يساريين فالأول منهما شيوعي والآخر كان قريبا من الحزب الشيوعي أو اليسار عامة أدركنا أن كون الشاعر خريج أدب عربي ، وكونه ماركسيا أو قوميا ، مسألة لا تحقق ارتباط الشاعر بالموروث تحققا كافي اذ ليس كل شاعر ماركسي بعيدا عن التراث وليس الشعراء ذوو الاتجاه القومي ملتصقين جميعا بالتراث بشكل واضح تماما ، ولو قرأنا أغلب شعر الكمالي وعلي الحلي ومحمد جميل شلش في الفترة التي عنى الصائغ بدراستها (44) ونستثني هنا القصائد ذات الشكل التقليدي، أو قصائد الحماسة - لوجدناه لا يتميز كثيرا من الناحية اللغوية عن شعر زملائهم الذين عرفوا بالماركسيين أو أنه كان جزءا من اللغة الشعرية الجديدة السائدة التي يكتب بها الشاعر الشيوعي أو البعثي أو غيرهما على حد سواء اننا لا نستطيع أن ننفي تماما أن الدراسة الجامعية في قسم اللغة العربية بهذه الكلية أو تلك أو الاتجاه الفكري الذي يحمله شاعر ما قد يجعله قريبا الى حد ـ نظريا أو تطبيقيا - من التراث ، ولكننا لا يمكن أن نطمئن الى أن تلك المسببات وحدها هي العامل الذي يتحول الى قاعدة أساسية أو استنتاج جوهري يتم من خلاله تصنيف الشعراء قربا من التراث أو بعدا عنه فتحقق هذه العلاقة سلبا أو ايجابا انما هو موقف فردي بالدرجة الأولى غير أن هذا الموقف الفردي وليد مسببات ومؤثرات أيضا وهذه المسببات قد لا تكون بالضرورة ايديولوجية أو دراسية في قسم اللغة العربية بل هي في الغالب ادراك ووعي ثقافي عام أو خاص (45) نظرة ثقافية معينة قد تجعل هذا الشاعر قريبا من لغة التراث وذاك متمثلا لها وثالثا بعيدا عنها وربما تعزز الموقف الفردي بالدراسة الجامعية أو تبلور وتأكد عبر نظرة نابعة عن موقف ايديولوجي وضروري هنا أن نقول ان الصائغ لا يتناسى الموقف الفردي (46) ولكنه لا يوليه من الأهمية ما يولي تقسيماته تلك وتتحقق علاقة الشاعر بالتراث الأدبي واللغوي من خلال مستويات متعددة منها الألفاظ ومنها التراكيب ثم استحياء الجو اللغوي الشامل لنمط . موروث من الأداء وأخيرا ما يحدث في حالة التضمين والاقتباس، وموقع هذا من بحثنا في فصل الصورة الشعرية .وليس جديدا القول بأن السياب كان أقرب شعراء جيله الى المفردة العربية الموروثة التي لم يعد استعمالها شائعا في لغة هذا العصر ففي شعره يرى القارئ العديد من الألفاظ كـ المرابع الأثافي الخدم للسيف واشرأب ويدلهم وأنصاب ، والعارض السحاح (47) وغير هذه المفردات ما يصعب عده وكلها توحي بأن الشاعر كان دائم القراءة والمراجعة للشعر العربي القديم وان هذا المعجم الموروث الواسع هو مما تسرب الى لغة الشاعر من تلك القراءات ان ما يهم الباحث عندما يتعرض لقضية المفردة الموروثة وغير الشائعة في لغة عصرنا هذا هو أن يلمس الدافع الذي حدا بالشاعر لهذا الاستخدام أكان لهوى خاص صدفة ؟ أم أن هناك ضرورة حتمت هذا الاستخدام وأخيرا أكانت له وظيفة فنية أم لا ؟ في قصيدة السياب غريب على الخليج نقرأ وهي النخيل أخاف منه اذا أدلهم مع الغروب فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب(48) ونرى أن الشاعر وظف في هذه الأبيات مفردة واحدة ليست شائعة في الاستخدام اللغوي المعاصر تلك هي الفعل الماضي أدلهم فأية ضرورة حتمت انبثاق هذا الفعل ؟ ان من يتأمل هذه الأبيات جيدا يدرك أن الشاعر - أثناء كتابته القصيدة ـ كان بحاجة الى فعل ذي مواصفات خاصة أولها أن يدل على الكثرة والكثافة وأن يرتبط بصفة لونية هي درجة من الظلمة وأن يثير حالة نفسية أيضا هي الخوف أو التوجس خيفة لدى طفل صغير يسكن غابات النخيل ويذعر منها ليلا وكل هذه المواصفات تعتبر ضرورات موضوعية ولغوية ونفسية وهنا أسعفت السياب ذاكرته ومخزونه اللغوي الذي قدم له هذه المفردة التي يتحتم عليه استخدامها لأنها تحتوي تلك المواصفات معا ولعل ضرورة مجيء هذا الفعل ستبدو أكثر وضوحا للقارئ الذي عرف وخبر صورة بساتين نخيل البصرة ليلا ، كثافة وظلمة وخوفا والتي لا يعبر عنها بدقة غير الفعل أدلهم وترد في قصيدته قافلة الضياع هذه الأبيات هيهات ليس للاجئين ولاجئات من قرار ودیار الا مرابع كان فيها أمس معنى أن نكون النار تركض كالخيول وراءنا أهم المغول على ظهور الصافنات ؟ وهل سألت الغابرين أروضوا أمس الخيول أم نحن بدء الناس كل تراثنا أنصاب طين (49) وفي هذا النص يتسع حجم توظيف المفردة الموروثة ، فنحن هنا أمام المرابع صافنات أنصاب وسنرى ما اذا كان لهذه المفردات ضرورات أو وظائف القصيدة تتحدث عن اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم بلا ديار أو وصن ولقد انتقى الشاعر أول الأمر مرابع والمرابع جمع مربع وهو موضع سكن القوم ولا يفهم منه جمع القلة ، كما انه يفتقر الى الصفات المقترنة به كالتي ارتبط بـ الدمن مثلا والتي غالبا ما تحمل صفة القدم أو البلى فالمرابع اذن لا تشير الى قدم أو جدة مكان فرح الأحبة وتجمعهم أو مكان مغادرتهم وخراب موضع سكناهم وسيرى القارئ أن هذه المفردة صارت ضرورة من ضرورات استخدام اللغوي، وذلك بعد أن أكسبها الشاعر -- من خلال التركيب - صفات اقترنت بها لأنها في البيت تبدو وكأنها تشير الى القلة لأننا بعد أن ضيعنا الديار وطن لم يبق لنا الا مرابع أي بقية قليلة من الأرض ومن خلال السياق يحس القارئ ان المرابع توشك أن تتصف بجمال ذاهب ، كانت على شيء من الجمر أيام كانت مجتمعا لأهلنا وأحبتنا ، ولكن ذلك كان بالأمس ، فالمرابع - الآن - اذر تكاد تكون خربة من هنا صارت المرابع بعد أن اكتسبت ظلالا وايحاء لغوي ضرورة لغوية تخدم المضمون والحالة النفسية، توضحها ، وتفجر الاحساس امر بها ويختار السياب ( الصافنات ) والصافنات صفة للخيول الجيدة القوية ، وهذه المفردة تتطلبها الضرورة لاستكمال الصورة الشعرية ككل والتي تهدف الى اثارة الرعب الآتي من مقدم المغول على ظهور خيولهم التي تعرف الفتك والقتال ، ولعل الصافنات هنا تحمل صفة ( البديل اللغوي الذي يغني عن التكرار لأن لفظة الخيول وردت مرتين في الأبيات المتلاحقة وليس حسنا أن تتكرر لمرة ثالثة بهذا الشكل المتتابع ويوظف الشاعر أنصاب والأنصاب جمع نصب ، ومثلها نصب والنصب والأنصاب تنتمي الى الموروث اللغوي أكثر من انتمائها الى لغة هذا العصر الذي يميل فيه المرء لاستخدام التمثال والتماثيل فلماذا لجأ اليها السياب ؟ انه هنا يتساءل أليس لنا نحن العرب الذين أصبحنا الآن مشردين بلا وطن أليس لنا ماض عن عريق ؟ أما كان آباؤنا يعرفون حقا كيف تروض الخيول وكيف يصنع النصر أم أننا بلا ماض وليس لنا من تراثنا غير أنصب هذه الأنصاب ذات الدلالة المقترنة بالوثنية والتخلف والتي أطاح بها المسلمون هذا التساؤل المحير والمرير يتطلب مثل هذه المفردة التي أضاف اليها الشاعر لفظة طين لتمعن فياثارة الأسى والحزن المتأتي من أنصابنا البدائية والرخيصة أم نحن بدء الناس كل تراثنا انصاب طين حين ننتقل الى شعر عبد الوهاب البياتي نجد أن الحصيلة اللغوية لمثل مفردات السياب قليلة جدا اذ أن مفردات البياتي غالبا ما تنبثق عن هذه اللغة الجديدة المعاصرة ذات الألفاظ الواضحة والمعنى الشائع بل ان البياتي ليبدو أحد الشعراء
لمبكرين الذين كرسوا لغة الواقع والحياة الأدبية الجديدة في الشعر وأصلوها في عملهم الابداعي وصارت من بعدهم منهجا لغويا يحتذى به الشعراء ، وهنا لا بد ننا أن نقول ان القصيدة الجديدة التي تستسقي بعض المفردات الموروثة من الشعر والأدب ليست بالضرورة خيرا من القصيدة التي تخلو من تلك المفردات ، ذلك أن لشعر ليس عملا لغويا فحسب وان كل ما تدلل عليه تلك القصيدة انما هو الذاكرة اللغوية التي يتمتع بها كاتبها هذه الذاكرة التي تلقى بظلالها على مفردات الشاعر والتواصل بين الحاضر والماضي ويعد شعر شاذل طاقه الذي كتبه منذ الخمسينات قريبا من لغة التراث لعربي وربما كان أقرب الشعراء الى السياب من هذه الناحية فالمفردة العربية لقديمة التي لم يعد استعمالها شائعا لا حصر لها في شعره ومن هذه المفردات على سبيل المثال الرضاب ، البارق الفرقد حثوة المفازة المسبغة مرزم ويلاحظ القارئ المتأمل ان أغلب هذه المفردات يأتي وكأنه مفتقر الى الضرورة التي تحتم التوظيف حين أفضى والى المقبرة الخرساء أمضى ويهيل الترب فوق الرمس حفار القبور فاذكريني(50) قد علاها اليوم قبر من غبار أسحم يا له من حلم ضائعا يبحث عن معناه بين الدمن في نهار مظلم(51)
أو وحوم فوق قريتنا غراب أعور فلج(51) اننا هنا ازاء مجموعة من المفردات الرمس أسحم دمن فلج ولنبحث عن الضرورة التي دفعت الشاعر الى التقاط هذه الكلمات فلا نجد مبرر واضحا للافادة من الرمس مثلا دون القبر هنا توشك مثل هذه المفردات :. تكون معرفة لغوية غير موظفة توظيفا فنيا ايجابيا ، ويبدو ان الشاعر لم يفلح كثيرا في اختيار لفظة الرمس لأنها من ناحية الدلالة اللغوية على شيء من الخصوصية فالرمس هو القبر القديم الذي يوشك أن يكون دارسا وواضح أن الشاعر لم يقصد هذا المعنى ثمة كلمة ينبغي أن تقال في هذا الموضع وهي أن الشاعر البارع حقا هو ذاك الذي يستطيع أن يبعث الحياة من جديد في ألفاظ هي على وشك الاندثار أو الموت ويتأتى له هذا من حساسيته الخاصة إزاء المفردة الموروثة وتكمن بعض أهمية عمله في قدرته على اكساب تلك المفردات ايحاءات جديدة ظلالا جديدة ، تنبثق عن الحالة النفسية أو الضرورة الموضوعية للعمل الشعري ولقد مر بنا قبل قليل عمل الشاعر في لفظة المرابع ومر بنا احساس السياب بالمفردة أدهم وكيف استطاع أن يشحنها بالايحاء الملائم للمناخ النفسي الذي يشيع في تلك الأبيات وسنرى هنا كيف أفاد شاذل طاقة من ذلك الفعل نفسه
اذا ما أدلهم الدجى
وغشى الوجود خيال كئيب
فلا تيأسي من رجا
ولا تحذري من رقيب هلمي الى الليل نشرب خمره
ونثمل حتى نجوب السماء
هلمي لقد أوشك الليل أن يسأما هلمي فما أجمل الكون ان أظلما(52) ان أدلهم التي كانت في أبيات السياب طافحة بالألوان والكثافة والمثيرة خالة من الخوف تحولت هنا الى شيء ناعم شفاف - ان صح التعبير - الى شيء لا يحمل من تلك الصفات التي تتوافر في الفعل الا ملامح باهتة بل ان الحالة التي يثيرها أدلهم اكتسبت من خلال السياق شيئا من الفرح لأنها غدت سبيلا الى نقاء المحبوب واحتساء الخمر معه اتبعها الشاعر بكل ما يوحي بالجمال جمال دلهم والظلمة
ها هي فما أجمل الليل ان أظلما لي
اذا ما أدهم الدجي والسماء
أنار الهوى للقلوب الظماء
لعل عبد الرزاق عبد الواحد في قصيدته الصور سيكون أكثر الشعراء العراقيين التفاتا الى توظيف المفردات الموروثة المتلاحقة وهو يلتقي مع شاذل طاقة في غياب المبرر الواضح لتوظيف تلك المفردات لقد غدت قصيدته الصور متفردة عن أي نتاج عراقي آخر ومر بنا ان الشاعر العراقي يفيد من الفاظ معدودة في قصيدته ، أما عبد الواحد فقد جعل البناء اللغوي كله موروثا وبعض الفاظه حاجة الى مراجعة المعاجم لكي يفهم القارئ قصد الشاعر ولسنا مخطئين لو نقول هذه التراكمات في المفردة الموروثة ، لم تكن الا دليلا مفتعلا على ثقافة تراثية لا غير شقوا سجفة الديجور من الأجداث مستعره وليدة توأد على الثغاء على الرّغاء على صهيل الخيل حولي تمضع الارسان
رأيت يد البسوس تجوس في الأرحام
تشد رقابها قربا
على غلمان أشأم كلهم
بجير مات
بشسع من تعال كُليب
وقربت النعامة منك مربطها فقم يا موت قم يا موت(53) وقارئ شعر عبد الرزاق عبد الواحد يفاجأ بحقيقة غريبة لأنه سيرى الشاعر ضمن موقفين لغويين يناقض أحدهما الآخر فلغة شعر عبد الواحد تقدم هذه الثنائية التي تفتقر الى تبرير واضح ، فهو يبدو حينا لغويا ينتمي الى الموروث بشكل متطرف ، وربما مفتعل ، وحينا آخر يرمي بنفسه في أحضان اللغة اليومية بل والنثرية أيضا واذ يلتقي عبد الواحد مع شاذل طاقة في غياب التوظيف الايجابي للمفردة العربية الموروثة ، فان شاذلا يتميز عن عبد الرزاق وعن غيره من الشعراء في أنه دائم الافادة من العبارة الموروثة ، وليس المفردة وحدها بل ان شيوع العبارة في شعره يبدو أكثر من شيوع المفردة واشيم بارقة الوفاء وعدت عليها الذاريات : فتی سادر لج في سيره يبنى على حبب المدام له فخارعن ضائعين في قفار التيه مدلجين(54) وفي مثل هذه النماذج وغيرها في شعر شاذل كثير تصير العبارة الموروثة أسلوب الشاعر اللغوي يتدفق بعفوية واضحة لا تفارق قصائد المجموعة الكاملة ومن هنا يغدو البحث عن الضرورة الفنية التي تدفع به لمثل هذه الاستخدامات لتراثية صعبا ، لأن اللغة الموروثة صارت لغة الشاعر المعاصر بشكل عام ومن يتابع النتاج الشعري الجيل الستينات فسيرى ان خالد علي مصطفى يكاد يكون أبرزهم في الافادة من العبارة أو المفردة التراثية (55) اذا قيس نتاجه الى نتاج زملائه كحسب الشيخ جعفر وسامي مهدي وفوزي كريم وحميد سعيد والمطلبي وغيرهم وسيمر بنا ان لغة فاضل العزاوي وهو من جيل خالد نفسه ستغدو في الشجرة الشرقية تمثلا للغة التراث وتتضح علاقة الشاعر الحديث بالتركيب الشعري اللغوي الموروث بصورة كبر حين يتعرض بعضهم لكتابة قصائد ذات شكل قديم ، وهنا نجد القصيدة وكأنها نسج على منوال الشاعر العربي لغة فخمة وجزلة كما يقال وقوافي تتناوب على طريقة الاسلاف وبعضها يبدو غريبا وتمتلىء القصيدة بالحكمة ، وبأساليب موروثة تسهم كلها في خلق قصائد تذكرنا بالشعر العربي في عصوره الماضية ، ولعل على الحلى في طعام المقصلة » وبدر شاكر السياب في قصيدته بور سعيد وكثير من قصائد طاقة ، وعبد الرزاق عبد الواحد هم خير من يمثل هذا الاتجاه في الأداء الشعري الموروث وتجنبا للاطالة فسنورد هنا أبياتا معدودة تشير الى علاقة الشاعر بالموروث مفردة وعبارة وتركيب قلى لك يا دنيا فمرتعك البلى ويالك دنيا لا تدوم عهودها اذا وعدت فالوعد منها نكوصها وان اخلفت فالخلف منها وعودها تحاربني بالشر وهي كليلة وتهزمني بالموت وهو يبيدها(56) من ترى ذلك المحضل رمل الجرف بشرى ؟ واجدل الموت جاثم يمسح المجد نحره من مدمي الجرح، والهام من جراح المعاصم لن يلم الرصاص الا الفدائيون في الساح والكمى المهاجم(57) ويلاحظ القارئ ان أغلب هذه النماذج هي صدى لقصائد عربية معروفة أو لمعان كثيرا ما ترددت في شعر الماضي ، وبقدر ما يتجلى من هذه النماذج والنماذج الأخرى مدى قرب الشاعر من التراث لغة وأسلوبا ، يتجلى أيضا مدى وقوعه في التقليد أليست المعاني التي قدمها شاذل طاقة لا تخرج كثيرا عما قدمه أبو العلاء في قصيدته التي أولها أحسن بالواجد من وجده صبر يعيد النار في زنده یا دهر یا منجز ایعاده ومخلف المأمول من وعده أي صديق لك لم تبله وأي اقرانك لم ترده أما بائية السياب بور سعيد هاويك أعلى من الطاغوت فانتصبي ما ذل غير الصفا - للنار – والخشب فتعتبر صدى لبائية أبي تمام الشهيرة السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب ويسير على المرء أن يرد الكثير من ألفاظها ومعانيها وأسلوبها الى تلك القصيدة الذائعة في نمط آخر من القصائد تغدو لغة الشاعر تمثلا للغة التراث الشعري أو الأدبي بشكل عام هنا يتم استيحاء الأجواء اللغوية الموروثة دون الوقوع في التقليد ولا يتم هذا الاستيحاء بالمفردة وحدها أو بالعبارة والتركيب انما بكل هذه الأمور معا ، وبافادة من التضمين والاقتباس والاشارة، مما يؤدي الى ما يمكن وصفه بأنه محاولة لاشاعة مناخ لغوي موروث ومثال هذا ما حصل في قصائد شفيق الكمالي
ويوسف الصائغ وبلند الحيدري وفاضل العزاوي ليعجبني انني عربي وانكم أهل بيتي
ومهما يكن فحنيني لكم فوق ما يبلغ العتب عندي
جراحي وقيدي وصمتي ووالله لا ما عدا القيد في معصمي
حديدا به ترسفون وتستضعفون وتستغفلون وأصرخ ها أيها العرب الجائعون
كلو ربكم فهو تمر الا واطردوا البائعين من الهيكل القدس بيت أبي للصلاة ـ يقول الكتاب وانتم تركتم سقايته للصوص رحی فلتدر وارصدوا البحر فالبحر رب عدو ولا يهجعن لكم هاجس واستيربوا به(58) وحين نلتقي ببلند الحيدري في قصيدته الطويلة حوار عبر الأبعاد سنكتشف أن الشاعر الذي كان بعيدا جدا عن لغة الموروث الأدبي (59) في مجاميعه خفقة الطين و أغاني المدينة الميتة و جئتم مع الفجر بدأ يقترب بشكل واضح من هذه اللغة التي تنتمي الى التراث وان علاقته القديمة باللغة التي كان يكتفي منها بما ينفعه في الاحتراز من الخطأ(60) قد تطوطدت وتجاوزت تلك الحدود وبدأ يستلهم بشكل جميل وواضح معطيات اللغة الادبية ولابد لنا أن نشير الى أن بلند يستقي مادته اللغوية في حوار عبر الابعاد من مصادر دينية أو أقرب الى الدين ونجد فيها شيئا من أثر الكتب المقدسة القرآن والعهد القديم والعهد الجديد وشيئا من لغة الصوفيين لا تأخذن الرائي بجريرة ما رأى ولا السامع بجريرة ما سمع فبالأذان التي أعطيت سمعنا وبالعين التي وهبت رأينا والعين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع وبمشيئتك القائمة على الحق نقول الحق (61)باسمك ولد وباسمك استشهد في أزمنة الضيق يوم أن عرفك في الحر المطلق ويوم أن عرف نفسه في العبد الموثق رغب فيك ورغب عنك فكان أن ثار بك عليك فقتل فاستشهد ربنا ربانا ربنا من عرفك في نفسه كبر بك عن جنتك وصغرت به جحيمك فلا هو من جنتك ولا هو من جحيمك فاقبله شهيدا من أجلك(62)
ويمكن اعتبار قصيدة فاضل العزاوي الشجرة الشرقية التي تدور حول البحث عن الانسان والصفاء الانساني محاولة ابداع تشكيل جمالي للغة من أجل خلق مناخ لغوي موروث يستقي معظم أسلوبه وعباراته من القرآن والانجيل وكتابات الصوفيين أيضا وتكتظ القصيدة بالحكايات والمشاهدات والأمثال التي هي جزء من معطيات الأساليب الدينية قال المتوحد ما لم أشهد جرحى لن أعرف نفسي ، ان الانسان ليشقى فاذا هو شيخ يسعى واذا هو طفل يبحث عن معنى (63) ان الدرب الى الانسان بعيد ما من نفس الا وتقول معي الانسان ولكن النفس تضل الدرب أفها أعطيت العاري ثوبا والجائع خبزا والعاشق حبا ؟ أفما قلت أكون فكنت ؟ وأصغى عبد الله الى نفسه ثم تهدج في البرية صوته (64) فصعدت اليه وقال انزع نعليك على بابي واصعد قلت ولكني أخشى أن أصعد ، قال اصعد لترى ظلك في الوادي قلت جميل هذا الوادي قال ادخل انك في وادي الشجرة فدخلت (65) وبشرني بالموت (66) واذ نفرغ من حديثنا عن المؤثرات التي تسهم في صنع لغة الشاعر المعاصر لا بد لنا أن نتابعها من خلال مستوى آخر هو انها أداة تعبير فإلى أي مدى ارتبطت هذه الأداة بالحالة الشعرية بتجربة الشاعر ذاتها وكيف يمكن لها أن تنبثق عن الموضوع أو الاتجاه الفني للقصيدة الجديدة وما دام عالم الانسان متغيرا دائم الحركة والتجدد فان تجارب الشعراء ستكون متغيرة ومتعددة ، تتسع لعديد من المواقف والرؤى التي لا تحصى والمشاعر التي تتراوح بين الحالات من حب وغضب وعنف ، ورجاء ، وحزن ونكد وهذه الحالات لدى الشاعر الناضج والمقتدر جديرة بأن تصوغ اللغة الشعرية التي تستطيع حملها وايصالها الى القارئ وهي متدفقة مفعمة بحرارة تلك التجربة أو الحالة ووسيلة الشاعر الى تحقيق مثل هذه اللغة يسهم في صنعها عدد من المؤثرات منها اللفظة ذاتها ثم التركيب ، وأخيرا الصورة التي يمكن لها أن تؤثر تأثيرا كبيرا في بلورة اللغة النابعة عن الموضوع الشعري ولكن ينبغي أن نقول أن هذا لن يتحقق الا على يدي الشعراء المهرة المقتدرين حقا لأن العفوية الشعرية لا تنفع كثيرا في هذا المجال وانما نحن هنا بحاجة الى وعي شديد ومراقبة نقدية مخلصة بمعنى أن يكون للشاعر عينا ناقد متيقظ في قصيدة السياب سفر أيوب التي كتبها الشاعر بعد تطواف في المستشفيات، ورحلة قاسية للبحث عن الشفاء دونما جدوى ، لقد وزعوا جسد الشاعر في القناني ومن دمه ملأ الأطباء زجاجات وزجاجات وأخيرا خاب ظنه بالعلم ، وبقدرة الانسان على شفائه ، فكتب هذه القصيدة التي هي ابتهال ودعاء واحساسات متصوف ولغة زاهد ، ولنا أن نكتفي بالمقطع الأول منها والرابع لتلمس أثر تغير الموقف على لغة الشعر تبدأ القصيدة بهذا المقطع لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم لك الحمد ان الرزايا عطاء وان المصيبات بعض الكرم(68)الذي شاء السياب له أن يكون ابتهالا ، أو مناجاة دافئة بين العبد المبتلي وربه، العبد المؤمن الذي ينطلق في شكوى حالة من تلك العبارة الدينية التي تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وبلهجة المحب أو المتصوف سيعلن ان الرزايا هي بعض من هدايا الحبيب، وان المصيبة شيء من كرمه وللقارئ أن يتأمل قدرة السياب على توليد المفردات ذوات الدلالات المتقاربة وكيف ترابطت لتمسك النسيج الشعري وتقدم المعنى المأساوي وتكشفه البلاء الألم الرزايا المصيبات وما ترادفها هنا الا من قبيل التأكيد على الحالة الشعرية التي تخلق لغتها أو تنتقي بذكاء واقتدار من اللغة ما يلائم الموقف ويمضي السياب في قصيدته دونما ضجة أو عويل لأنه ـ على ما هو فيه من أسى - في حالة رضى ، رضى العبد المؤمن المبتلي الذي يدرك جيدا انه لا يليق بمن هو في حضرة الرب أن يبدو غاضبا ، صارخا ، ناديا وبهذا الاحساس تتحول حتى الكلمات التي تثير الجزع والبكاء الى كلمات ناعمة شهور طوال وهذي الجراح تمزق جنبي مثل المدى ولا يهدأ الليل عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى ولكن أيوب ان صاح صاح لك الحمد ان الرزايا ندى (69) هنا تتحول الرزايا والمدى والجراح والأوجاع الى كلمات تكتسب احساسات جديدة غير مألوفة ، احساسات من ينظر الى جراحه وأساه وكأنها شيء زائل ومؤقت ، أو أنها قريبة جدا من أن تبرح جسد الشاعر الذي هو على حافة الموت ، قد كان بمقدور السياب - لو شاء - أن يجعلنا في حالة رعب وجزع من هول ما هو فيه ، بمعنى أن يشحن تلك المفردات بكل ما يثير فينا مثل تلك الأحاسيس ولكنه درك بحس الفنان الكبير أنه بصدد كتابة قصيدة ذات لهجة هادئة يشف منها التضرع و ببكاء والأسى دون أن تغرق فيه أو تعلن عنه بصراخ ولأن الشاعر كان في حالة طيبة رضى النفس غير منفعل ، جاءت لغته الشعرية ملائمة لموقفه واذ تنمو القصيدة نجد الشاعر يمعن في تطوير لغته لتكون جزءا من الحالة
ولتعبر عما يريده بدقة وتقترب الأحاسيس هنا من احساسات المتصوف ولغته
وان الجراح هدايا الحبيب
أضم الى الصدر باقاتها
هداياك في خافقي لا تغيب
هداياك مقبولة هاتها
أشد جراحي وأهتف بالعائدين
ألا فانظروا واحسدوني فهذي هدايا حبيبي
ويحاول الشاعر في المقطع الرابع من القصيدة - وقد كتبه بعد أيام من المقطع الأول أن يقف موقفا آخر فبعد أن كان يتكلم بين يدي ربه هادئا فرحا بهداي حبيبه ، نراه هنا متعطفا شاكيا متعجلا الشفاء فلقد اشتد مرضه وأوشك أن ييأس من شفائه فبدأ دعاءه بصيغة جملة الأمر التي تخرج للترجي والاستعطاف واكتسبت لغته شيئا من الحدة ، وبدأ يتسرب اليها منطق المعلل الذي يخاطب الرب بدلا من أن يستكين بجراحه في حضرته ، ويتلمس الأسباب ويقدمها الى خالقه طمعا في رحمته وحثا على فعل ينجيه من دائه يا منجيا فلك نوح مزق السدفا عني ، أعدني الى داري ، الى وطني أطفال أيوب من يرعاهم الأنا ضاعوا ضياع اليتامى في دجى شات يا رب ارجع على أيوب ما كانا جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات وزوجة تتمرى وهي تبتسم(70) لقد عاش السياب في قصيدته سفر أيوب حالات عديدة ولقد أفلح في تقديم اللغة الشعرية المناسبة لحالاته وتوشك لغة عبد الوهاب البياتي أن تكون لصيقة بموضوعاته ومواقفه ومنبثقة عنهما ولأن البياتي محتدم بالغضب دائما ثائر شديد الادانة للأنظمة المتخلفة وللحكام المتسلطين كثير الشتائم للشعراء الدجالين المنافقين أو لخدم السلطان والسائرين في ركابه فقد كانت لغته تحمل مفردات هذه المواقف الممتلئة بالغضب لسنوات عديدة من النفي والطرد والملاحقة وما ألفاظه العور الاذناب الاقزام أشباه الرجال الضفادع الخصيان التنابلة الكلاب الجيف الا جزء من الاداء الموضوعي الحاد والموقف الرافض الذي يخلق المفردة والصورة لتبلور بشكل اكيد حالة الشاعر النفسية ريشة البلبل آنات القياثر صرخت بالموت كلا هزمت ليل المقابر عرت الاشباه والخصيان من تيجانهم داست على أنف المكابر نزعت أنياب نمر الورق المحشو بالقش وأثواب المخانيث العواهر وأشباه قياصر يعلكون الخطب الجوفاء في عيد المساخر(71) الشمس والفارس فوق المدخنة ينازل اللصوص والمشوهين بالحروف المؤمنة يمد الف خنجر منها والف لفظة مبطنة لتطعنه(72)
هذه مفردات وتراكيب تسهم في صنع لغة شعرية تمثل موقف الغاضب والمحتدم بالثورة والعنف الذي لا يختار من الأساليب ما يبدو هادئا رقيقا ولا من الألفاظ ما هو ناعم أو منمق ويرى قارئ القصائد ذات الأداء القصصي أن الاهتمام بالحدث أو رسم الشخصية أو محاولة كتابة القصيدة - القصة سيترك أثره في لغة الشعر وضروري أن نقول ان هذا الأثر قد يكون ايجابيا نافعا وقد يقود الى ما ليس بنافع أو ضروري فمن الآثار السلبية على لغة القصيدة التي تطمح لأن تكون قصة ما وقع فيه السياب عند مفتتحي قصيدتيه المومس العمياء و حفار القبور ولقد مر بنا في الفصل الأول من بحثنا كيف ان الشاعر أفاض واستطرد وكتب أكثر من سبع صفحات تقوم على الوصف وملاحقة الصور الشعرية التي تعنى بأمور ليست ذات قيمة ، أمور هي على هامش الحدث القصصي فلقد وصف المدينة والليل ، والعابرين ، وتطرق الى حكاية وأساطير ودلف إلى المبغى فوصفه وصفا دقيقا ، وانتقل الى المومسات وتحدث عنهن طويلا ، وأخيرا وصل الى الحدث الأساسي وهو البطلة العمياء المومس حقا ان قدرات السياب كشاعر غنائي كبير كانت واضحة في تلك الصفحات الا أن هذا لا يعني القارئ ولا يؤثر فيه كثيرا لأنه يقدم لنا احساسات السياب الشخصية بأمور غير مهمة ، اننا نبحث عن اللغة والصورة الشعرية الملتحمتين بالحدث، وليستا الفائضتين عنه واللتين تبدوان زينة أو استطرادا غنائيا في قصيدته القصصية الثانية حفار القبور يقع بمثل ما وقع في المومس العمياء ولكن بصورة أقل لقد رأى السياب أن يكون مدخل قصيدته هو رسم
مكان الحدث ولا اعتراض لقارئ على هذا فرسم مكان الحدث ضرورة فنية ، وجزء من متطلبات القصة ، شرط ألا ينمو لهوى خاص وتداعيات شعرية وأسلوب وصفي مسترسل يقوم على الصور المتلاحقة التي ترصد رغبات الشاعر ومواقفه وأحاسيسه انها تبدو خارجية وليست من صميم القصة ضوء الأصيل يغيم ، كالحلم الكئيب على القبور واه كما ابتسم اليتامى أو كما بهتت شموع في غيهب الذكرى يهوم ظلهن على دموع والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيور كالعاصفات السود كالأشباح في بيت قديم برزت لترعب ساكنيه من غرفة ظلماء فيه وتثاءب الطلل البعيد يحدق الليل البهيم من بابه الأعمى ومن شباكه الحرب البليد والجو يملؤه النعيب فتردد الصحراء(73)ويستمر الشاعر الى أكثر من صفحة أخرى على هذه الشاكلة من الوصف والاسترسال التصويري اللغوي الذي لا يضيف شيئا الى القصة وواضح أن هذه الافاضة في الحديث هي من ميزات الشاعر غير المتمكن قصصيا أي الذي لا يستطيع أن يكون قاصا حقا ولذا تنمو اللغة وتتأنق على حساب الفن القصصي الحدث والمشكلة والأشخاص في قصيدة سعدي يوسف القصصية الأخضر بن يوسف ومشاغله نقرأ هذا تفتتح نبي يقاسمني شقتي يسكن الغرفة المستطيلة وكل صباح يشاركني قهوتي والحليب وسر الليالي الطويلة وحين يجالسني وهو يبحث عن موضع الكوب في المائدة وكانت فرنسية من زجاج ومعدن أرى حول عينيه دائرتين من الزرقة الكامدة وكانت ملابسنا في الخزانة واحدة كان يلبس يوما قميصي والبس يوما قميصه(74) ومنه يلحظ القارئ نمو أسلوب السرد وربط الجمل بأدوات العطف المتلاحقة وكل صباح وهو يبحث وكانت ملابسنا وألبس يوما و لكنه حين ولعل عناية الشاعر بالصور الشعرية تبدو قليلة لانه يحاول أن يقترب بشكل مباشر من بطله وفعله وهو بعد هذا يتوسع في الافادة من الفعل الناقص وكانت فرنسية وكانت ملابسنا وكان يلبس وكان رجال الجوزات وقد كنت الحمت وكان جواز السفر (75) لان الاهتمام بعناصر الحكاية وتطويرها قاد الشاعر الى الافادة المتوسعة من هذا الفعل وهذا الاسلوب من الاداء اللغوي الشعري وقارئ القصيدة كلها سيرى ان هناك جملا اخرى تشير الى تأثير القصة في أسلوب الشاعر كاهتمامه ببعض العبارات التي تؤدي وظيفة توضيح الفعل أو الحركة بين البطل والشاعر عبر أسوار وجدة حيث الحدود التي ماتزال معارك لكنها ويقدم لي زهرة الآس ملك لك الآن (76) أو ويدنو ليأخذ كف الفتاة أنا جالس لصقها ثم يمضي بها خارج الحجرة المعتمة (77) فهاتان الجملتان الاعتراضيتان ويقدم لي أنا جالس لصقها هما مما يتطلبه الاداء القصصي لكي يوضحا الحركات الصغيرة والافعال العابرة التي تتخلل سرد الشاعر لحدثه وحين نقرأ شعر حسب الشيخ جعفر ستبدو لنا لغة السرد أكثر وضوحا مما هي لدى سعدي يوسف لأن الشاعر منذ صدور مجموعته زيارة السيدة السومرية بدأ يكرس القصة في شعره تكريسا تاما فكان ان ألقى الموضوع القصصي بسمات الأسلوب الذي يتابع الحدث والفعل ويصف الاشياء بطريقة سردية تقوم على توالي الجمل المعطوفة على بعضها وعلى توالي الافعال التي توضح الحركة ارتدى معطفي وأغادر غرفتي البهو منطفئ والخفيرة تنصحني ان أغطي رأسي من البرد أشكرها مسرعا أتوقف عبر الحديقة أسمع خطوا بطيئا ومقتربا أتبينها في الضباب الخريفي(78) ومن يقارن بين هذا المقطع والمقطع الذي تقدم من قصيدة سعدي يوسف سيرى ان حسبا يهتم بالجمل الفعلية المتلاحقة التي تعتمد صيغة المضارعة المرتبطة بضمير المتكلم ارتدي اغادر اغطي أشكر أسمع أتوقف بينما يعمد سعدي الى الفعل الماضي كان والمضارع كان والمضارع الذي هو للغائب وواضح ان سبب هذا التباين في الاستخدام هو نوعية الحدث والبطل ففي قصيدة حسب الشيخ جعفر بل وفي أغلب قصائده القصصية يكون البطل هو الشاعر نفسه ولذا نراه يكثر من الفعل المضارع المرتبط بالمتكلم أما قصيدة سعدي فهي تتحدث عن شخص لآخر فكان أن لجأت الى المضارع للغائب و كان التي تصف حدثا ماضيا ولعل حسب الشيخ جعفر من الشعراء العراقيين القلائل الذي يتخذون من الحوار داخل بنية القصيدة القصصية وسيلة تعبير أساسية لا تنفصل عن السرد وأغلب هذا النمط من الحوار يجيء على شكل لقطات سريعة أي أنه لا ينمو ليشمل القصيدة كلها أو جزءا كبيرا منها كما حصل في المصادرة التي سنأتي على ذكرها وانما يضيء جانبا صغيرا منها ولكنه كبير الاهمية لانه يوضح فعل البطل أو جزءا من ملامح البطلة أتشرب سيدتي؟ شكرا لن أمكث غير دقائق معذرة اتي أتذكر وجهك لكن أين رأيتك قبل اليوم ؟ أتعرفني ؟ لكن خبرني ما معنى هذا ؟. فأنا أيضا أتذكر وجهك لكني ماكنت هنا من قبل ألم علي المعطف مرتجفا والا حق ظلا في الساحات تلاحقني متسولة في أسمال المبغى (79) أما القصائد القصيرة التي تعني بتقديم شخصية ضمن حدث صغير والذي هو رصد الشاعر لما حوله فغالبا ما تكون اللغة فيها سردا عماده جمل فعلية صغيرة ومتتابعة تتميز عند سامي مهدي في أسفار جديدة ويوسف الصائغ في سيدة التفاحات الاربع وسعدي يوسف في الليالي كلها بتوالي حروف العطف رجل من سامراء سيأتي سيدور هنا حينا ويدور هناك ويحدق في أوجهنا والاشياء المبثوثة حول مقاعدنا وسيختار له ركنا منعزلا ويظل يحدق فينا (80) جاءت سيدة وابتاعت أربع تفاحات ورأيناها تمضي مسرعة نحو القفر كانت تضحك تضحك والتفاحات الاربع تكبر تكبر ثم انقطع الضحك وأعقبه صوت أبيض ورأينا التفاحات الاربع تسقط فوق الارض وانقطع الصوت وساد الصمت(81) في القصائد ذات البناء الطويل التي توظيف عنصر الدراما يلمس الباحث شيئا من أثر البناء الشعري في لغة القصيدة ولأن القصيدة الدرامية هي في الأصل قصيدة مواقف متضادة متصارعة فان هذا التضاد سوف يترك بعض أثره على لغة الاشخاص أو على الاداء اللغوي لكل من الجانبين واذ نعود الى قصيدة بلند حوار عبر الأبعاد التي ينهض بعبء مهمات الحدث فيها كورسان كورس النساء وكورس الرجال سنرى أن التضاد في الموقف بين الكورسين سيؤدي الى اختلاف واضح في الأداء اللغوي، وبكلمة أدق في اللهجة اللغوية والأسلوب ان كورس الرجال في القصيدة الذي يرمز الى القيم المتخلفة التواقة الى هدر دم ا البطل سيحاول أن يحقق رغبته تلك بلغة من هذا النمط اللهم اسمعنا لا عذر لهذا الانسان سدت أذناه فلم يسمع أجراسك يا رب عميت عيناه فلم يبصرك وراء الصلبان جحدت شفتاه عطاياك لا عذر لهذا الانسان فلقد شفناه ورأينا خنجره الغائر في قلب أبيه يا رب قتل الأب أكبر من كل خطاياهم لا ترحمه فتصير الرحمة دربا للقاتل والمجرم والآبق مأوى للسارق من بيت أبيه(82) هذا نمط من الاداء اللغوي الذي يمكن أن يوصف بأنه ذو لهجة محرضة ومدمرة وتواقة الى القتل ويمكن لنا أن نصف هذا النوع من اللغة المحرضة بأنه لغة مباشرة خالية من الجماليات التي تميز شعر القصيدة لأن الصورة الشعرية توشك أن تكون معدومة في الطرف الثاني من القصيدة يوجد الموقف المضاد الذي يمثله كورس النساء رمز الحياة الجديدة أو الأمومة التي تحتضن وليدها لتدفع عنه وتنتصر لــــــــــه
الهنا يا من صيرت قيامة ذاتي كلمات عزاء في زمن الضيق ونداء محبة يوم الغضيه
ما أظلم انسانك في الفرد اذ سواك على شكله ليقايض مجدك ذاك الخالد بالوجه الفاني للانسان باسمك قالوا فليفن هذا الابن العاق هذا الراغب أن يصبح صنوك في المجد الباق ففنوا فيه وتأبد فيهم عاش الانسان نزوعا في الانسان وماتوا في حفرة ، كفيه ، وسكتة عينيه جنبه وعيدك في البغض وفي الرهبة وفي اللعنة من يرفض وعدك بالجنة يبقك في الأرض محبة(83) ومنذ اللحظة الأولى في هذا المقطع نلمس اللغة ذات اللهجة الهادئة التي تطفح بالمحبة في زمن الضيق ، وأيام الغضب والعنف ، كما أنها مليئة بالحزن الهادئ لأن كورس النساء لا يملك الا أن يبتهل للرب ويشتكي من ظلم الانسان لأخيه الانسان ، ومن يتأمل لغة كورس النساء على صعيد التشكيل الجمالي سيرى أن الشاعر يوليها العناية والاهتمام لتكون بالتالي ذات سمات خاصة تميزها عن لغة كورس الرجال فالصور الشعرية هنا نامية والجملة تستمر من خلال المجاز والرمز ، وهي عموما تتصف باقترابها من لغة التراث الديني أو الصوفي بكلمة أدق والدربان وعدك أن يبقى ووعيدك أن يفنى الاول يسقط في الخارج لتصير الاجساد معابد ان هرمت في الظل نبوءتك أمست حجرا تتستر خلف كثافته ديدان الارض وولائم ديدان والثاني كان أنت بلا معبد يا ربنا القائم في الانسان (84) واذا كان بلند الحيدري في قصيدته هذه لا يميل الى صنع الحوار لأنه يلجأ الى تقابل الأًصوات كلا على حده فان قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد المصادرة تجعل من الحوار المباشر بين البطل وجلاديه وسيلة تعبير مهمة تكشف عن ملامح الاشخاص ومواقفهم وتدفع بالحدث الى النمو والتطور فالانتهاء أطلب مرآة أبصر فيها وجهي مرفوض نحن نبصره عنك لكنكم لن تروا فيه أن نقاضيك وفقا لأعيننا نحن معذرة أنت متهم باعترافك للمرة الثانية بالتمرد لابأس أسألكم لحظة أخلع الثوب
تمنع كل ضروب التعري هنا
ولعل ما يميز لغة الحوار في قصيدة المصادرة هو اقترابها الشديد من الحوار المسرحي الموظف لخدمة الموضوع، وأعني به الحوار المركز والمكثف الذي يلتحم بالحدث ويصير جزءا منه الحوار الذي لا يستطيل لرغبات الشاعر في الاسترسال أو العناية الفائقة بملاحقة جماليات الشعر لغو وصورا على حساب المادة الموضوعية وانما هو اللغة التي تتبع من الموقف غير أن قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد ليست حوارا كلها فالشاعر يزاوج بين السرد والحوار يناوب أحدهما الآخر في محاولة مقتدرة لخلق أداء لغوي متأثر بالحدث الدرامي في قصائد شفيق الكمالي الطويلة ، وبعض قصائد يوسف الصائغ سنرى غطا آخر من تأثير البناء الطويل في لغة القصيدة وقصائد شفيق الكمالي تتصف بأنها ذات حدث أساسي أو محور رئيسي تتجمع حوله مجموعة من الأحداث والمواقف تضيف اليه وتكشفه وتطوره ، غير ان اهتمام الشاعر بالفكرة الأولى والحدث الرئيسي غالبا ما أدى الى وقوع اللغة في التكرار لأننا نرى أن القضية التي يحاول الشاعر طرحها ستمر علينا من خلال جمل لا تختلف عن بعضها في المعاني ولكنها ذات أداء لغوي مختلف ومتكرر يا زمان النوى هل تعود الأماسي ؟ عزاء بني عمنا أن رحلنا (85) بكى نخل بغداد من لوعة الهجر ذبنا أسى غير أن الديار لظى والمزار بعيد وما بين بصرى وذي قار ناست قوافلنا المتعبات احترقنا (86) تقدم لنا الابيات الاولى فكرة ضياع الزمن الجميل الذي كان يجمع الاخوة أما الابيات الاخرى فتعتبر امتدادا للمعنى المتقدم لأن زمان النوى يعني لوعة الهجر و الاسى و المزار البعيد هو معنى عزاء ان رحلنا ان هذا التكرار في المعاني بلغة مختلفة كان بسبب ذلك المحور الرئيسي للحدث في قصيدة الكمالي الطويلة هذه والفكرة الاساسية هي الفرقة بين الاخوة وما ينبثق عنها من عواطف تتوق الى التئام الشمل ومواقف قد تصل الى حد القطيعة يا معشر القوم تهنا فلا بارق من أراضي الحجاز يلوح ولا نجمة الصبح تبدو نما الشوك بين الجفون (87) وليست هذه المعاني الا تكرارا لما تقدم والا اعادة لها بلغة مختلفة اذ ما الفرق الكبير في المعاني أو الحالات بين ناست قوافلنا المتعبات احترقنا وتثب الحصى تحت اقدامنا وبين تهنا نما الشوك بين الجفون و يا دمشق التي هدنا بعدها مثل هذا التكرار في المعاني الذي نتج عن الاهتمام والتركيز الشديد على الفكرة الاساسية في القصيدة ما نراه في قصيدة يوسف الصائغ الطويلة أيضا اعترافات مالك بن الريب ونقرأ فيها منذ البدء تشيح العواصم حين تمر وأترك وحدي(88) هذه هي الفكرة الأساسية غربة البطل ووحدته في عصر قاس وسيتابعها الشاعر صفحة بعد صفحة مغتربا غربة يوسف في الحب(89) يوحش كالذئب وجهي وأفرد مغتربا بين أهلي(90) عندي قمر مدفون يرافقني في المنافي ان عبارت كـ أترك وحدي غربة يوسف أفرد مغتربا في المنافي تبدو من ناحية المعاني واحدة لأنها تقدم موقفا واحدا هو احساس الشاعر بغربته ووحدته بين أهله وزمنه ومما ينتمي الى هذه الفكرة أيضا قوله أنا مسلم للعراء (91) تحتويني الرمال النظيفة تحت سماء الصحاري (92) الموت وسادة حبي(93) وتنتهي القصيدة بهذه الابيات التي تؤكد المعاني المتكررة انني وطن المتعبين الذين يحسون وحشة هذا الزمان (94) وما كان هذا التكرار للمعاني الا بسبب حرص الشاعر على تأكيد المعنى الذي بدا له أكثر أهمية من غيره أو الموقف الذي أراد له أن يكون محور القصيدة وقاد البناء الطويل لها الى مثل هذا التكرار بحيث بدت القصيدة في جزء كبير منها وكأنها استطرادات لغوية لمعنى واحد متكرر.
_____________
1 - بدر شاكر السياب 30 وينظر أيضا الشعر المصري بعد شوقي ، الثانية 4 ولغة الشعر الحديث ، د السعيد الورقي 60 د محمد مندور الحلقة
(2) ينظر حركات التجديد في الأدب العربي 175 - 176
(3) ديوان البياتي 1/ 145 وينظر ديوان السياب 1/39، 40 وقصائده و رئة تتمزق سوف أمضي هوى واحد لن نفترق سراب في ليالي الخريف
(4) ينظر لغة الشعر العربي الحديث ، الدكتور السعيد الورق 59 وما بعدها (5)مقدمة عبد الجبار عباس لمجموعة بلند الحيدري ، خفقة الطين ، ص 7
(6) ينظر حياتي في الشعر 90
(7) دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده د محمد غنيمي هلال دار نهضة
مصر للطباعة ، القاهرة ص 85
(8) الكاتب وعالمه ، تشارلس مورجان ، ترجمة الدكتور شكري محمد عياد ، القاهرة 1974 ص 79
9) ينظر النظرية الرومانتيكية في الشعر ، كولردج ، ترجمة د عبد الحكيم حسان ،
دار المعارف بمصر 1971 ، ص 270 - وينظر المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الأديب وصناعته ، 10 ، من الوجهة النفسية في دراسة الادب ونقده ، محمد خلف الله أحمد ، الطبعة الثانية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة 1970 ص 79 وما بعدها ، ثلاثة قرون من الأدب الأمريكي 103/1
(10) عزرا باوند وحركة الشعر الصوري، خلدون الشمعة ، مجلة المعرفة ، عدد 13 لسنة
1972 ، ص 232
(11) اليوت ، فائق متى ، دار المعارف بمصر 1966 ، ص 130 وينظر ايضا اليوت الناقد الشاعر ، ماتيسن 54 ومقال اليوت ) موسيقى الشعر : الذي ترجمة الدكتور محمد النويهي في كتابه « قضية الشعر الجديد ، ص 19 ينظر التجربة الخلاقة ، س ، بورا 215 وينظر أيضا الدراما في القرن العشرين ، بامبر جاسكوين ، ترجمة محمد فتحي ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، ص 67
(12) قضية الشعر الجديد 22
(13) نفسه ، 21
14)الشعر والتجربة، 20
(15)ينظر الرؤيا الابداعية هاسكل بلوك وهيرمان سالنجر ترجمة اسعد عبد الحليم مكتبة نهضة مصر القاهرة 1966 ، ص 27
(16) أنشودة المطر، 14 - 15
(17) أنشودة المطر 171
18- أغاني المدينة الميتة 16
19- خفقة الطين 100
20- نفسه 108
21- وينظر ديوان شاذل طاقة 274 وخيمة على مشارف الاربعين 25 ، 127 والخيمة الثانية 28، 99
(22) طراز خاص 11 - 20
(23) أنشودة المطر ، 206
(24) والعبارة تنطقها النسوة بهذا الشكل فدوة لعيونك أو فدوة العينك
(25) الخيمة الثانية 189 ، وينظر أيضا 17
(26) الدرس حركة تصاحب الاهزوجة وهي تنسجم ايقاعيا مع الكلمات ويتصف بانه طريقة خاصة لضرب الأرض بالأرجل وغالبا ما يستخدم فيه كعب القدم متجاوبة مع حركة اليدين أيضا و لولت المرأة هددت ترنمت لوليدها وهو في المهد لينام و هزت واضحة ولكنها بالأداء الشعبي تتحول الى : هزيت
(27) ديوان البياتي 2/ 201
(28) ديوان البياتي 1/549 وينظر أيضا 1/ 678 ، 679 0 2 / 375 ، و3/311 392 ، 302 وتنظر الخيمة الثانية 56 وأوراق التوت 50 ، 52
29- ديوان عبد الوهاب البياتي 1/ 179
30- نفسه 1/344
31- نفسه 1/446، 447 وينظر أيضا 1/275 و477 و3/56و3/415
32- نفسه 3/56
(33) ديوان نازك الملائكة 2/ 453، 454ومن أغاني الحرية 157 ، 160 ، 161 / 17 ، 16 ، 138 وينظر على سبيل المثال المجموعات الشعرية التالية رحيل الامطار لشفيق الكمالي 93 وديوان شاذل طاقة 243 ، 308 ، 420 والحب والحرية لمحمد جميل شلش 26 ، 85 وخطوات في الغربة لبلند الحيدري 135 ، 138 ، 150 ، والنجم الرماد لسعدي يوسف القصائد اعتداء ، بعض محرري الصحف وطني و الربان الألفريد سمعان 8، 11، 14، 16، 18، 19، 32، 73
(34) التطور في الفنون ، توماس مونرو ترجمة محمد علي ابو درة وآخرين ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1971 ، ص 1/241
35- مجلة المثقف أيلول 1962 ص 59
36- شجر الغابة الحجري 110
36- نقلا عن الشعر الحر في العراق 350
37- النشيد 25
38- نفسه 71
39- النشيد 81
(40) مقالات في النقد الأدبي ، 6
(41) الشعر الحر في العراق ، 320
(42) نفسه ، 322
(43) نفسه
(44) درس يوسف الصائغ حركة الشعر الحر في العراق منذ النشأة حتى عام 1958
(45) ضروري هنا أن نشير الى ما قاله محمود العبطة عن السياب :كان يعود الى ديوان المتنبي أو أبي تمام أو البحتري، وغيرهم من فحول الشعراء ولكنه كان مشغوفا بدرجة لا توصف بأبي تمام ، يحفظ مطولاته ويحلل صوره ويعيش أجواءه ينظر لهذا : بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة في العراق مطبعة المعارف بغداد 1965 ص 9
(46) الشعر الحر في العراق، 330.
(47) (48) أنشودة المطر ، 13 43 ، 50 ، 54، 764، 97، 99، 104 141 174 177 181 187 188 190 210 212 216 219 221 224 226 235 237 241 259 263 والمعبد الغريق 41 ، 61 ، 63 ، 237، 241، 259 ،263 والمعبد الغريق 410، 61 ،63، 64، 77 ، 78، 93 ، 94، 97 ، 98 ، 103 ، 105 ومنزل الاقنان 47، 50 ، 59، 60 ، 80 ، 85، 101 131
(49) أنشودة المطر 64 - 65
(50) المجموعة الشعرية الكاملة لشاذل طاقة، 36
(51) نفسه ، 382
(51) نفسه، 300
(52) المجموعة الشعرية الكاملة لشاذل طاقة ، 100
(53) خيمة على مشارف الأربعين قصيدة الصور
(54) المجموعة الشعرية لشاذل طاقة ، الصفحات على التوالي 71، 81 ، 256 ، 344 ، 58
(55) تنظر على سبيل المثال مجموعته : موتى على لائحة الانتظار : 9 ، 10 ، 12 ، 14 ،15 ، 18 ، 24، 25، 27، 30، 42، 71
(56) المجموعة الكاملة لشاذل طاقة ، 32
(57) طعام المقصلة، علي الحلي، دار الكرنك ، القاهرة 1962 ص 27
(58) القصيدة : رياح بني مازن ( من ) اعترافات مالك بن الريب ص 4 ، وينظر أيضا أغلب شعر شفيق الكمالي في تنهدات الأمير العربي و هموم مروان وحبيبته الفارعة )
(59) يقول بلند الحيدري أنه شعر بنفور من التراث وتحدله هذا في مراحله الشعرية الأولى - وكنت الاحق اللغة العربية من خلال الأدب المترجم ؟! ويوم كتب الأستاذ مارون عبودي عن شعري أخذ علي أكثر من خطأ في مجموعتي. ولقد نبهني مقاله إلى ضرورة الاحتراز من الخطأ وهو أقل ما أردته من اللغة آنذاك ينظر مقابلة مع بلند الحيدري منشورة في مجلة الأديب المعاصر ، المجلد الثاني ، العدد الخامس بغداد 1973
60- نفسه
61- حوار عبر الابعاد 17 وواضح أن بلند في قصيدته هذه يزاوج بين الشعر والنثر وهذا المقطع نثري
62- حوار عبر الابعاد 18
63) الشجرة الشرقية 13
64)نفسه ، 15
65) نفسه ، 24
66) نفسه ، 39
67) نفسه ، 45
(68) منزل الاقنان 36 وتنظر قصائد أخرى للشاعر المقطع الأول من قصيدته المسيح بعد الصلب والمقطع الثاني من قصيدته في المغرب العربي وقصيدته مدينة بلا مطر وكل هذا في مجموعته أنشودة المطر
(69) منزل الاقنان، 37
(70) منزل الأقنان 50- 51
71- ديوان البياتي 1/651-652
(72) ديوان البياتي 1/655وينظر أيضا 1/636وما بعدها و 1/ 668 و 690 ، 691 ،694، 696
(73) انشودة المطر مطلع قصيدة حفار القبور
74- الاخضر بن يوسف ومشاغله 13- 14
75- نفسه 22
76- 15
77- نفسه 117
78- عبر الحائط في المرآة 17 وينظر الشجرة الشرقية 6، 7، 15، 17، 30، 31، 33
79- نفسه 11 وينظر 12، 18، 19، 20، 23، 24، 38، 39، 54، 55، 59 ، 60، 63، 65، 104، 105، 109
80- أسفار جديدة سامي مهدي دار الحرية للطباعة بغداد 1976 ص28 68
81- سيدة التفاحات الاربع مطبعة الاديب البغدادية 1976 ص13 وينظر الليالي كلها 39، 40، 63، 68 وتحت جدارية فائق حسن 95، 98
(82) حوار عبر الأبعاد 63 ، وينظر 22 31 ، 42، 65، 66
(83) حوار عبر الأبعاد، 55 وما بعدها
84- نفسه 58
(85) تنهدات الأمير العربي ، 104
86- نفسه 106
87- تنهدات الامير العربي 109 وينظر 114، 115
88- اعترافات مالك بن الريب 5
89- نفسه 7
90- نفسه 9
91- نفسه 14
92- نفسه 17
93- نفسه 23 وينظر 25
94- اعترافات مالك بن الريب 26
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
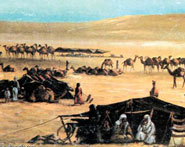 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|