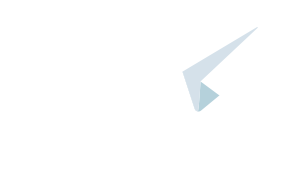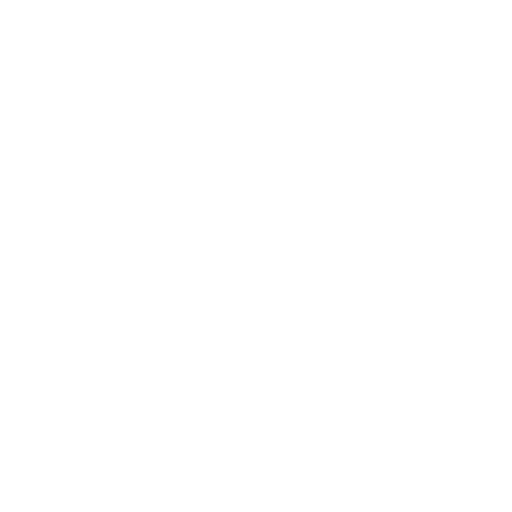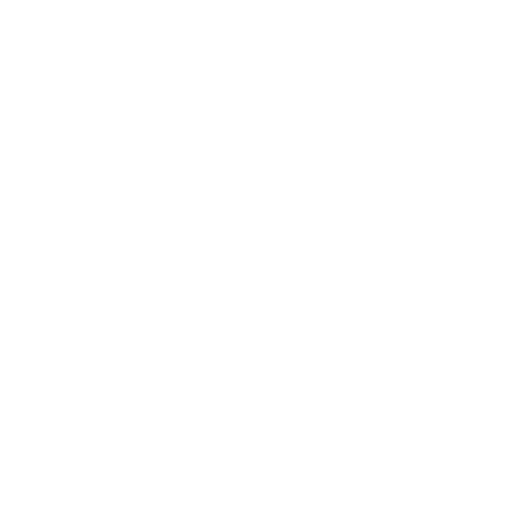النحو

اقسام الكلام

الكلام وما يتالف منه

الجمل وانواعها

اقسام الفعل وعلاماته

المعرب والمبني

أنواع الإعراب

علامات الاسم

الأسماء الستة

النكرة والمعرفة

الأفعال الخمسة

المثنى

جمع المذكر السالم

جمع المؤنث السالم

العلم

الضمائر

اسم الإشارة

الاسم الموصول

المعرف بـ (ال)

المبتدا والخبر

كان وأخواتها

المشبهات بـ(ليس)

كاد واخواتها (أفعال المقاربة)

إن وأخواتها

لا النافية للجنس

ظن وأخواتها

الافعال الناصبة لثلاثة مفاعيل

الأفعال الناصبة لمفعولين

الفاعل

نائب الفاعل

تعدي الفعل ولزومه

العامل والمعمول واشتغالهما

التنازع والاشتغال

المفعول المطلق

المفعول فيه

المفعول لأجله

المفعول به

المفعول معه

الاستثناء

الحال

التمييز

الحروف وأنواعها

الإضافة

المصدر وانواعه

اسم الفاعل

اسم المفعول

صيغة المبالغة

الصفة المشبهة بالفعل

اسم التفضيل

التعجب

أفعال المدح والذم

النعت (الصفة)

التوكيد

العطف

البدل

النداء

الاستفهام

الاستغاثة

الندبة

الترخيم

الاختصاص

الإغراء والتحذير

أسماء الأفعال وأسماء الأصوات

نون التوكيد

الممنوع من الصرف

الفعل المضارع وأحواله

القسم

أدوات الجزم

العدد

الحكاية

الشرط وجوابه


الصرف

موضوع علم الصرف وميدانه

تعريف علم الصرف

بين الصرف والنحو

فائدة علم الصرف

الميزان الصرفي

الفعل المجرد وأبوابه

الفعل المزيد وأبوابه

أحرف الزيادة ومعانيها (معاني صيغ الزيادة)

اسناد الفعل الى الضمائر

توكيد الفعل

تصريف الاسماء

الفعل المبني للمجهول

المقصور والممدود والمنقوص

جمع التكسير

المصادر وابنيتها

اسم الفاعل

صيغة المبالغة

اسم المفعول

الصفة المشبهة

اسم التفضيل

اسما الزمان والمكان

اسم المرة

اسم الآلة

اسم الهيئة

المصدر الميمي

النسب

التصغير

الابدال

الاعلال

الفعل الصحيح والمعتل

الفعل الجامد والمتصرف

الإمالة

الوقف

الادغام

القلب المكاني

الحذف


المدارس النحوية

النحو ونشأته

دوافع نشأة النحو العربي

اراء حول النحو العربي واصالته

النحو العربي و واضعه

أوائل النحويين


المدرسة البصرية

بيئة البصرة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في البصرة وطابعه

أهم نحاة المدرسة البصرية


جهود علماء المدرسة البصرية

كتاب سيبويه

جهود الخليل بن احمد الفراهيدي

كتاب المقتضب - للمبرد


المدرسة الكوفية

بيئة الكوفة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الكوفة وطابعه

أهم نحاة المدرسة الكوفية


جهود علماء المدرسة الكوفية

جهود الكسائي

الفراء وكتاب (معاني القرآن)


الخلاف بين البصريين والكوفيين

الخلاف اسبابه ونتائجه

الخلاف في المصطلح

الخلاف في المنهج

الخلاف في المسائل النحوية


المدرسة البغدادية

بيئة بغداد ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في بغداد وطابعه

أهم نحاة المدرسة البغدادية


جهود علماء المدرسة البغدادية

المفصل للزمخشري

شرح الرضي على الكافية

جهود الزجاجي

جهود السيرافي

جهود ابن جني

جهود ابو البركات ابن الانباري


المدرسة المصرية

بيئة مصر ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو المصري وطابعه

أهم نحاة المدرسة المصرية


جهود علماء المدرسة المصرية

كتاب شرح الاشموني على الفية ابن مالك

جهود ابن هشام الانصاري

جهود السيوطي

شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك


المدرسة الاندلسية

بيئة الاندلس ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الاندلس وطابعه

أهم نحاة المدرسة الاندلسية


جهود علماء المدرسة الاندلسية

كتاب الرد على النحاة

جهود ابن مالك


اللغة العربية

لمحة عامة عن اللغة العربية

العربية الشمالية (العربية البائدة والعربية الباقية)

العربية الجنوبية (العربية اليمنية)

اللغة المشتركة (الفصحى)


فقه اللغة

مصطلح فقه اللغة ومفهومه

اهداف فقه اللغة وموضوعاته

بين فقه اللغة وعلم اللغة


جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

جهود القدامى

جهود المحدثين


اللغة ونظريات نشأتها

حول اللغة ونظريات نشأتها

نظرية التوقيف والإلهام

نظرية التواضع والاصطلاح

نظرية التوفيق بين التوقيف والاصطلاح

نظرية محاكات أصوات الطبيعة

نظرية الغريزة والانفعال

نظرية محاكات الاصوات معانيها

نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية


نظريات تقسيم اللغات

تقسيم ماكس مولر

تقسيم شليجل


فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

لمحة تاريخية عن اللغات الجزرية

موطن الساميين الاول

خصائص اللغات الجزرية المشتركة

اوجه الاختلاف في اللغات الجزرية


تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

اللغات الشرقية

اللغات الغربية


اللهجات العربية

معنى اللهجة

اهمية دراسة اللهجات العربية

أشهر اللهجات العربية وخصائصها

كيف تتكون اللهجات

اللهجات الشاذة والقابها


خصائص اللغة العربية

الترادف

الاشتراك اللفظي

التضاد


الاشتقاق

مقدمة حول الاشتقاق

الاشتقاق الصغير

الاشتقاق الكبير

الاشتقاق الاكبر

اشتقاق الكبار - النحت

التعرب - الدخيل

الإعراب

مناسبة الحروف لمعانيها

صيغ اوزان العربية


الخط العربي

الخط العربي وأصله، اعجامه

الكتابة قبل الاسلام

الكتابة بعد الاسلام

عيوب الخط العربي ومحاولات اصلاحه


أصوات اللغة العربية

الأصوات اللغوية

جهود العرب القدامى في علم الصوت

اعضاء الجهاز النطقي

مخارج الاصوات العربية

صفات الاصوات العربية


المعاجم العربية


علم اللغة

مدخل إلى علم اللغة

ماهية علم اللغة

الجهود اللغوية عند العرب

الجهود اللغوية عند غير العرب


مناهج البحث في اللغة

المنهج الوصفي

المنهج التوليدي

المنهج النحوي

المنهج الصرفي

منهج الدلالة

منهج الدراسات الانسانية

منهج التشكيل الصوتي


علم اللغة والعلوم الأخرى

علم اللغة وعلم النفس

علم اللغة وعلم الاجتماع

علم اللغة والانثروبولوجيا

علم اللغة و الجغرافية


مستويات علم اللغة

المستوى الصوتي

المستوى الصرفي

المستوى الدلالي

المستوى النحوي

وظيفة اللغة

اللغة والكتابة

اللغة والكلام


تكون اللغات الانسانية

اللغة واللغات

اللهجات

اللغات المشتركة

القرابة اللغوية

احتكاك اللغات

قضايا لغوية أخرى


علم الدلالة

ماهية علم الدلالة وتعريفه

نشأة علم الدلالة

مفهوم الدلالة


جهود القدامى في الدراسات الدلالية

جهود الجاحظ

جهود الجرجاني

جهود الآمدي

جهود اخرى

جهود ابن جني

مقدمة حول جهود العرب


التطور الدلالي

ماهية التطور الدلالي

اسباب التطور الدلالي

تخصيص الدلالة

تعميم الدلالة

انتقال الدلالة

رقي الدلالة

انحطاط الدلالة

اسباب التغير الدلالي

التحول نحو المعاني المتضادة

الدال و المدلول

الدلالة والمجاز

تحليل المعنى


المشكلات الدلالية

ماهية المشكلات الدلالية

التضاد

المشترك اللفظي

غموض المعنى

تغير المعنى

قضايا دلالية اخرى


نظريات علم الدلالة الحديثة

نظرية السياق

نظرية الحقول الدلالية

النظرية التصورية

النظرية التحليلية

نظريات اخرى

النظرية الاشارية

مقدمة حول النظريات الدلالية

موضوعات أخرى
أحرف النصب
المؤلف:
حسن عباس
المصدر:
حروف المعاني بين الأصالة والحداثة
الجزء والصفحة:
ص:83-89
18-4-2020
3003
أحرف النصب
هي: ((أن-لن - إذن -كي)) تنصب الفعل المضارع
1-أنْ
أولاً- حول خصائص حرفيها ومعانيهما الفطرية:
1-(الهمزة)- يوحي صوتها الانفجاري في أول المصادر بالظهور والحضور والبروز.
2-(النون)- من معانيها البطون والصميمية كما أسلفنا في دراستها.
ومحصلة معاني حرفيها تشير إلى حضور ذات المتكلم وظهوره. وهي بذلك تكون أكثر توافقاً مع استعمالها ضميراً منفصلاً للمتكلم والمخاطب، من استعمالها أداة لنصب الفعل المضارع، كما سيأتي.
ثانياً- حول معانيها واستعمالاتها التراثية:
(أَنْ) المفتوحة (الهمزة) والساكنة(النون)، هي على وجهين: اسم وحرف.
آ-(أنْ) الاسم: هي على رأي بعضهم ضمير منفصل للمتكلم، كقولنا: ((أن فعلت))، أي (أنا) فعلت، وللمخاطب (أنت- انتما..) بتقدير: الضمير هو (أنْ)، و(التاء) حرف خطاب.
وأما البعض الآخر فيرى ان الضمائر في (أنا) للمتكلم، و(أنت- أنتما) للمخاطب، هي كل الحروف.
وهذا الوجه من استعمال (أنْ) ضميراً منفصلاً يتوافق أصلاً مع الخصائص الفطرية لصوتي حرفيها في (البطون والظهور)، كما رأينا آنفاً. فماذا عن استعمالاتها التراثية.
ب-(أنْ) الحرف: وتقع على أربعة أوجه:
1-أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع.
2-أن تكون مخففة عن (أنَّ) الثقيلة.
3-أن تكون مفسِّرة بمنزلة (أي).
4-أن تكون زائدة.
ولما كان حديثنا هنا مقتصراً على نواصب المضارع، نكتفي بالحديث عن (أنْ) المصدرية.
(أنْ) حرف مصدري:
تدخل على الأفعال المتصرِّفة، للماضي، نحو: ((سافرتُ بعد (أنْ) غربت الشمس)). أو للمضارع، نحو: ((سآتيكَ بعد (أنْ) تغربَ الشمس)). أو للأمر: ((كتبت إليه بأن قُمْ)).
وهي في ذلك. مؤوّلة مع ما بعدها بالمصدر في الحالات الخمس التالية:
1-أن يكون المصدر مبتدأ، نحو: ((أنْ تدرسَ خيرٌ لك)). بتأويل (الدرسُ خيرٌ لك)).
2-أن يكون المصدر مبتدأ، نحو: ((يسرني أنْ تنجحَ)) بتأويل: ((يسرني نجاحُك)).
3-أن يكون مفعولاً به، نحو: ((أريد أن أسافر)): بتأويل: (أريد السفرَ)).
4-أن يكون مجروراً بالاضافة، نحو: ((سآتيك بعد أن تغربَ الشمس)) بتأويل: ((بعد غروبِ الشمس)).
5-أن يكون مجروراً بالحرف، نحو: ((كتبت له بأن يقومَ)). بتأويل: ((كتبت له بالقيامِ))
إذا دخلت (أن) على المضارع نصبته، أما إذا دخلت على غيره فلا عمل لها.
ولكن ما تعليل نصبها للمضارع؟
عندما تكون (أنْ) وما بعدها مؤولة بمصدر على أنَّه: ((مفعول به، أو مجرور بالإضافة أو بالحرف))، كما لاحظنا في الحالات الثلاث الأخيرة الآنفة الذكر فإنه لا صعوبة في تعليل نصبها للمضارع.
1-ففي حال تأويل (أن) وما بعدها مفعولاً به، تنتقل (الفتحة) من المصدر المؤوّل، إلى الفعل المضارع موضوع التأويل، فالفتحة مختصة بالاستكانة، سواء أَفي الأسماء أو الأفعال كما مر معنا في دراسة حركات الشكل. (الحرف العربي والشخصية العربية ص128-131).
2-وعندما يأخذ المصدر موقع المجرور بالإضافة أو بالحرف، فالأمر يختلف قليلاً. فلما كانت الأفعال لا تقبل الكسرة المختصة باستكانة الأسماء واستقرارها، فقد استعاض العربي عنها للفعل المضارع بالفتحة المختصة أصلاً باستكانة الأفعال واستقرارها.
وهكذا لم يكن للعربي مفرّ من تحريك الفعل المضارع بالفتحة في هذه الحالات الثلاثة.
ولكن ما هو تعليل نصب (أنْ) للمضارع في حال تأويلها وما بعدها بالمبتدأ أو الخبر؟. فنقول:
1-في مثال المبتدأ: ((أن تدرس خيرٌ لك)). فالدرس هنا يقع عليه حكم التخصيص أو التمني أو الترجي أو التهديد، حسب سياق الكلام، مما يُخلّ بفعالية مضارعه وحريته. فاستحق هذا الفعل (تدرسَ) حركة الفتحة الضعيفة، وليس الضمة القوية ولا السكون الأقوى.
2-وفي مثال الفاعل: ((سرني أن تنجحَ)). فالنجاح هنا قد وقع عليه حكم (السرور)، ففقد مضارعه (تنجحَ) بذلك حريته وفعّاليته- لالتزامه بأمر معين هو (سروري) فاستحق حركة الفتح الضعيفة للاستكانة.
وهنا قد يطرح القارئ هذا التساؤل:
هل كان العربي حقاً على هذا المستوى الرفيع من رهافة الحس والنفس والمشاعر؟
فأجيب: أن نعم. فللشعراء الأصلاء عباقرة الكلمة وأساتذة القواعد الصرفية النحوية في ذلك الباع الطولي، فطرة سوية.
2-لَنْ
أولاً- حول خصائص حرفيها ومعانيهما الفطرية:
1-(اللام)- للإلصاق والجمع والإلزام.
2-(النون)- من معانيها في نهاية المصادر: الرقة والخفاء والاستقرار.
فإذا صح أن خاصية النفي الشديد في (لم) الجازمة تعود إلى توافق خصائص حرفي (اللام والميم) في الإلصاق والجمع والضم، فإن (لن) لابد أن تكون أقل شدة في النفي منها. وذلك للفارق الكبير بين خصائص كل من (النون والميم) في نهاية المصادر، جمعاً وضماً في (الميم) ورقة وخفاء- في (النون). وتأسيساً على هذا الفارق في خصائصهما فإنه لا يجوز تعليق منفي (لم) على شرط مثلما يجوز ذلك مع (لن). كما أسلفنا.
ثانياً- حول معانيها واستعمالاتها التراثية:
هي حرف نصب ونفي واستقبال.
ولقد حاول بعض اللغويين تعليل خاصية النفي في معاني (لَن). فقال (الفرّاء)، بأن (لا) النافية هي أصل كل من (لن-ولم). فأُبدلت الألف نوناً في (لن)، وميماً في (لم). واستبعد (ابن هشام) ذلك، لأن الأصل هو إبدال (النون) ألفاً، كما في قوله تعالى: ((لنسفعاً بالناصية) بدلاً من ((لنسفعن).
أما العكس فلا:
كما قال (الخليل والكسائي) بأن (لن) أصلها (لا أن)، فحذفت الهمزة تخفيفاً والألف للساكنين. واستبعد (ابن هشام) هذا الرأي أيضاً. ومآل ذلك أن (لن) لديه هي أصل ذاتها ولكن إذا كانت (لن) بخاصة هي أصل ذاتها، فمن أين أتتها وظيفة النفي؟. فاللام (للإلصاق والنون (للرقة والخفاء والاستكانة). يبدو لي أن (الفراء) قال الحقيقة فيما يتعلق بـ(لن) فبين (ألف) التنوين والنون علاقة قربى عريقة متبادلة. ف(إذاً) هي أصل (إذن) كما سيأتي. ولا يؤبه لِما قاله (ابن هشام) بأن الأصل (قلب النون ألفا، وليس العكس).
أما محاولة (الفراء) بصدد إعادة (لم) الى أصلها المزعوم في (لا)، فذلك يعود إلى عدم انتباهه الى الخصائص الإيمائية في (الميم) للجمع والضم، مما ينفي كل قربى بينها وبين الألف.
ومما ذكره (ابن هشام) بمعرض إثبات ضعف النفي بـ(لن)، أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأييده. وكذلك جواز تعليق منفيها على شرط، نحو: (لن آتيك إلا إذا دعوتني). ولا يقال ذلك مع (لم) كما أسلفنا.
وعلة نصبها للمضارع تعود إلى أن فعاليته قد توقفت بنفي وقوعه، فكانت الفتحة أولى به من الضمة للفعالية. ولما كان نفي المضارع بـ(لن) أقل شدة من نفيه بـ(لم) فلم يستحق السكون.
وهكذا اقتضى الذوق العربي الفطري أن ينصب المضارع الذي تدخل عليه أنْ بالفتحة حصراً.
3- إذَنْ
لم نجد رابطة واضحة بين معناها التراثي باعتبارها ((حرف جواب))، وبين خصائص أحرفها: (الهمزة والذال والنون). فهل ستنفعنا معانيها التراثية واستعمالاتها في الكشف عن معانيها الفطرية.
أولاً- حول معانيها واستعمالاتها التراثية:
هي حرف جواب تنصب المضارع بشروط ثلاثة:
1-أن تتصدر الإجابة.
2-أن يليها المضارع الذي معناه الاستقبال.
3-ألاّ يفصل بين (إذن) وبين المضارع فاصل، إلا أن يكون الفاصل ((ظرفاً، أو مجروراً أو قَسَماً، أو حرف (لا)، أو منادى))، كما في الأجوبة التالية.
قال لك: سأزورك، فتجيبه: ((إذن أُكرمَك- إذن غداً أُكرمَك- إذن والله أكرمَك اذن لا أخيّبَ ظنّك- إذن يا عبد الله أُكرمَك)).
فهي تنصب المضارع عندما تتوافر لها هذه الشروط الثلاثة، ولكن عند وجود الفاصل، فالأكثر إهمالها.
وفي حال الوقت يحكمها مذهبان: إما أن تكتب (إذاً) بقلب (النون) ألفاً، وإما أن تكتب (إذن) بتثبيت (النون).
وأكثر استعمالاتها تقع جواباً لـ(إنْ) أو (لو)، كقول الشاعر:
|
وأمكنني منها (إذنْ) لا أُقيلَها)). |
|
((لئن عادني عبدُ العزيزِ بمثلها |
وقول الحماسي:
|
بنو اللقيطة من ذهل بنِ شَيبانا)) |
|
((لو كنتُ من مازن لم تَستْبحْ إبلي |
|
عند الحفيظة إنْ ذو لوثةٍ لانا)) |
|
((إذاً لقامَ بنْصري معشرٌ خشنٌ |
ثانياً- عودة إلى أصل تركيبها:
يشترط في (إذن)، أو (إذاً) كيما تنصب المضارع أن تتصدر الإجابة إطلاقاً. ولمّا كانت الإجابات التي تلي (إذن) لا يمكن توقعها، فهي تنطوي على عنصر المفاجأة لابد أن تكون مستمدة من خصائص (إذن) ذات الصدارة.
ولأخذ فكرة عن مسألة المفاجأة في (إِذن) يمكن مقارنتها بأي من حرفي الاستفهام (الهمزة وهل). فعندما نسأل مثلاً: ((أجاء زيد))، أو: ((هل نجح زيد))، فإن الإِجابة بـ (نعم) أو (كلاّ) متوقعة، لا تنطوي على عنصر المفاجأة. وذلك على العكس مما لو قال أحدهم: (سأزورك) فإن أي إجابة بعد (إذن) لا يمكن توقعها.
وهكذا من المرجح أن يكون أصل (إِذن) الناصبة: (إذْ) الفجائية، نحو: ((بينما أنا جالس( إذْ) أقبل زيد)). كما إِنّ (إذْ) الفجائية هذه، هي أيضاً (إذا) الفجائية نحو: ((خرجت، فإذا زيد واقف)).
ثم لحق (إذْ) الفجائية التنوين لفظاً فصارت (إذاً)، أو كتابة فصارت (إذنْ) وذلك تمييزاً لها عن (إذْ) الفجائية من جهة، وتمكينا للإجابة في ذهن السامع وإعطائها المزيد من الاهتمام.
فمن معاني (نون التنوين)، التمكين، ويسمى (تنوين التمكين)، كما سيأتي في (بحث (إنّ) وأخواتها.
ثالثاً- فماذا عن خصائص حرفي (إذْ) الفجائية ومعانيها الفطرية؟ وما تعليل نصب (إِذن) للمضارع؟
1-(الهمزة)- في أوائل المصادر هي للظهور والبروز والحضور أصلاً، ولكنها بصوتها الانفجاري تتضمن معاني التنبيه والمفاجأة كأي انفجار صوتي في الطبيعة.
2-(الذال)- ذات الصوت المهتز المضطرب، كان من معانيها المعجمية (الاهتزاز والاضطراب وشدة التحرك والقطع)، بما يتوافق مع صدى صوتها في النفس. وصوتها المهتز المضطرب من شأنه أن يثير أيضاً انتباه السامع، كأي صوت مهتز في الطبيعة، مما يدعم وظيفة (الهمزة) في المفاجأة.
وهكذا فإن محصلة الخصائص الفطرية لهذين الحرفين تتوافق مع حالات المفاجآت الصوتية في الطبيعة فنقلها العربي إلى حالات المفاجآت المعنوية في لغته..
وسنرى أن لحرف (الذال) وظيفة عريقة في إثارة انتباه السامع بمعرض حديثنا المقبل عن أسماء الإشارة (ذا- ذاك- هذا..)، كما سنرى أن العربي قد أفاد من خاصية الاهتزاز- والاضطراب في صوت (الهاء)، فاستعملها لإثارة انتباه السامع في بعض أسماء الإشارة (هذا- هؤلاء) وأسماء الأصوات وغيرهما. وهذا يعزز قولنا بأن الإجابة بـ (إذن) تتضمن معنى المفاجأة والتمكين. وبذلك تتوافق معانيها واستعمالاتها التراثية مع الخصائص الفطرية لأصوات- أحرفها.
وهكذا، فإن المضارع الذي يليها مباشرة يقع عليه حكم الجواب المفاجئ، فاستحق النصب لأنه غير متحرر من أحكام ما قبله.
وذلك على العكس مما لو كان بين (إذن) وبين المضارع موضوع الجواب أحد الفواصل المذكورة آنفاً، فإن حكم الجواب يتراخى عنه، فيخف وقع المفاجأة عليه. عندئذ يكون العربي حراً في نصب المضارع أو رفعه حسب مقتضى الحال، ولاسيما في الشعر الأصيل.
4- كَيْ
أولاً- حول خصائص حرفيها ومعانيهما الفطرية:
1-الكاف- للاحتكاك والتشبيه.
2-الياء- كحفرة صوتية، هي للنسبة الذاتية والمكان الخفيض.
ومحصلة معاني حرفيها تشير إلى وظيفتها الفطرية في جعل الفاعل يحتك بمفعوله، فيستكين لطلبه.
ثانياً- حول معانيها واستعمالاتها التراثية:
هي حرف مصدرية ونصب. قد تستعمل مسبوقة بـ (اللام) التعليلية، نحو: ((ذهبت إلى المدرسة لكي أتعلمَ)).
وقد تستعمل غير مسبوقة بها، نحو: ((ذهبت إلى المدرسة كي أتعلمَ)). وقد اختلف النحاة في هذه الأخيرة. فبعضهم قال: هي المصدرية الناصبة. ومصدرها في محل جر بلام التعليل المحذوفة. وقال آخرون بل هي حرف جر. أما الناصب المضارع فهو (أنْ) المضمرة بعدها أي ((كي أنْ أنجحَ)).
أما نصبها المضارع فيما نرى فيرجع إمَّا الى وظيفتها، أو إلى (أن) المضمرة بعدها في تحميله رغبة الفاعل وقصده مباشرة في وجهي استعمالها: أمسبوقة كانت باللام التعليلية أو غير مسبوقة بها.
ففي قولنا ((درست (كي-لكي) أنجحَ)) قامت (كي) بتحميل فعل (أنجحَ) رغبتي وقصدي من الدراسة، على مثال ما يقع للمفعول به، فكانت الفتحة أولى به من الضمة والسكون.
ثالثاً: حول العلاقة الفطرية بين خصائص حرفي (كي) ومعانيها التراثية:
1-(الكاف) في(كي) قد جعلت (دراستي) في الأمثلة السابقة (تحتك وتتطابق) مع رغبتي في (النجاح).
2-أما (الياء) كحفرة صوتية، فقد جعلت (النجاح) يقع في حيز هذه الرغبة، فاستكان لها فكان مفعولاً به مؤولاً يستحق النصب كما ذكرنا آنفاً.
ومما يشير إلى صحة هذا التخريج أن (كي) تقبل دخول (لام) الإلصاق عليها في (لكي). وذلك لتوكيد خاصيتي (الاحتكاك والمطابقة) في وظيفتها الفطرية. فعبارة: ((درست لكي أنجحَ)) تكشف عن شدة رغبتي في النجاح أكثر من عبارة (درست كي أنجحَ). فمعاني (اللام) هنا هو اقرب للتوكيد، وهو أحد معانيها، كما أسلفنا في دراستها.
وبذلك تكون (كي) المصدرية المختصة بنصب الأفعال المضارعة هي إحدى مستحاثاتنا اللغوية.
 الاكثر قراءة في الحروف وأنواعها
الاكثر قراءة في الحروف وأنواعها
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











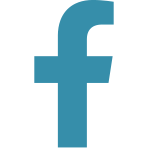
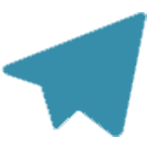
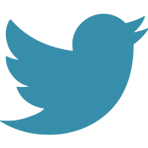

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)