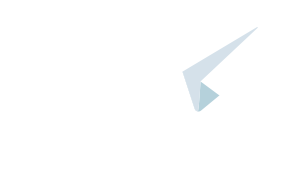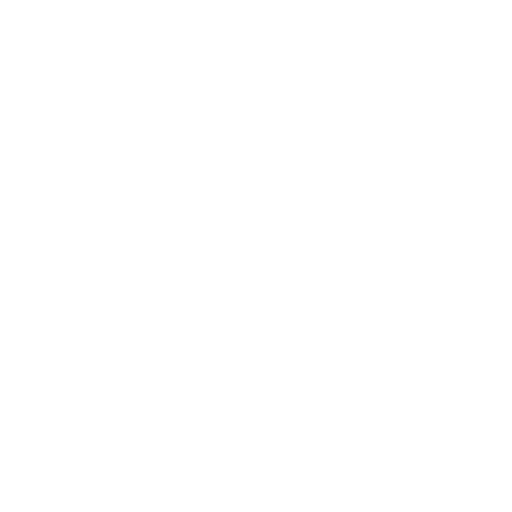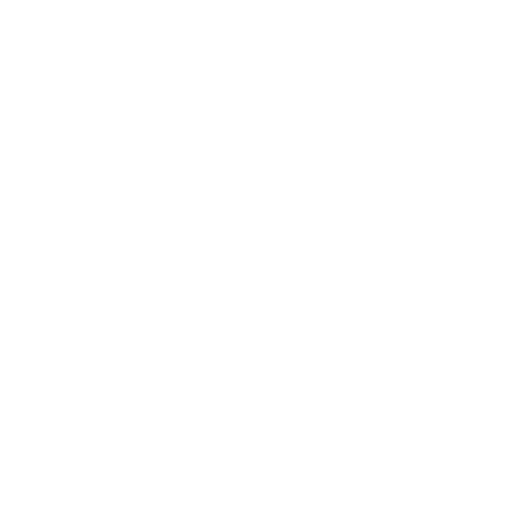الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات


قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية
الهداية في القرآن
المؤلف:
السيد عبد الاعلى السبزواري
المصدر:
الاخلاق في القران الكريم
الجزء والصفحة:
41- 60
30-4-2021
2656
قال تعالى : {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا } [البقرة: 135].
الضمير في قالوا يرجع إلى أهل الكتاب ، و (أو) للتنويع ، والجملة لبيان عقيدتهم.
أي : قالت اليهود إن دينهم على الحق ، وأن الهداية محصورة في اليهودية ، وكذلك ادعت النصارى ، بل إن ذلك معتقد كل ذي دين أن دينهم خير الأديان ، وأن كتابهم أبدي لا يقبل التغيير والتبديل، وطرق الهدايا منحصرة في دينه ، ومقتضى ذلك أن يدعو كل واحد من الفريقين الناس إلى دينه.
وهذا النوع من المنهج من الفطريات لكن من يعتقد بشيء ويرى صحته ، وهو من الجهل المركب ، وداء ابتلي به جميع الأمم حتى بعض فرق المسلمين ، الذي يعتقد صحة مذهبه أو عقيدته وبطلان غيرهما ، وقد أبطل سبحانه مدعاهم بدليل إلزامي لهم ، فقال مخاطباً لنبيه (صلى الله عليه واله) إتماماً للحجة والبيان ، وتلقيناً للبرهان، وتثبيتاً لشريعته ونبوته ، بل إظهاراً للوحدة بين أصل الوحي وقول الموحى إليه في الحجية ، وتوطئة لأمر المسلمين بهذا المقال.
قال تعالى : {قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } [البقرة : 135].
مادة (حنف) تأتي بمعنى الميل ، أي : الميل من الضلالة إلى الهداية ، ومن الباطل إلى الحق، فصارت تطلق على الموحد0 التابع لدين الحق ، وهي بخلاف (جنف) فإنه الميل من الحق إلى الباطل.
وقد استعملت هذه المادة بالنسبة إلى ملة إبراهيم في القرآن الكريم كثيراً ، قال تعالى : {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [آل عمران : 95] ، وقال تعالى : {دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [الأنعام : 161] ، وقال تعالى : {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل : 120].
وتطلق على أصل الملة والدين أيضاً ، قال تعالى : {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا } [الروم : 30] ، وفي الحديث : " أحب الأديان إلى الله تعالى ، الحنيفية السمحة ".
والوجه في إطلاق الحنيفية على إبراهيم وملته دون غيره من الأنبياء السابقين ، أن إبراهيم كان في قوم مشركين، عبدة الأوثان ، وقد جاهد (عليهم السلام) في دعوتهم إلى التوحيد ونبذ الأوثان وعبادتها ، وابتلى من قومه بما ابتلى حتى اختاره الله تعالى لأقصى درجات الخلة والإمامة ، ومنحه الملة التي كانت بمنزلة المادة لجميع الأديان الإلهية الكبرى - اليهودية والنصرانية والإسلام - مع أنه - يعتبر مؤسسة حركة التوحيد في العالم، وبه ابتدأت الشرائع الإلهية.
وأما شرائع من قبله من الأنبياء ، فلم تكن لها تلك الأهمية التي جعلها الله ملة إبراهيم، ولذلك كانت ملته الملة الحنيفية الجامعة للمعارف الإلهية، والكاملة في التوحيد ونفي الشرك ، والارتقاء في معارج الكمال ، وقد أنزلها تبارك وتعالى حسب المصالح ومقتضيات الظروف حتى انتهى الامر إلى الإسلام ، الدين الجامع لجمع الكمالات والمشتمل على أقص المعارف الإلهية.
ومن ذلك يعرف أن اختلاف المفسرين في معنى الحنيف وبيان الأخذ لا وجه له ، بل هو اختلاف مصداقي .
والجامع هو الصحة والتمامية والسهولة وعدم الضيق والحرج.
وإنما ذكر سبحانه إبراهيم (عليه السلام) ، وأمرهم باتباع ملته ، لأنه لا ينازع أحد من أهل الكتاب في أنه كان مهتدياً ، بل يعتبر إمام المهتدين، فإذا كان ادعاء كل واحد منهم صحيحاً، لكان إبراهيم (عليه السلام) - غير مهتد ، وهم لا يقبلونه.
ومن ذلك يستفاد أن الهداية منحصرة في اتباع ملة إبراهيم (عليه السلام) ، وأن موسى وعيسى (عليهم السلام) أيضا كانا متبعين لملته ، لأنه الدين الحنيف القائم على الصراط المستقيم ، والمبني على التوحيد والإخلاص ونفي الشرك ، والحق أحق أن يتبع .
قال تعالى : {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [البقرة: 135].
أي : لم يكن إبراهيم من المشركين بالله تعالى، وفيه إشارة إلى اختلاط اليهودية والنصرانية المخترعتين لنوع من الشرك والتناقض ، على ما يأتي تفصيله.
قال تعالى : {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ} [البقرة : 136].
الأسباط : جمع سبط ، وهو بمعنى الانبساط في سهولة، وسمي ولد الولد سبطاً لانبساطه وتفزعه من الجد ؛ ومنه سمي الحسن والحسين (عليه السلام) سبطي الرسول (صلى الله عليه واله).
والأسباط في بني يعقوب كالقبائل في بني إسماعيل ، وكانوا اثني عشر سبطاً ، كل سبط ينتهي إلى ولد من ولد يعقوب ، كل واحد منهم أمة وجماعة من الناس ، قال تعالى : {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} [الأعراف : 160] ، ولذلك لم يستعمل في القرآن إلا جمعاً.
وسموا بذلك أيضاً في التوراة وغيرها.
والنزول مساوق للإيتاء في الجملة ، لأنه يشمل الجواهر والأعراض والتشريعات ، قال تعالى : {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [الحديد : 25] ، وقال تعالى : {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى} [الأعراف : 26] .
وقال تعالى : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر : 21] .
وقال تعالى : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة : 44] ، إلى غير ذلك من موارد استعمالات هذه المادة في القرآن الكريم ، التي هي كثيرة جدا بهيئات مختلفة.
فأصل المادتين - الإيتام والإنزال - متحدتان في جامع قريب هو الإيصال والوصول، إلا أنه لوحظ في النزول الانحطاط من العلو في الجملة، بخلاف الإيتاء ، لكنه إذا أضيف الممكن إلى الواجب بالذات ، والمخلوق إلى الخالق الغني بالذات ، ينطبق عليه الانحطاط من العلو - لوحظ ذلك أو لم يلحظ - فكل إيتاء منه عز وجل إنزال دون العكس.
ولعل الوجه في التعبير بالنسبة إلى إبراهيم (عليه السلام) ومن تبعه بالإنزال والإعلان بأنه مؤسس الحركة الدينية والملة الحنفية، فلا بد من إفاضة ذلك من عالم الغيب .
ثم إنه قد يستدل على أن الأسباط كانوا أنبياء بالآية المباركة، وبقوله تعالى : {وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى } [النساء : 163].
وفيه : أن الآية المباركة أعلم من حدوث الوحي وإبقائه ، ومناط النبوة هو الأول دون الثاني، فيكون من حفظ الوحي غير من أنزل الوحي عليه ابتداء .
وفي بعض الأحاديث: " إن الله تعالى جعل النبوة في ولد بنيامين ونزعها من ولد يوسف)).
وعن أبي جعفر (عليه السلام) نفي كون الأسباط انبياء ، ولكنهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء ، ولم يكونوا فارقوا الدنيا إلا سعداء.
ومن ذلك يظهر الوجه في قول نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) ، أي في جهة حفظ الدين والوحي المبين ، فإن العلماء أمناء الله تعالى في أرضه ما لم يميلوا إلى الدنيا .
وهذه الآية المباركة دعوة عقلية إلى نبذ الاختلاف والعصبية والأهواء ، وهي تدعو الناس إلى الوحدة والاتحاد بين جميع أفراد البشر في المبدأ والتشريع والمعاد، والترغيب إلى الإيمان بأصل الدين ، الذي لا خلاف فيه بين جمع أنبياء الله تعالى ، فكما أن البشر متحدون في أصل التكوين الإلهي ، كذلك لا بد وأن يكون بينهم اتحاد في نظام التشريع الربوي. والاختلاف إنما ينشأ من المصالح الزمنية، وما يقتضيه السير التكاملي في الإنسان ، كما أنه يختلف حفاظ الوحي باختلاف العصور والقرون .
والمراد بقوله تعالى : وما أنزل إلينا القرآن وجميع المعارف والتشريعات الإلهية التي أتى بها نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) ، وباعتبار النزول عليه وعلى سائر الأنبياء صدق النزول علينا أيضاً.
كما أن المراد بقوله تعالى : {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران : 84] الصحف التي أنزلت عليه وملته الحنفية المقدسة التي أمر النبي (صلى الله عليه واله) باتباعها.
وإن المراد بما أنزل على إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ذلك أيضاً ، لأنهم الحفظة للملة الحنيفية علماً وعملا وبياناً ، وإلا لم يعهد نزول كتاب عليهم ، كما أن علماء أمة محمد (صلى الله عليه واله) كذلك ، كما عرفت .
قال تعالى : {وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ} [البقرة : 136].
مادة (ا ت ي) تأتي بمعنى المجيء بسهولة ، وتستعمل في الأعيان والأعراض ، والخير والشر.
والكل مذكور في القرآن الكريم ، قال تعالى : { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء : 88، 89] ، وقال تعالى : { أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ } [التوبة : 70] ، وقال تعالى : { وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء : 47] ، إلى غير ذلك من الآيات المباركة.
وما أوتي موسى وعيسى عبارة عن التوراة والإنجيل ، وما حباهما الله تعالى من كرامة الوحي وسائر المعجزات الباهرات.
وإنما خضهما بالذكر لكثرة الاهتمام بهما ، ولأن المقام مقام المحاجة مع اليهود والنصارى والاحتجاج عليهما، وإلا فهما كسائر أنبياء الله تعالى يدعوان إلى التوحيد والإسلام ، ولذا أكد سبحانه وتعالى بعد ذلك بــ :
قال تعالى : { وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ} [البقرة : 136].
فلم يكن لك خاصاً بموسى وعيسى، فيكون تعميماً بعد التخصيص ، وإيضاحاً للسبيل ، واتماماً للحجة، والإشارة إلى أن أنبياء الله تعالى متحدون في الدعوة إلى الحق ، وهو أيضاً أعم من المعارف التشريعية والمعجزات التي خص الله تعالى بها كل نبي.
قال تعالى : {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة : 136].
أي : قولوا لا نفرق بين أحد من الرسل والأنبياء ، ونحن لله تعالى مسلمون.
قال تعالى : {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا } [البقرة : 137].
(الباء) في (بمثل) بمعنى التشبيه فقط ، ولفظة " مثل " تفيد معنى الآلية التي ينظر بها، جيء به إتماماً للحجة ، وقطعاً للخصومة، وهذا شايع ومتعارف عند الناس ، فليست الكلمة زائدة، بل بمعنى التوسعة في المثلية في جمع القرون اللاحقة .
قال تعالى: {وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ} [البقرة : 137].
التولي : هو الإعراض ، ومادة (ش ق ق) تأتي بمعنى الثقب والخرم ، ويلزمهما الفصل والتجزئة، وهي تستعمل في القرآن كثيراً ، قال تعالى : {ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا} [عبس : 26] ، وقال تعالى : {وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} [الحج : 53] ، وقال تعالى : {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} [ص : 2].
وللشقاق مراتب كثيرة بالنسبة إلى الأصول والفروع والأخلاق ، والشقاق بالنسبة إلى الله ورسله بمعنى الكفر والضلال ؛ فالكافر في شق والمؤمن في شق ، والمصلي في شق وتارك الصلاة في شق آخر ، والعادل في شق والفاسق في شق آخر ، وهكذا.
فكل شيء وغيره يمكن أن يكونا من شقين ولو كانا من صنف واحد في الجملة، وفي أحاديث آخر الزمان : " لا بد من فتنة يسقط فيها الحاذق الذي يشق الشعرة شعرتين" أي بحذافته وفكره .
قال تعالى : {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة : 137].
كفى : يأتي بمعنى سد الخلة وبلوغ المراد في الأمر، قال تعالى : {وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ} [الحج: 53] ، وقال تعالى : {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [الحجر: 95] ، وغير ذلك من الاستعمالات القرآنية التي يأتي التعرض لها.
فهو السمع لأقوالهم، العليم بأعمالهم وما في ضمائرهم وما يقدره على عباده وما ينفذه فيهم ، فهو الكافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء.
والآية الشريفة من البرهان العقلي الذي قرره القرآن الكريم ، بأن يقال : الإيمان بالأنبياء والرسل سبب للهداية ، فكل من كان على إيمانهم فهو مهتد ، فاليهود والنصارى إن كانوا على إيمانهم فهم مهتدون ، ثم نقول إنهم ليسوا على إيمان الأنبياء والرسل، وكل من كان كذلك فهو في شقاق مع الله ورسله ، فاليهود والنصارى في شقاق مع الله ورسله ، وكذا كل من يكون مثلهما في المخالفة الاعتقادية أو العملية مع الله ورسله ، هذا بالنسبة إلى أصل ثبوت الموضوع.
وأما الأثر المترتب عليه، فهو أن الله تعالى يكفي أنبياء ، ورسله والمؤمنين بهم من كيد أهل الشقاق ونفاقهم ، كما يقتضيه نظام التكوين والتشريع .
وفي الآية المباركة تسلية للمؤمنين بالنصر ، ووعد لهم بالكفاية ، ولن يخلف الله وعده ، وقد ظهر صدقه مراراً ، وسيظل كذلك في ما بعد إلى آخر الزمان.
كما أن هذه الآية المباركة من أدلة نبوة نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) ورسالته.
قال تعالى : {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} [البقرة : 138].
الصبغة : اسم للكيفية الحاصلة من صبغ الشيء ، فكما أن للأجسام ألواناً تظهر للبصر، كذلك للنفوس والأرواح ما هو بمنزلة اللون، يظهر لأهل البصائر والبصيرة من بياض وسواد ، وصفاء وكدر ، ونور وظلمة ، وطهارة وخباثة.
وأخرى : تضاف إلى غيره تعالى ، وهي الظلمة والكدورة التي تحجب عن مبدأ النور.
فيكون المراد بالصبغة هو العقل الذي بعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان، الذي تجتمع فهي الشرائع الإلهية - على ما يأتي من التفصيل - المعبر عنها بالفطرة السليمة ، وما سوى ذلك من صبغة الله تعالى.
فصبغة الله تعالى هي الطهارة عن كل دنس روحي ومعنوي ؛ ولا يمكن أن تجتمع مع الشرك والكفر والنفاق والرذائل النفسانية ، فلا تتأثر بالتقاليد والأهواء والعصبية، وإنما هي من صنع الله تعالى التي تبقى وتدوم ، وهي المؤثرة في الإنسان في جمع العوالم التي ترد عليه.
وهي التي تميز من كان على الصبغة الإلهية - التي يظهر أثرها الكريم من التوحيد والأخلاق الفاضلة والأعمال الشريفة - من غيرها الذي يكون على الصبغة البشرية ، التي هي في اضطراب وتعدد وتفرق.
فما يفعله النصارى من تعميد أولادهم لا ينفع لدنياهم - مع ما هم عليه من الكفر - إلا إذا كان ما قرره الإنجيل مصدقاً بالقرآن ، فحينئذ ينفعهم التعميد ، لأنه من دين الله تعالى.
وبالجملة : صبغة الله ترجع إلى ارتباط العبد مع الله تعالى بنحو ما يشاء الله تعالى ويريده ، لا بما يشاؤه العبد ويريده ، كما يدل عليه صدر الآية المباركة وذيلها ، فإن قوله تعالى : {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة : 136] ، وقوله تعالى : {وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} [البقرة : 138] ، بيان للصبغة والعلة لتحققها ، والإيمان والعبودية إنما يتحققان بما يشاء الله المعبود بالحق ، لا بما يشاؤه العابد.
ومن ذلك يظهر أن تفسير الصبغة بالإسلام ، أو ملة إبراهيم ، أو دين الله تعالى ، كل ذلك صحيح وينبئ عن شيء واحد ، وهو التوجه إلى الله تعالى والانقطاع عن غيره ؛ كما سيأتي في البحث الروائي.
ثم إن هذه الصبغة تنسب إلى الله تعالى نسبة الفعل إلى الفاعل ، كما تنسب إلى العبد نسبة الشيء إلى قابله ، وكن منهما على نحو الاقتضاء ، لا العلية التامة.
ومن ذلك يظهر أحسنية هذه الصبغة من حيث الذات والمورد والفاعل ، فأصل اللون هو التوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق ، ومورده المؤمن ، وفاعله هو الله عز وجل ، وغايته السعادة والخلود في الجنان.
ومن آثارها العبودية التي كنهها الربوبية ، فلا يتصور في العالم شيء أفضل وأحسن من هذه الصبغة ، وفيها قال تعالى : {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم : 30].
قال تعالى : {وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} [البقرة : 138]
أي : لا نشرك في العبادة والألوهية غيره تعالى ، وهو في موضع الحال، وبيان العلة لأحسنية الصبغة.
كما أن نصب (اصبغة الله) بالفعل المقدر ، أي : اتبعوا ، أو بدل من ملة إبراهيم، وإن كان الأخير هو الأوفق، كما عرفت.
ثم إن كمالات النفس الإنسانية على أقسام ثلاثة :
الأول : ما تكون للدنيا ومن الدنيا وفيها أيضاً ولا تتجاوز عنها ، وهذا هو الكثير الذي ابتلي عامة الناس به ، ولا ربط له بصبغة الله تعالى أبداً.
نعم ، هو مورد فضاء الله وقدره.
الثاني : ما تكون للدنيا والآخرة معاً ، بحيث يجعل الدنيا وسيلة وذريعة للوصول إلى الكمال الأخروي.
الثالث : ما تكون للآخرة فقط ، بحيث لا نظر إلى الدنيا إلا على نحو الآلية والمرآتية، كما قال علي (عليه السلام) : " صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى".
والقسمان الأخيران من صبغة الله تعالى ؛ ولكل منهما درجات متفاوتة ومراتب كثيرة.
قال تعالى : { قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ} [البقرة : 139].
المحاجة : المجادلة ، ومادة (ح ج ج) : تأتي بمعنى القصد والطلب، ومنه: " حج البيت " ، وحيث إن كل واحد من المتخاصمين والمتنازعين يطلب الغلبة على الآخر ويقصد جذبه ، أطلقت عليه المحاجة.
وتستعمل في كل من الحق والباطل ؛ قال تعالى : رويتك {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ } [الأنعام : 83] ، وقال تعالى : {وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ } [الأنعام : 80]. والعلوم الاستدلالية مشحونة من الاحتجاجات المتضادة المتناقضة مع العلم بكذب أحد الطرفين ، والعلماء وضعوا علماً مستقلا مفصلا لبيان الحجة الصحيحة مادة وصورة، والتمييز بينها وبين انحاء المغالطة.
والمعنى : أتجادلوننا في الله وتدعون أنكم أحباء الله وأبناؤه والموحدون له، وأن دينكم الحق، وأن النبوة فيكم، مع أن رحمته وسعت كل شيء وكل عبيده، ولا تختص رحمته بقوم دون آخرين ، وجمع تلك المقترحات باطلة ، وأن الله يختار ما شاء ، و {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } [القصص : 68] ، وكيف يخصكم برحمته دون غيركم ؟ { وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ} [البقرة : 139] ، والجميع عباده ، ورحمته واسعة ؛ وهو الرب ولكن مربوبون له.
قال تعالى : {وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ} [البقرة : 139].
مادة خلص ؛ تأتي بمعنى ذات الشيء وخاصته وزوال كل ما يشوبه وينافيه ، وقد استعملت في القرآن الكريم بهيئات مختلفة ، قال تعالى : { إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ} [ص : 46] ، وقال تعالى : {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [الزمر : 2] ، وقال تعالى : {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } [ص : 82، 83] ، وقال جل شأنه : {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر : 3] ، إلى غير ذلك من الآيات المباركة.
وكل ما قيل في حقيقة الإخلاص يكون دون حذه ورتبته ، وقد قال علي (عليه السلام) : " بالإخلاص يكون الخلاص ، وطوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء "
وهو من الأمور الإضافية ، فيضاف إلى أصل التوحيد تارة بدرجاته ، وفي مقابله الشرك بمراتبه.
والى العبادة أخرى ، وفي مقابلها الرياء بمراتبه.
والى سائر الأعمال ثالثة، وفي مقابلها كثير من مفاسد الأخلاق.
والجامع بين الجمع الإخلاص في الدين.
والعلماء والعرفاء ذكروا للخلوص والإخلاص معارا متعددة ، فعن الفقهاء أن معناه إتيان العمل لله تعالى ، بأن يكون الداعي على إتيانه هو الله تعالى ؛ وقد فضلنا القول فيه في الفقه.
وعن بعض العرفاء : أن الإخلاص ؛ سر من أسرار الله تعالى ؛ يستودعه قلب من يحب من عباده.
وعن آخر : أنه لا يحب أن يحمد على شيء من عمله .
وقد ينسب هذان القولان إلى الحديث أيضا.
والحق: أنه من الحقائق التي لها مراتب كثيرة جداً ، فأولى مرتبته أن يكون الداعي على إتيان العمل هو الله تعالى ، وأقصى مراتبه ما تنتهي إلى حبه تعالى ، وفي هذه المرتبة أيضا درجات غير محدودة حتى ينتهي إلى ما أثبتوه من الفناء في الله ، الذي هو عين البقاء بالله تعالى.
وبالجملة : أصل الحقيقة وجدانية عملية ، لا أن تكون قولية بيانية ؛ فكم من حقائق تقصر الألفاظ عن بيانها - وإن كثرت - والعبارات عن شرحها - وإن تعددت -.
والمعنى : أن التفاضل يأتي من ناحية الأعمال ، فكل امرئ رهين عمله ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، والدار على الإخلاص ، وفيها تعريض لهم بعدم الإخلاص لهم.
والآية من الآيات التي تبين كيفية رد من يخاصم الإسلام ، سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم.
ونظير الآية المباركة بوجه أبسط من المقام قوله تعالى : {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [الشورى : 15] ، وهذه الآية شارحة لجمع الآيات الواردة في هذا السياق.
والمستفاد منها أن منشأ النزاع والتخاصم مع دين الإسلام إما أن يرجع إلى المبدأ، أو إلى المعاد، أو إلى أحقية دين الإسلام ، أو إلى جهات أخرى دنيوية.
وجمع ذلك غير مقبول بالنسبة إلى الإسلام .
أما الأول : فإذا كان المعادي من لا يعترف بالمبدأ ، فلا بد له من الرجوع إلى الأدلة العقلية والبراهين الساطعة التي يثبت بها المبدأ ؛ وقد أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : {اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ} [الشورى : 15].
وأما الثاني : فلان إثبات الجزاء للأعمال يستلزم الاعتراف بالمعاد ، لأن العمل لا يعقل بدونه بعد الاعتقاد بالمبدأ ، فهما متلازمان ثبوتاً وإثباتاً ، ويدل عليه قوله تعالى : {وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} [البقرة : 139] ، وهو من قبيل ذكر اللازم وارادة الملزوم.
وأما الثالث : وهو أحقية الإسلام - ويندفع بالآيات البينات والمعجزات الباهرات - وإليه يشير قوله تعالى : {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} [الشورى : 15].
وأما الرابع: وهو الأغراض الدنيوية كالتي يدعيها اليهود والنصارى ، فإخلاص دين الإسلام لله عز وجل ينفي ذلك كله ، إذ لا معنى للدين الخالص إلا ما كان له تعالى ، فكل ما سواه باطل ، خصوصاً ما يتعلق بمعبوديته وعبادته.
قال تعالى : { أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة : 140].
بين تعالى حجة أخرى لإبطال دعواهم بأحسن بيان وأتم حجة ، أي : أتقولون إن إبراهيم - وأولاده وأحفاده كانوا هوداً أو نصارى ؛ وإن اليهودية أو النصرانية هما المرضيتان عند الله، ولا ينجو أحد إلا بهما ، وإن ما عداهما كفر وضلال ؟!
كيف ، وقد كان إبراهيم (عليه السلام) وأبناءه ، واحفاده على الملة الحنفية المرضية - التي بدأت بخليل الرحمن وختمت بسيد المرسلين — الداعية إلى أصول المعارف الإلهية في المبدأ والمعاد.
والأحكام الشرعية ، والبداهة والبرهان تدلان على كذبهم ، وأن اليهودية والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم (عليه السلام) وأولاده وأحفاده بقرون ، وهذا ادعاء باطل ، قال تعالى : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [آل عمران: 65].
إلا إذا ادعوا أنهم كانوا شهداء حين حضر هؤلاء الأنبياء الموت ، فأوصوا لأعقابهم بالتهود والتنصر ، وهذا كسابقه باطل ، ولذا رد عليهم سبحانه.
وفي قوله تعالى : {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ} [البقرة : 140] توبيخ وتعبير لهم بإبطال جميع محتملات كلامهم ، ثم إظهار ما هو الحق.
و" أم " متصلة ومعادلة لما قبلها ، أي : إن كانت المحاجة في الله تبارك وتعالى فأنتم والمسلمون تعترفون بأنه تعالى رب الكل ، وإن كانت في أن ابراهيم - وأولاده وأحفاده كانوا هوداً أو نصارى ، فهو خلاف الوجدان والبرهان ، لأن التوراة والإنجيل نزلا بعد إبراهيم بقرون ، وأن الله هو الجاعل النبوة لإبراهيم وأولاده ، وأنه أنزل الكتب السماوية على رسله ، فهو أعلم بذلك منكم .
قال تعالى : {قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [البقرة : 140].
أي : أنتم أعلم بالواقع - مع ادعائكم الباطل - أم الله الذي أخبر بأن إبراهيم كان حنيفاً، وأنه ارتضى لكم ملته ؟! أو أن أولاده رضوا بعبادة الله إلهاً واحداً - كما عرفت - وأنه أنزل الكتب السماوية على رسله ، فهو أعلم بذلك منكم. ولا ريب في أنهم يعترفون بالثاني ، فيكون ادعاؤهم باطلا.
قال تعالى : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ } [البقرة : 140].
كتم : بمعنى ستر ، وكتم الشهادة أي سترها ، وهو وشهادة الزور من المعاصي الكبيرة.
والمراد من الشهادة في المقام شهادة التحمل - كما هو الظاهر - فيكون التوبيخ والتعيير حقيقياً ، لأجل كتمان الواقع وإيقاع النفس في الكبيرة الموبقة والهلاك الأبدي.
ومثل هذا كثير في القرآن الكريم ، قال تعالى : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } [الأنعام: 21] ، وقوله تعالى : {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ} [الزمر : 32] ، إلى غير ذلك من الآيات المباركة.
والمراد بالمشهود عليه : إما رسالة رسول الله (صلى الله عليه واله) ، وقد أخبر الله تعالى اليهود بأنه يقيم لهم نبياً من إخوتهم ويجعل كلامه في فيه ، كما أخبر المسيح برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ، وقد كتموا هذه الشهادة تعصباً وإنكاراً للحق.
أو الشهادة بأن إبراهيم (عليه السلام) كان على دين الحق والإسلام والملة الحنفية ، ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً .
وقد كتموا الشهادتين ظلماً.
ومن المحتمل أن يكون المراد شهادة الأداء ، أي من أظلم من الله لو كان قد كتم الشهادة على أن إبراهيم (عليه السلام) كان يهودياً أو نصرانياً ، وقد بين خلافها ، فيكون الشرط تقديرياً ، ويصح مثل هذا التعبير في المحاورات حتى مع امتناع المتعلق ، كما في جملة كثيرة من القضايا الشرطية وما في سياقها.
ويكون المراد من مثل هذا التعبير هو إيهام الطرف بأن كتمان الشهادة من الظلم القبيح ، وفيه من المفسدة العظيمة ولا سيما إذا كانت الشهادة في المعارف الإلهية والأمور الدينية ، فيكون أظلم ، ولذا أوعد عليه تبارك وتعالى بــ :
قال تعالى : {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة : 74].
تقدم معنى الغفلة في آية (75) من هذه السورة ، وقد ذكرت هذه الكلمة في القرآن العظيم كثيراً ، قال تعالى : } {وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [هود: 123] ، قال تعالى : {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [آل عمران : 99] ، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة. وبعد فرض إحاطته تعالى بما سواه إحاطة ربوبية قيومية تستحيل العفلة بالنسبة إليه جل شأنه ، لأنه من الجمع بين النقيضين ، فالغفلة منه ممتنعة وتقع من عباده بالنسبة إليه تعالى، ولها مراتب كثيرة جدا.
هذا ، ولكن ليس من القبيح عقلا ولا شرعاً غفلته تعالى عن سيئات عباده ، وهي في الحقيقة ترجع إلى تغافله تبارك وتعالى عنها.
قال تعالى : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة: 134].
تقدم معناها ، وإنما كررت تأكيداً لسوء أخلاقهم، وبياناً لعدم اقتداء الخلف بالسلف الصالح، فكانت إحدى الآيتين بالنسبة إلى أصل الحدوث لطائفة ، وهم الأنبياء والرسل، والأخرى كانت ناظرة إلى البقاء بالنسبة إلى طائفة أخرى ، أي : أنهم يعالون عن أعمالهم مع هذا الدين الجديد ومعاملتهم مع رسول الله (صلى الله عليه واله) .
والآية المباركة تشير الى إنكار رذيلة الاستكبار عن قبول الحق والإصرار على الباطل ، والافتخار بالدعاوى التي لا واقع لها ، والتعلل زوراً بمن مضى.
وفي تكرارها تأكيد أيضا إلى ارتباط المعادة بالعمل الصالح ، الذي أكد القرآن الكريم عليه ، فكن يجزى بعمله ، ولكن ذلك لا ينافي ثبوت أصل الشفاعة . كما لا تدل عليها ، فإن انتفاع الناس بعضهم ببعض في الدنيا والآخرة مما لا ريب فيه عقلا وشرعاً ، فالمقام كالآيات الشريفة الدالة على عدم تملك نفس عن نفس شيئاً ؛ قال تعالى : {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ } [الانفطار : 19] ، التي لا تنفي الشفاعة.
 الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












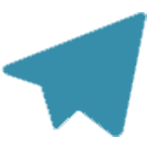
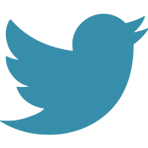

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)