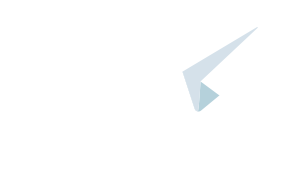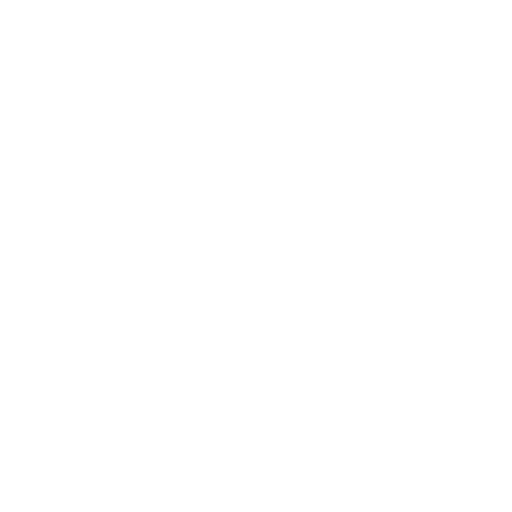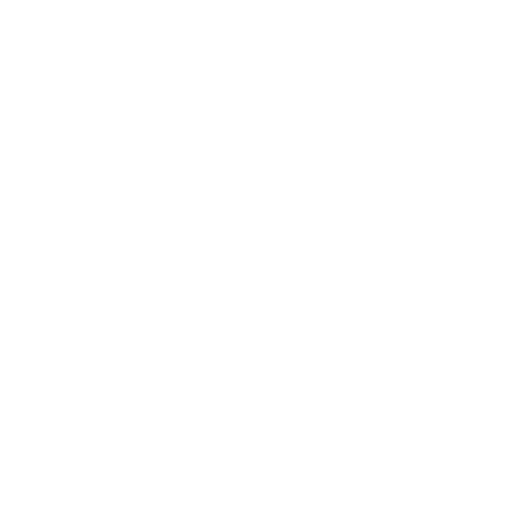الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات


قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية
وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم
المؤلف:
السيد عبد الأعلى السبزواري
المصدر:
الأخلاق في القرآن الكريم
الجزء والصفحة:
204 - 216
15-7-2021
5283
قال تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ * هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133 - 138]
دعوة عامة إلى الغفران ، وبشارة عظيمة لجميع أهل الذنوب والعصيان ، واستضافة من الجواد الغني لجميع الواردين عليه ، وترغيب إلى العباد في إزاحة جميع الأغشية والظلمات ، ودفع أنوع الجهالات ، ووعد منه عز وجل لمن أطاع الله وأطاع الرسول ، وقد ذكر جزاء المتقين المطيعين اتباعاً للوعيد بالوعد الجميل ، واقتراناً للترهيب بالترغيب ، كما هو سنته عز وجل.
والمسارعة المبادرة والاشتداد في السرعة ، وهي في الخير ممدوحة وفي الشر مذمومة ، والمسارعة إلى الخيرات هي المبادرة إليها.
وإنما أمر سبحانه وتعالى بالمسارعة إليها بإطاعة الله تعالى والرسول ، للتنبيه على ترك التسويف الذي يفوت به الأجر والحظ ، وكثرة المثبطات ووسوسة الشيطان التي توهن العزائم.
ويمكن أن يكون قوله تعالى : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [آل عمران : 135] ، مبينا للمغفرة في هذه الاية الشريفة ، كما أن قوله تعالى : {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ} [آل عمران : 134] مبينا للمسارعة إلى الجنة.
وكيف كان ، فإن أسباب المغفرة والدخول في الجنة معروفة مذكورة في القرآن الكريم والسنة الشريفة ، كما أن أسباب الدخول في النار كذلك.
قال تعالى : {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران : 133].
العرض خلاف الطول ، وهر أقصر الامتدادين عادة ، ويكنى به عن السعة ، واستعماله في ذلك شائع ، يقال : بلاد عريضة ، أي واسعة ، ومنه قولهم : أعرض في المكارم إذا توسع فيها ، وفي الحديث عنه (صلى الله عليه واله) : " لقد ذهبتم فيها عريضة " ، أي الأرض الواسعة ، وقد قال (صلى الله عليه واله) ذلك عندما هرب جماعة يوم أحد فراراً من الزحف.
ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره بعض من أنه إذا كان العرض كذلك فأين الطول وما مقداره ، مع أنه لا يجري ذلك إذا فرضنا كروية الجنة.
ويمكن أن لا يكون التعبير كنائياً ، بل كان على الحقيقة ، إما بناء على عدم تناهي الأبعاد ، كما عن جمع من الفلاسفة ، فالأمر واضح. وإما بناء على التناهي كما عن بعض ، فلا ريب في أنه على فرض صحته إنما هو في الدنيا ، وأما في الآخرة فهي غير متناهية من جميع الجهات ، زمانا ومكانا ، وسعة ونعمة ، وغير ذلك.
وقد ذكر المفسرون في معنى العرض في المقام بما لا يرجع إلى محصل.
ونقل عن أبي مسلم بن بحر : أن المراد من العرض في الآية الشريفة هو من عرضك الشيء على البيع ، والمقايضة ، أي لو عرضت الجنة بالسماوات والأرض لكانتا ثمنا.
وهذا تأويل باطل.
وكيف كان ، فالآية الشريفة ترمز إلى معنى جميل ، ترغب المخاطبين إلى المراد بأسلوب لطيف وجار على ما يتصوره الناس من التمثيل بالموجود في الخارج ، وتبين بلوغ الجنة في السعة بحيث لا يمكن أن يحدها حد وهمي ، وهذا مما يوجب اطمئنان الإنسان بأن له ما مشتهيه النفس من جميع الجهات ، ففي بعض الأحاديث القدسية : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر " ، وهذا هو شأن النعمة التي أعدت من غير المتناهي من كل جهة إلى المنعم عليه المتناهي من كل جهة ، وهذه هي الحياة الكاملة الأبدية التي لا ينبغي للإنسان إلا السعي في دركها.
قال تعالى : {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133].
الإعداد : التهيئة ، وهو إما علمي أو خارجي ، في هذه النشأة أو في نشأة أخرى أو في عالم الملكوت الذي يكون كالصورة والمرآة لهذا العالم بجمع جزئياته وكلياته ، ويمكن أن يعبر عنه بعالم المثال الخارجي ، وهو موجود بوجود روحاني معنوي ، ودخله سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) في معراجه واطلع على خصوصياته ، فيكون الإعداد مطابقاً للوجود العلمي الأزلي ، والوجود الخارجي في الدنيا والوجود الأخروي في ما لا يزال.
والتقوى هي سبب معد للجنة ، فتكون حقيقة التقوى منزلة من العلم الأزلي مثل بالوجود المثالي ، ثم نزلت إلى هذا العالم وستعود إلى المحل الذي أعدته لنفسها ، كما أنها حقيقة العصيان والطغيان والكفر كذلك ، ولكن منها مظاهر خاصة تناسب عالم ظهورها ، ويمكن التمثيل له في هذا العالم أيضا ، فإن بعض الأراضي لا قابلية لها إلا لزراعة مثل الزعفران ، وقطعة أخرى لا تصلح إلا أن تكون سبخة يعلوها الملح . وذلك كله بنحو الاقتضاء لا العلية التامة ، ومن ذلك يعلم المراد من قولهم (عليهم السلام) : " كل ما هناك لا يعلم إلا بما هنا " ، أو : " إن الدنيا مزرعة الآخرة ".
وإنما أتى عز وجل الفعل مجهولا ، للإشارة إلى أن لفعل الفاعل دخلا في الإعداد ، وأضيفت الجنة إلى المتقين ، لبيان أن الوصف - وهو التقوى - علة هذا الإعداد.
ونظير هذه الآية قوله تعالى : {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران : 133] ، ولعل الاختلاف في التعبير بالمسارعة والمسابقة ، لأجل أن المسارعة تكليف للجميع من غير اختصاص بفرد ، والمسابقة تكليف فردي بأن يتسابق كل فرد فرداً آخر حين المسارعة ، فتكون المسابقة أخص من السارعة ، ويكون المراد بالجنة في آية السابقة جنة خاصة ، عرضها كعرض السماء والأرض ، فإن لله تعالى جنات كثيرة ، بل غير متناهية.
كما أن المراد بالجنة في آية المسارعة الجنس التي يكون عرضها السماوات والأرض ، ويصح أن يراد بالسماء في آية المسابقة الجنس ، فيتحد مفاد الآيتين حينئذ.
ثم إنه تعالى ذكر المتقين في المقام لغرض الأوصاف التي وصفهم بها ، وهي أوصاف جامعة لمكارم الأخلاق وهي تفيد المجتمع كما تفيد الأفراد ، أمروا بالتحلي بها لغاية تهذيبهم وتكميلهم ، وقد نزلت هذه الآيات بعد غزوة أحد ، وقد جرى على المسلمين ما جرى ، كما صدر منهم ما صدر ، فاستلزم ذلك تنبيه المؤمنين وتهذيبهم وإعدادهم لما ستجري عليهم من الحوادث.
وقد وصف عز وجل المتقين بأوصاف خمسة ، وهي:
قال تعالى : {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ} [آل عمران : 134].
السراء : من السرور ، وهو الرخاء والفضل ، والضراء من الضرر ، وهو الشدة والعسر والضيق. أي : الذين ينفقون لوجه الله تعالى في حالة الرخاء والسرور ، وحالا الشدة والضيق والعسر.
وظاهر الآية الشريفة أن السراء والضراء حالتان للمنفق ، ويحتمل أن تكونا حالتين للإنفاق في حالة الرخاء والسرور ، وحالتي الضيق والشدة ، فمن الأول الإنفاق في التوسعة على العيال ، ومن الثاني الإنفاق لرفع ما يضطرون إليه .
وإنما حذف عز وجل متعلق الإنفاق ليشمل القليل والكثير ، وكل ما يصلح للإنفاق ، سواء كان مالا أم غيره.
وقد بدأ سبحانه وتعالى من بين الأوصاف بالإنفاق مقابلة للربا الذي نهى عنه عز وجل في الآية السابقة ، الماحق لكن فضل وفضيلة ، ولأن الإنفاق في الحالتين يكشف عن محبة المنفق لله تعالى وتقواه ، لأن أنفق أحب الأشياء لنفسه. ولأن الإنفاق أنفع للناس من سائر الصفات ؛ فإن فيه يظهر التعاون بين أفراد المجتمع ، وبه ترتفع المشكلات وتنحل المعضلات ، ويخفف من هموم الفقراء ويبعث في نفوسهم الأمل ويشدهم مع سائر أفراد المجتمع.
قال تعالى : {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ} [آل عمران : 134].
وصف ثان ، ومادة (كظم) تدل على الحبس والإمساك ، ومنه الحديث : " إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع "، أي يحبه مهما أمكن ، ويقال : كظم البعير ، أي أمسك عن الجرة ، وكظم القربة شد رأسها عند الامتلاء ، والغيظ شدة الغضب وفوران الدم للانتقام.
قال تعالى : {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران : 134].
وصف ثالث ، وهو من أجل مكارم أخلاق الله تعالى ، فإن بعفوه يتم تدبير نظام العالم. ومن أسمائه تعالى العفو ، وهو المبالغة في العفو الذي هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه ، وأصله المحو والطمس ، والعفو عن الناس هو ترك مؤاخذتهم مع القدرة عليها والتجاوز عن عقوبة من استحقها ، وهو أقرب للتقوى ، وفي الحديث : " سلوا الله العفو والعافية والمعافاة " ، أما العفو فمحو الذنوب ، والعافية أن تسلم من الأسقام والبلايا وهي الصحة ، والمعافاة هي صرف أذى الناس عنك وأذاك عنهم ، ويغنيك عنهم ويغنيهم عنك.
وإنما حذف المتعلق ليشمل كل ما يدخل تحت حقه.
وهنا الوصف يكشف عن كرم المتصف به وحسن سريرته وضبط نفس الأمارة تحت إرادته وحكمته ، فتكون مرتبة هذا الوصف أعلى من مرتبة كظم الغيظ ، فإن الشخص قد يكظم غيظه ولكن على عقد وضغينة ، والعفو دليل على انتفائهما.
قال تعالى : {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134].
وصف رابع ، وهو الإحسان الذي له المرتبة الأعلى من بين جمع ما سبق ، بل هو أكرم المكارم ، ولعله لأجل ذلك لم يعطفه على ما سبق.
والإحسان : صفة كريمة تتصف بها النفس يكشف بها كظم الغيظ والعفو عن الناس ، فإن هذه نعوت معدة لكسب الإحسان والتحلي به ، والإحسان : هو جعل الأشياء في موضعها وإتيان الأعمال على الوجه اللائق بها ، وبالإحسان يتم الإنفاق الذي لا بد أن يعرى عن جميع ما يشينه ويكمل كظم الغيظ والعفو عن الناس ، ولذلك كان للمحسنين أجر عظيم ومنزلة كبيرة ، قال تعالى : {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت : 69] ، ويكفي في منزلة هذا الوصف أن الله يحب المحسنين ويثيبهم على إحسانهم ، وكفى بذلك فخراً وفوزا.
قال تعالى : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ } [آل عمران: 135].
وصف خامس ، وهو أعظم آية في القرآن الكريم في تهييج رجاء العبد ، وفيها التنويه بمقام العفو والإحسان ، وتذكر المتقين بعدم اليأس لو صدر منهم ذنب ، فإنه بعد أن ذكر أوصاف المتقين - من كظم الغيظ والعفو والإحسان - عقبه سبحانه بأعظم ما من به على العباد ، وهو العفو عن المذنبين والإحسان بهم ، تعليماً لهم وتنويهاً لمقامهما وإعلاماً بأن الإنسان لا يخلو عن الذنب إلا أن يكون معصوماً بعصمة الله تعالى ، فهو محتاج إلى العفو والإحسان ، فتكون الجملة معطوفة على المتقين ، ( وأولئك ) في الآية التالية إشارة إلى الجميع.
والفاحشة من الفحش ، وهو مجاوزة الحد في السوء ، فتكون الفاحشة كل اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ، وشاع استعماله في الزنا باعتبار أنه أظهر أفراد الفحشاء ؛ وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ، وفي الحديث : " إن الله لا يحب الفحش و التفاحش ".
والمراد بها في الآية الشريفة - بقرينة المقابلة للظلم - المعصية الفاحشة في قبحها ، سواء كانت مقتصرة على النفس ، كترك الصلاة ونحوه ، أم متعدية إلى الغير ، كالقتل والغيبة ونحوهما . والظلم ما دون ذلك ، كما يصح أن يكون الفرق بينهما كالفرق بين الكبيرة والصغيرة.
قال تعالى : {ذَكَرُوا اللَّهَ} [آل عمران : 135].
أي : تذكروا عظمة الله تعالى وآياته الموجبتين للخشية منه ، وأنه مرجعهم في كل خوف ورجاء ، بعد أن أغفلهم الشيطان وأنساهم ذكر ربهم حين الذنب ، فيسرعون إلى الاستغفار وطلب المغفرة.
والمراد بذكر الله هو الذكر الحقيقي الذي يكون داعياً إلى ترك الذنب واستشعار الخوف والرجع إليه تعالى ، لا مجرد الذكر اللفظي مع البقاء على الذنب ، فإنه حينئذ يكون كالمستهزئ به تعالى.
قال تعالى : {فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} [آل عمران : 135].
أي : حين ما ذكروا الله وتذكروا جلاله وكبرياءه أحبوا التقرب إليه بعد أن انصرف عنهم طائف الشيطان ، فتابوا إليه طالبين المغفرة منه عز وجل لجميع ذنوبهم.
والآية الشريفة في مقام التمييز بين من يفعل المعاصي محادة وعناداً ولجاجاً ، فإنه بعيد عن الاستغفار ولا يوفق إليه أبداً.
وبين من تذفر الله تعالى حين المعصية وارتدع عنها خوفاً ، فتاب إليه تعالى وطلب المغفرة منه ، فإن لهم مقاماً معلوما.
قال تعالى : { وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران : 135].
بشارة عظيمة ، وتطييب للنفوس ، وتشويق إلى التوبة والاستغفار ،
وتنبيه للمذنبين بالالتجاء إلى الله تعالى وعدم اليأس منه عز وجل ، فإنه لا منجى من الذنوب ولا ملجأ في الغفران إلا إلى الله تعالى ، وهذا منا يؤكد الفزع والرجوع إليه عز وجل.
والآية المباركة - بأسلوبها البديع وخطابها البليغ - تؤثر في المخاطبين أبلغ التأثير ، وينبه الضمير الإنساني الذي تأثر بارتكاب الذنوب والمعاصي بالرجع إلى الله والإنابة إليه ، لإزالة ما يوجب ضلاله وإغوائه.
وفي هذا الخطاب وجوه من الدلالة على المعنى المراد ، كإظهار اسم الجلالة ، وإسناد المغفرة إلى ذاته المقدسة المستجمعة لجميع الصفات الكمالية ، ودلالة ذلك على الغفران الواسع وانحصاره فيه عز وجل ، لأنه المسلط على ذلك كله ، فإن من بيده أصل الخلق وتدبير شؤونهم ، يكون ملطاً على الغفران بالأولى ، وليس لغيره هذا الحق ، وهذا ما يدل عليه الحصر المستفاد من النفي والإثبات.
وفيه الإنكار على من يطلب المغفرة من الأوثان أو الأفراد الذين لم يأذن لهم الله تعالى بالاستشفاع لديه في غفران الذنوب بالخصوص.
ويؤكد ذلك ورود الخطاب على هيئة الإنشاء دون الإخبار.
وفي ذكر الجمع المحلى باللام الدال على العموم ، إعلان بأن الله جل شأنه يغفر جميع الذنوب ، صغائرها وكبائرها ، فيكون المذنب بعد الاستغفار والتوبة عنده كمن لا ذنب له ، كما في الحديث.
ثم إن مجيء هذا الخطاب بعد ذكر الفاحشة وظلم النفس ، فيه الدلالة على سعة غفران الله تعالى وعدم مبالاته فيه ، فإن الذنوب مهما كبرت وجلت ، ولكن عفوه وغفرانه أجل وأعظم وأكبر.
قال تعالى : {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135].
الإصرار على الشيء : المداومة عليه وملازمته ، وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب ، وفي الحديث : " ويل للمصرين الذي يصرون على ما فعلوه وهم يعلمون " ، وقد تقدم اشتقاق هذه الكلمة في قوله تعالى : {كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران : 117] " وهم يعلمون " حال من فاعل الإصرار و متعلق به.
والمعنى : أنهم لم يداوموا على الذي فعلوه من الذنوب والمعاصي وهم عالمون بقبحها وبالنهي عنها والوعيد عليها.
وإنما قيد الإصرار على الفعل بالمعصية ، لبيان أن مجرد الإصرار على المعصية مع الجهل بها لا يكون إصراراً شرعاً ، كما يبينه قوله تعالى : {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ } [النساء : 17].
والآية الشريفة ترشد الناس إلى ترك الإصرار في المعاصي ، لأنه يوجب عدم المبالاة برحمات الله تعالى والاستكبار عليه والاستهانة بأحكامه المقدسة ، ويجعل النفس ميالة إلى الطغيان والخروج عن الطاعة ، فتنتفي العبودية وتخرج عن الفطرة المستقيمة ، فلا ينفع حينئذ ذكر الله تعالى الذي كان يمنع عن المعصية والإقامة على الذنب.
قال تعالى : {أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} [آل عمران: 136].
وعد منه عز وجل للمتقين الموصوفين بما تقدم من الأوصاف ، وبيان للأجر الجزيل والثواب الكبير المعن لهم ، وهو المغفرة والجنات العظيمة التي تجري من تحتها الأنهار زيادة في بهجتها ، ولتمامية النعمة أنهم خالدون فيها لا يشوبها نقص.
ويمكن أن يكون ما ورد في هذه الآية المباركة هو نفس ما ذكره عز وجل في الآية السابقة من الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض ، فتكون تلك الأوصاف من المعدات والأسباب للمغفرة والدخول في الجنة ، وتكون هذه الجنات ضمن تلك الجنة الفسيحة.
وقد أضاف سبحانه وتعالى الجزاء إلى ضمير " هم " تشريفاً ، وفي ذكر الرب المضاف إلى " هم " ، لبيان العلة في نيلهم لذلك الجزاء العظيم وتربيته تعالى المعنوية لهم.
قال تعالى : {وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} [آل عمران : 136].
تأكيد للوعد الجميل وتشويق لهم إلى العمل ، أي : تلك المغفرة والجنات إنما تكون على تلك الأعمال الحسنة التي تعد النفس إعداداً صالحاً ، وتهيئوها لنيل تلك المراتب العالية.
والخطاب على إيجازه يشتمل على وجوه من الدلالات المحسنة ، الدالة على عظمة المرضع والاهتمام به ، وتهييج الشوق والمسارعة إلى نيله.
منها : إقامة الأجر مقام الجزاء ، إعلاما بإنجاز الوعد وتحققه ، مما يزيد في شوق العامل وتنشيطه للعمل ، فكان العامل يستحق ذلك .
ومنها : ذكر الجمع المحلى باللام وإقامته مقام الضمير تأكيداً ، وللدلالة على حصول المطلوب.
ومنها : إتيان هذه الجملة بعد ذكر الجزاء وتفصيله لبيان الاهتمام بالوعد ، والتأكيد على المسارعة لدركه.
قال تعالى : {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ} [آل عمران: 137].
أمر بالاعتبار بما جرى على الأمم الغابرة والنظر في ما بقي من آثارهم ، زيادة في التحريض على العمل والاستعداد لنيل الكمال ، وتشويقاً للجزاء الذي أعده الله تعالى للعاملين ، وتنبيها للمؤمنين على عدم الغفلة ، وتذكيراً لمن خالف الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) ، وتسلية للمؤمنين ، وتوبيخا لمن أعرض عن آيات الله تعالى وأحكامه المقدسة وغفل عن الاستكمال ، وتشنيعاً على من أدرج نفسه في عداد المكذبين بعد إتمام الحجة ، التي يكون منها الرجوع إلى أحوال الماضين والسير في الأرض والنظر في ما خلفته تلك الأمم من الآثار ، فقد خلت عن أصحابها بعدما كانت قصوراً شاهقة أو عروشاً جمعت كل أسباب البهجة والسرور، وقد ابتهج ساكنوها وعمارها مدة فيها ، أو كنوزاً امتلأت بكل أسباب العيش الهنيء ، أو ذخائر عظيمة لم تدخل في الحسبان ، وقد جرت عادته عز وجل أنه يرجع المخاطبين - بعد سرد جملة من الحوادث وبيان الأحكام الفردية والاجتماعية - إلى سنن الأمم الغابرة ، والأمر بالاعتبار بها والنظر في آثارهم لمزيد التنبيه ، والاستفادة من تجاربهم ولئلا تتكرر ما جرى عليهم على هذه الأمة ، وأن يلكوا الطريق المستقيم الذي سلكه الصالحون منهم ، والإعراض عن سبل المكذبين لئلا يدخلوا في زمرتهم فينالوا جزاءهم ، وقد جعل القرآن الكريم هذا الأمر من سبل إتمام الحجة على العباد.
وخلت بمعنى مضت ، والسنن جمع سنة ، وهي الطريق المعبدة الملوكة ، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في ما يقرب من سبعة عشر موضعاً ، قال تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ } [الأنفال: 38] ، وقال تعالى : {وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} [الحجر : 13].
والنظر في سنن الماضين من سبل الرشاد ، وفيها وجوه من الحكمة ، منها الاعتبار بها ، وإتمام الحجة على اللاحقين ، وتسلية لما يجري عليهم ، والاستفادة من تجاربهم وغير ذلك ، ولذا اهتم بها عز وجل فذكرها في مواضع متعددة.
وبالجملة : فهو إرشاد إلهي.
والمراد بها في المقام منهاج الماضين وما جرى عليهم ، سواء كان سنة المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله تعالى والعاملين المستعدين للقائه والدار الآخرة ، وما كابدوا من عتاة زمانهم وجبابرتهم وصعوبة العيش ، فرضوا بما قسمه الله لهم وصبروا وآثروا الآخرة على الحياة الدنيا الفانية ، وسنة الكاذبين الكافرين الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ونعيمها ، لانهماكهم في الضلال والشهوات مع وضوح الحجة ومعرفة البينات ، والأمر بالسير في الأرض لزيادة الاعتبار من آثار الماضين والتبصر منها ، ويدخل في السير في الأرض السير في حالات أهل الأرض من خلال التأريخ والحوادث الواقعة فيهم.
قال تعالى : {فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [آل عمران : 137].
المراد بالنظر هو التأمل والتبصر بأنه كيف كان علاقة المكذبين مع المؤمنين، وما جرى من الصرع بين الحق والباطل، وما آل أمر المؤمنين إليه ، وعاقبة أمر المكذبين وما حل بهم من العذاب والهلاك بسوء أعمالهم ، فإن النظر في ذلك كله يزيد المعرفة ويوجب التسلية بما يجري على المؤمنين ، ويفيد العظة والاعتبار ، والتوبيخ للمكذبين الكافرين.
قال تعالى : {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران : 138]. الإشارة راجعة إلى ما ورد في الآيات السابقة من ذكر غزوة احد والمضامين العالية التي احتوتها تلك الآيات ، والتقسيم باعتبار حالات الناس ومدى تأثرهم بالقرآن الكريم ، فبعضهم يكون القرآن بالنسبة إليه بلاغاً وبياناً ، والبعض الآخر يكون هدى وموصلا له إلى الهداية وموعظة تدعوه إلى الاتعاظ والاعتبار وزيادة الإيمان وثباته ، كل ذلك لا بد أن يكون للذين أعدوا أنفسهم لقبول الهداية والاتعاظ ، وهم المتقون الذين يتأثرون بالبيان وينتفعون منه ويهتدون بهداه ويتعظون بمواعظه دون سواهم.
 الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












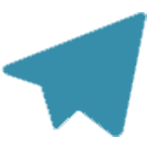
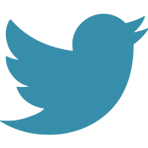

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)