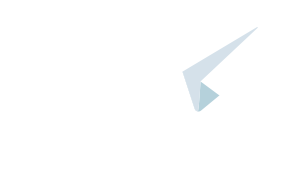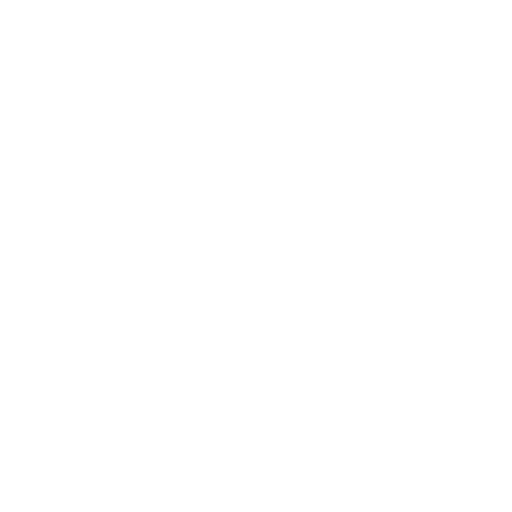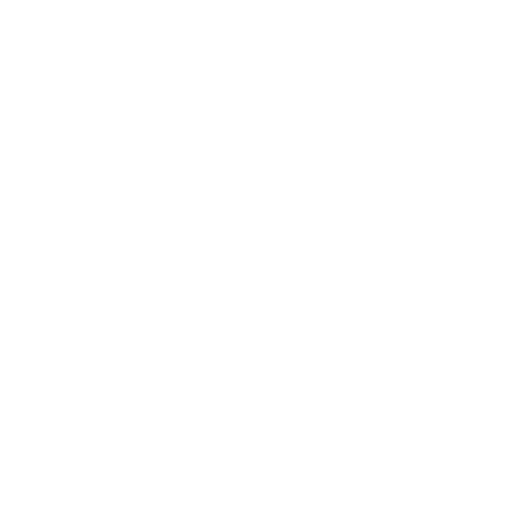الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
آفاق الإصلاح للتعليم الجامعي
المؤلف:
أ. د. عبد الكريم بكَار
المصدر:
حول التربية والتعليم
الجزء والصفحة:
ص 257 ــ 269
2025-07-22
18
لا نستطيع هنا أن نتناول كل الجوانب والمسائل التي نرى أنها بحاجة إلى معالجات جادة وحاسمة؛ لذا فسنحاول تسليط الضوء على ما نراه ملحاً منها، وذلك على النحو التالي:
ـ نفقات التعليم الجامعي:
لا يغيب عن بالنا أن التعليم الجامعي بكل فروعه وجوانبه وقضاياه هو جزء من كل، بل إنه كثيراً ما يشكل (مرآة) تعكس الوضعية العامة للمجتمع بكل دقة، ولذا فإن من غير المتوقع أن تستطيع الشعوب الفقيرة جدا أن تشيد جامعات ممتازة، حيث إن ذلك مكلف جدا اليوم، والمال الذي يحتاجه مطلوب لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم الأساسي ومشروعات البنية الأساسية، وقبل ذلك رغيف الخبز!
سيكون من الخطأ البالغ أن تعتقد أن المال سيحل كل المشكلات كما سيكون من غير الصواب أيضاً الاعتقاد أن القصور المالي والاقتصادي لدى شعوب العالم، معزول عن قصورها التربوي والسياسي والاجتماعي. وهذا يعني أن النهوض بالتعليم الجامعي، سيحتاج إلى (حلول مركبة) ليس المال سوى جزء منها.
إن الدول النامية مبتلاة بشهية لا حدود لها لتكديس السلاح، وتفيد بعض الإحصاءات أن البلدان الـ (46) الأقل نمواً في العالم تنفق على بناء قدراتها العسكرية ما يعادل نفقاتها على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين (1). وهذا يدل على أن الموارد الشحيحة جدا تلقى أعلى درجات الهدر وسوء الإدارة!.
التعليم الجامعي - بطبيعته - عالي التكاليف، وبعض الدراسات يفيد أن تكاليفه تصل إلى نحو من سبعة عشر ضعفاً من تكاليف التعليم الابتدائي (2). ومع هذا فإن انخفاض الناتج الوطني لمعظم الدول الإسلامية، جعل أكثر ما ينفق على التعليم الجامعي، لا يذهب إلى مراكز البحوث أو التجهيزات والوسائل التقنية، وإنما إلى أجور المدرسين مما جعل ما يفيض الخدمة البحث العلمي والتدريب محدوداً جدا، قد لا يصل في بعض الأحيان إلى 10 %. وعلى كل حال فإن ما ينفق على (الطالب الجامعي) في معظم الجامعات في العالم الإسلامي، محدود جدا إذا ما قورن بما يتم إنفاقه في دول أخرى، بسبب ضعف التجهيزات وقلة ما ينفق على البحوث والخدمات المساندة.
أفق متاح:
لا نعتقد أن بين أيدينا حلولاً جذرية لمشكلة كبرى مثل مشكلة (تمويل التعليم الجامعي)؛ فمن السهل اليوم أن يخرج من دائرة الاهتمام، ليبدو وكأنه قطاع ترفي أو ثانوي، وذلك بسبب انخفاض أدائه وشيوع البطالة بين خريجيه؛ مما يشجع على صرف الأموال إلى قطاعات أخرى تبدو أكثر أهمية للحياة العامة.
وفي الحقيقة فإن حيوية التعليم الجامعي وأهميته لا تبدو واضحة إلا إذا وضعناه في سياق من منظومة تنموية وحضارية جديدة.
في بعض الدول أثبت التعليم الجامعي أنه أقدر المراحل التعليمية على جمع الأموال والتبرعات لدعم برامجه ومشروعاته التعليمية والبحثية (3).
ويمكن لنا أن نحسن من موارد التعليم الجامعي - إن أردنا ـ من خلال عدد من التشريعات والتنظيمات والأنشطة، وتذكر منها على سبيل التمثيل الآتي:
1- من الواضح أن الحكومات لن تستطيع في المستقبل أن تقوم وحدها بتغطية نفقات التعليم الجامعي في ظل اتساعه والإقبال عليه وارتفاع تكاليفه، ولذا فلا بد من مساهمة الناس فيه. ولأمة الإسلام سجل رائع في هذا الباب، فقد كان من المألوف أن ينفق أهل الحي أو أهل القرية على طلاب الحلقات العلمية التي كان يقيمها كبار العلماء، وكان الإمساك عن الإنفاق في ذلك يعد أمراً مستغرباً، كما أن كثيراً من الأثرياء كانوا يسهمون في تفريغ كثير من العلماء للتعليم ونشر المعرفة، ومشاركة الأهالي كانت السبب في الحركة العلمية الهائلة في تاريخنا، وهي اليوم السبب في الحركة العلمية النشطة في العالم المتقدم كله إن الجامعات الأمريكية تجتذب أفضل الكفاءات العلمية اليوم في العالم؛ لأن كثيراً من الأسر الثرية هناك تملك الرغبة في إنفاق المال، وكثير من الجامعات الكبرى قامت ـ ولا زالت - على تبرعات بعض الأثرياء وأمة الإسلام أولى بذلك، وأعتقد أن الوعي الإسلامي في حالة من السبات تجاه الاهتمام بالثقافة والمعرفة، ولكنه إذا اوقظ فانه يستيقظ، وسيكون هناك خير عظيم!.
إن على الجامعات أن تنشط في كل سبيل لجمع الأموال، وعلى الوسائل الإعلامية أن تساعدها على ذلك؛ وهناك أبواب كثيرة في هذا الشأن، ومن تلك الأبواب أن تقوم الجامعات بإحداث كليات وأقسام و(كراسي) علمية وتدريسية بأسماء بعض الأسر أو الأفراد، ممن يسهمون في تمويل أنشطتها وهذا موجود لكنه ضعيف جدا، وربما كانت البداية في السعي إلى إيجاد تشريعات تسمح لها بالقيام بذلك. ثم إن عليها بعد ذلك أن تحدث من الأطر والبرامج ما يسمح باستيعاب كل أحجام التبرعات مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ثم الاتصال بالأثرياء وأولياء الأمور لمساعدتها عن طريق الهبات أو الوقف أو الوصايا أو إقامة المباني وتجهيزها .....
إذا كنا غير قادرين على التعلم من مبادئنا أو تاريخنا، فإننا نستطيع أخذ الخبرة من الآخرين الذين يعيشون بيننا، ففي فلسطين المحتلة يدهش المرء من كثرة ما يلاحظه من الجهات غير الرسمية التي تسهم في تشييد المؤسسات التعليمية وتمويلها والإشراف عليها وإداراتها؛ فالأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات المختلفة، تساعد بفعالية في دفع الحركة التعليمية ورعايتها وتقديم الخدمات لها (4).
2- حين تخير أي دولة بين توجيه مواردها المالية المحدودة إلى التعليم الأساسي وبين توجيهها إلى التعليم العالي، فإنها ولا شك ستختار إيثار توجيهها إلى التعليم الأساسي، لكن يمكن للجامعات أن تعوض النقص من خلال إجراء البحوث والدراسات والاستشارات للشركات والمؤسسات والمصانع، ويمكنها أن تسعى إلى تسويق منتجاتها البحثية، والمساهمة في التدريب والخدمات الاجتماعية المختلفة وتأمين بعض الموارد من وراء ذلك؛ لكن النجاح في هذا يحتاج إلى أن يكون هناك - على المستوى العام ـ توجه إلى الصناعة والإنتاج المحلي بدل (التجارة). وإن من المؤسف أن تجد دولاً إسلامية كثيرة، فيها أحدث المعدات الطبية، لكن ليس فيها مختبر أبحاث واحد، أو مصنع واحد للآلات والتجهيزات الطبية!!
إن الجامعات لن تجد أي مكان لأبحاثها في المطاعم أو محلات الأزياء أو المتاجر الكبرى، ولذا فإنه لا بد من قيام صناعات تعتمد على البحث المحلي، ولو كانت صناعات غير متقدمة؛ وكل أحوال جامعات الدنيا تؤكد هذه الحقيقة، فهل نستوعب الدرس؟
3- يبدو أنه لا بد في النهاية من فرض بعض الرسوم على التعليم الجامعي، فتقديمه على نحو مجاني في كثير من الدول أدى إلى أن يلجه كل من لا يجد له في سوق العمل موضعاً، كما أدى إلى ما ذكرناه من انحطاط مستواه نتيجة انخفاض مستوى المتقدمين إليه، ونتيجة عجزه عن تقديم خدمات وبرامج جيدة. ويمكن أن تكون الرسوم على نحو تصاعدي كلما ارتقت الكلية، وكلما طالت مدة الدراسة فيها على ما هو موجود في كثير من الدول، لكن علينا أن نلاحظ أمرين:
الأول: هو ألا تؤدي تلك الرسوم إلى انخفاض الأعداد المطلوبة من المثقفين الذين نحتاجهم فعلاً في تثقيف المجتمع وهدايته، وتقديم الخدمات العلمية له.
الثاني: ألا يؤدي ذلك إلى تمايز طبقي واسع؛ فيحرم بعض الجادين والمتميزين من التعليم الجامعي؛ لأنهم فقراء، ويتاح لغيرهم بسب قدرة أهليهم على الدفع ولتلافي هذا فإن بالإمكان وضع برامج واسعة، تقدم منحاً للطلاب المتفوقين، ولأبناء الفقراء، ويمكن لتلك البرامج أن تغطى من قبل بعض الهيئات والمنظمات الخيرية، كما يمكن أن تغطى من قبل بعض الوزارات والهيئات الحكومية في تركيا - مثلاً - رابطة تجمع بين الآباء والمعلمين وتقوم تلك الرابطة بالمساهمة في تقديم المساعدة للطلاب
المحتاجين إلى جانب دعم ميزانيات المباني التعليمية (5).
وبعد هذا وذاك فإن على الجامعات أن تستفيد من مبانيها وتجهيزاتها الموجودة على نحو أفضل مما هو موجود الآن من أجل تخفيض التكلفة دون أن يؤثر على مستوى التعليم.
بطالة المثقفين:
إن معايير البطالة في العالم الغربي، تختلف عن معايير البطالة في الدول النامية، كما أنه ليس لدى هذه الأخيرة تقارير أو إحصاءات دقيقة حول العاطلين عن العمل، حيث لا تصرف لهم معونات خاصة، ومن ثم فإنه ليس هناك - في الغالب - جهة تتولى القيام بالمسوحات التي تبلور حالة البطالة، ومع هذا فإن هناك ما يشبه الإجماع على أن نسب العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات آخذة بالازدياد في معظم الدول النامية، وإلى جانب هذا هناك قناعات بأن نسبة كبيرة من المتخرجين حديثاً من التعليم الثانوي والجامعي، والذين قد تم استخدامهم، قد قبلوا وظائف تعد حسب المعايير التي كانت سابقاً، أقل من مؤهلاتهم التعليمية (6).
كان الناس حين يرون بطالة طلاب الثانوي، يطالبون بزيادة فرص التعليم العالي، إلى أن صار خريجو الجامعات لا يجدون عملاً واليوم على من يريد أن يجد عملاً ملائماً أن يدرس (الماجستير) و(الدكتوراة) وإذا ظل الأمر على هذه الحال، فلا أدري بعد عشر سنوات ما الشهادة التي على حاملي (الدكتوراة) أن ينالوها حتى يجدوا عملاً يرتزقون منه؟!
تذكر بعض الدراسات المسحية في مصر أن حجم بطالة المتعلمين فيها ممن لم يسبق لهم العمل يصل إلى أكثر من مليون ونصف مواطن، وهو ما يمثل حوالي 90% من حجم البطالة فيها (7).
إن سبب تزايد البطالة في صفوف المتعلمين يعود إلى التوسع المذهل في التعليم في كثير من البلدان النامية، مما جعل معدل عدد الخريجين سنوياً يزيد على معدل فرص العمل المتاحة. التعليم لا يؤدي إلى البطالة، وإنما يغير نوعيتها، حين يحول العاطلين غير المتعلمين إلى عاطلين متعلمين، وبهذا المعنى كثيراً ما يكون التعليم وسيلة لتأجيل البطالة. بل إن بعضهم عرف التعليم العالي بأنه السبيل لتأجيل البطالة عدداً من السنوات (8)!.
مؤشرات المستقبل:
لا ندري على وجه التحديد الوضعية التي سيصير إليها الخريجون من الآن فصاعداً؛ لأن ذلك يتوقف على حجم الأعداد التي ستقذفها الجامعات والمعاهد العليا، كما يتوقف على حركة النمو الاقتصادي، ومدى قدرتها على الاستيعاب؛ لكن هذا لا يحرمنا من رؤية بعض المؤشرات العامة في هذه المسألة.
تقدر بعض الدراسات أن فئة الكبار الأقل سناً في القوى العاملة (سن 18 - 23 سنة)، سوف تشهد انكماشاً في العالم المتقدم بنسبة تزيد على 10% وذلك بين عامي (1980 - 2000) على حين تزيد الفئة نفسها في الأقاليم الأقل نمواً بنسبة تزيد على 40% ومن ثم فإن مشكلة إتاحة وظائف جديدة لهذه الفئة العمرية، سوف تنفرج على نحو ما في الشمال على حين أنها سوف تتعقد كثيراً في الجنوب (9).
إن التعليم الجامعي سيظل يتسع وستظل نسبة المتخرجين فيه إلى مجموع السكان في حالة من الارتفاع الدائم خلال السنوات العشر القادمة ـ على الأقل - فكيف يمكن التخفيف من وطأة بطالة الجامعيين؟
في البداية علينا ألا نتوقع أن الدول المتقدمة، سوف تساعدنا في إيجاد وظائف لأبنائنا، بل إن علينا أن نتوقع العكس، فاتفاقية (الجات) تقضي بفتح الطرق والأبواب أمام فوائض الدول الصناعية من منتجات ومعلومات وخبرات وأموال على حين أرتجت الأبواب أمام فائض العالم النامي: (العمالة)!!
في اعتقادي أن بإمكاننا أن نفعل أشياء كثيرة للحيلولة دون تكدس الباحثين عن وظيفة من خريجي الجامعات، منها:
1- على الجهات المسؤولة عن التوظيف الحكومي بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية وروابط المثقفين أن تبصر الناشئة بالحاجات الحقيقية لسوق العمل، كما ينبغي أن ينشأ نوع من التعاون الحي بين الجامعات وهذه الجهات؛ فتقلص الجامعات من القبول في الأقسام التي لا يحتاج المجتمع إلى خريجيها، وتوسع القبول، وتطور البرامج في الأقسام التي عليها طلب وذلك من أجل المواءمة بين ما توفره الجامعات، وما يحتاجه سوق العمل. وأعتقد أن إيجاد (بنك) معلومات حول هذا الموضوع سيكون ضرورياً لنشر ثقافة جيدة حول العمل والبطالة.
2- فك الارتباط بين الشهادة والوظيفة؛ فهناك تضخم هائل في جميع أجهزة التوظيف، في كثير من البلدان، فالدراسة والشهادة لتهذيب النفس، وتحسين الفهم، وزيادة الخبرة الحياتية، وهي بعد ذلك تساعد على العثور على عمل، وقد لا تساعد وتاريخنا الإسلامي مملوء بالنماذج العلمية الرفيعة التي لم تكن ترتزق من وراء التعليم أو المعرفة أو المهن العلمية بل يمكن القول: إن الربط بين العلم والوظائف، قد أدى إلى إضفاء الصبغة التجارية على أكثر أنشطة التعلم، وأدى بالتالي إلى انحطاطها!
إن فك الارتباط بين الشهادة والوظيفة سيجعل الطلاب أكثر دأباً وحرصاً على متابعة سوق العمل، واتجاهات العرض والطلب فيها، وعلى اختیار تخصصاتهم بعناية والتهيؤ الدائم إلى العودة إلى مقاعد الدراسة من أجل اكتساب خبرات جديدة والتدرب على المهن التي يحتاجها الاقتصاد الوطني (10).
3- من التقاليد المحمودة في بعض البلدان - دمشق مثلاً - أن يتعلم الناشئ في إجازة الصيف مهنة أو حرفة، أو يكتسب خبرة في ميدان تجاري أو خدمي، مما يجعل الشاب يتعرف على واقع الحياة واتجاهات السوق في وقت مبكر جداً؛ مما يساعده على الحصول على عمل في حالة كساد تخصصه العلمي الذي تلقاه في الجامعات. وهذه مسؤولية تقع على الأسر أولاً، كما أنه بإمكان الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية المختلفة أن تقيم البرامج والدورات المسائية القصيرة التي يتعلم فيها الأشبال والشباب بعض المهن في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والحاسب الآلي وغير ذلك مما يحتاجه سوق العمل.
في بريطانيا - مثلاً - تقوم بعض الجامعات بإعداد برامج خاصة للعاطلين عن العمل والشباب الذين أكملوا الفترة الإلزامية من التعليم العام وذلك لتزويدهم بالمهارات الكافية للبدء في أعمال حرة، وكذا فتح أقسام خاصة للكبار وفصول للمسجونين (11).
في ظل بطالة المتعلمين أسدى فلاح من (زامبيا) نصيحة لابنه قال فيها: (إذا لم تستطع الحصول على عمل عليك أن تحمل فأسك، وتحاول استنبات شيء تأكله. خذ تلك الفأس، وشيد مسكنك تستطيع أن تفعل شيئاً آخر إذا كان لديك القوة أن تضع خلية نحل على فرع شجيرة تحصل على بعض العسل، سوف يساعدك ذلك. وهكذا نعيش نحن كبار السن. وإذا ظللت على ما أنت عليه (طامعاً في وظيفة) كيف ستعيش إذن)؟؟ (12).
4- إن إيجاد فرص العمل لهذه العشرات من الملايين التي تدفع بها الأرحام سنوياً، ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل، فالبطالة، لا تسبب شحاً في الموارد الشخصية للعاطلين فحسب، وإنما تسبب لهم ارتكاسات نفسية واجتماعية خطيرة والمسؤولية يجب أن تكون عامة، لكن الخلاص من هذه المشكلة، أو كسر حدتها، يحتاج إلى قرارات جذرية في تغيير (بنية الاقتصاد) ومفاهيم العمل والاستهلاك، إلى جانب الاستفادة من أوقات الفراغ، والاستفادة من خبرات الأمم الأخرى في معالجة هذه المسألة.
إن الشباب بحاجة إلى من يرشدهم، ويساعدهم، وينبغي أن يكون هناك هيئات عديدة لدعم (المشروعات الصغيرة) التي يمكن أن ينفذها، كما ينبغي على الحكومات أن تتجه إلى إحلال (التقنيات المتوسطة) (13) محل التقنيات العالية (الأتمة) حتى يمكن استيعاب أعداد كبيرة من الشباب في المصانع والشركات وتوفير الكثير من المال الذي يدفع في شراء المعدات البالغة التطور.
على الشباب بعد هذا وذاك أن يعلم جيداً أنه إذا لم يساعد نفسه، فلن يساعده أحد.
تجاوز الذات:
إن الجمود وضعف القدرة على التكيف في المؤسسات التعليمية - على درجات متفاوتة - يمثل ظاهرة عالمية، وإن المستغرب ألا تستجيب الجامعات للتغييرات التي تقوم هي بإحداثها!
إن أمام جامعاتنا تحديات كثيرة، من أهمها العمل على حماية نفسها من مرض (تصلب الشرايين)، وذلك من خلال التأكد من القيام بوظائفها على النحو المطلوب، والتأكد من أنها تحقق الأهداف التي شيدت من أجلها على نحو جيد.
أعتقد أن علينا أن نحدث تغييرات كثيرة في أوضاع تعليمنا العالي، قد لا يتسع المقام هنا للتفصيل فيها، فلنتحدث عن أمرين أرى أن لهما أهمية خاصة هما:
1- إن مرض القطرية الذي أصاب كثيراً من البلدان العربية والإسلامية، قد انعكس على كل جوانب حياتها ومع اعترافنا بالخصوصيات المختلفة لكل دولة، إلا أن الخصوصية حين تعني إضعاف التعاون فيما يعود بالنفع على الجميع، فإنها تتحول إلى مرض، وإلى ضعف وارتباك وانغلاق. وهذا ما يحدث لكثير من جامعاتنا فلدينا اليوم العشرات من كليات الطب والهندسة والعلوم والمئات من أقسام اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس ... لكن السمة المشتركة بين السواد الأعظم منها هو (الضعف) على المستوى البحثي وعلى المستوى التعليمي، والسبب في ذلك هو قلة الموارد وانعدام النماذج الراقية التي يمكن أن تقتدي بها الجامعات والكليات الضعيفة.
الإمكانات المتاحة، قد لا تساعد على إحداث نقلة نوعية للارتقاء بها؛ ولذا فإنه قد يكون من المداخل المهمة للارتقاء بها، وتطويرها بما يتناسب مع التغيرات السريعة - إيجاد جامعات ومعاهد ومراكز بحوث إقليمية على أعلى المستويات، تكون مهمتها الأساسية ليست تخريج (موظفين) ولا مدرسين، وإنما إيجاد مناخ علمي وإنتاج بحوث رائدة، وتكوين مرجعيات عالية المستوى في فروع العلم كافة، وبذلك تحد من الابتعاث، ونوطن (المعرفة المتقدمة) في بلاد المسلمين إننا نريد جامعات فائقة، تشكل نماذج راقية، لما يمكن أن تفعله الجامعات الأخرى، وهذا لن يتم إلا من خلال التخصص والتعاون.
بالإمكان لكل دولة إسلامية في قطر من الأقطار أن تحتضن جامعة من تلك الجامعات أو مركزاً من المراكز الكبرى للبحوث، جامعة في دولة للعلوم الطبية، وجامعة في دولة للعلوم الهندسية، وجامعة في ثالثة لعلوم الكيمياء، وجامعة في دولة رابعة للفيزياء النووية والنظائر المشعة، وجامعة في دولة خامسة للمواد الجديدة، وجامعة في دولة سادسة للدراسات الشرعية، وأخرى للدراسات الإنسانية وهكذا ...
ويمكن لهذه الجامعات أن تتقاضى رسوماً مالية مقابل ما تقدمه من معرفة فائقة؛ لأنها حينئذ سوف تجتذب كل أولئك الذين يدفعون الأموال الطائلة في جامعات أمريكا وأوربا. ويمكن أن يشكل لكل جامعة مجلس أمناء من كبار العلماء من أجل رسم سياساتها، والمحافظة على مستويات عالية لأدائها.
العلماء موجودون والطلاب موجودون، والأموال وخبرات التنظيم موجودة، وبقي شيء واحد هو المبادرة والإرادة، فهل تتجاوز العقبة؟
2- ما دامت المهن وفرص العمل قد ارتبطت إلى حد بعيد بالتعليم التقني والعالي، وما دام العيش في الحياة بكفاءة وفاعلية ارتبط بمقدار جيد من المعلومات يجب أن يحصل عليه الفرد - فإن من واجب كل القادرين توفير أكبر عدد من الأطر التي تساعد الشباب على طلب العلم والتسلح به، وإن كثرة ما أتيح من وسائل الاتصال، ووسائط نقل المعرفة، قد سهلت وقربت أشكالاً من التعلم، كانت تعد قبل ثلاثين سنة مما يفوق التصور والخيال!
كانت (بريطانيا) سباقة إلى إنشاء (جامعة مفتوحة) عام 1971، وذلك لإتاحة فرصة التعلم لأولئك الذين حرموا من المعرفة بشكلها التقليدي. ويسجل في هذه الجامعة سنوياً أكثر من 75 ألف طالب، ويقوم الطلاب بالدراسة عن طريق كتب مقررة ترسل إليهم بالبريد، وكذلك بعض الواجبات التي يكلفون بها، بالإضافة إلى قدر يسير من البرامج التلفازية والإذاعية (14).
وعلى خطى هذه الجامعة أسست جامعة محمد إقبال في الباكستان وذلك عام 1974، وتقدم هذه الجامعة الآن 114 مادة، ويدرس فيها قرابة مئة ألف طالب (15).
إن الحاجة تزداد يوماً بعد يوم لتوفير كل أشكال التعلم عن بعد دون أن ينتقل الطالب، ودون أن يتفرغ، ولا سيما أن شبكات نقل المعلومات تتكفل اليوم بإيصال المعلومات للراغبين في ذلك في أي مكان كانوا في الأرض.
إن على كل جامعة من جامعاتنا اليوم أن توجد إطاراً يتيح لبعض الطلاب أن يتعلموا عن طريق الانتساب والدراسة بالمراسلة، وستستطيع الجامعات أن تحصل من وراء ذلك على أموال كثيرة، تساعدها على النهوض بمهامها الجليلة. والله المستعان.
إضاءة: إن أفق الغريزة لا يلامس المهارات الراقية والمعقدة؛ ولذا فإنه لا بد من التعلم والتدريب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مجلة المعرفة: العدد (21)، ص: 50.
2ـ المصدر السابق.
3ـ أزمة العالم في التعليم: 198.
4ـ مجلة المعرفة العدد (19): 70.
5ـ نظام التعليم في تركيا: 119.
6ـ ازمة العالم في التعليم: 257.
7ـ التعليم وتحديات القرن (21): 262.
8ـ التربية في البلاد العربية: 179.
9ـ أزمة العالم في التعليم: 263.
10ـ التربية العربية: 77.
11ـ أنظمة التعليم وتحديات العصر: 89.
12ـ أزمة التعليم في العالم: 238.
13ـ أنظر ان شئت كتابنا، (مدخل الى التنمية المتكاملة) فقد فصلنا هذا الامر فيه.
14ـ التعليم والتعلم في الجامعات: 15، 16.
15ـ انظر معلومات أوفى عنها في: (الجامعات الإسلامية)، 339 وما بعدها.
 الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











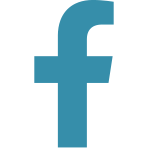
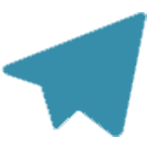
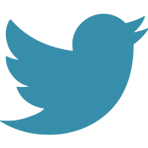

 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)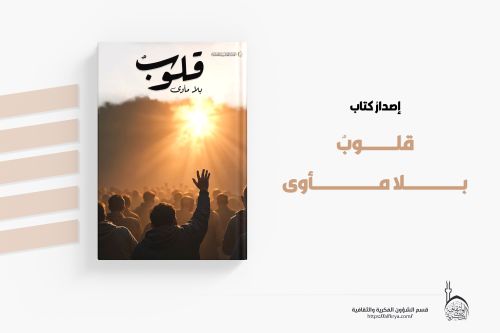 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)