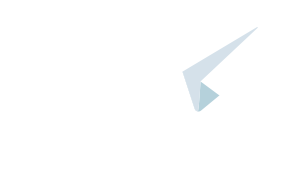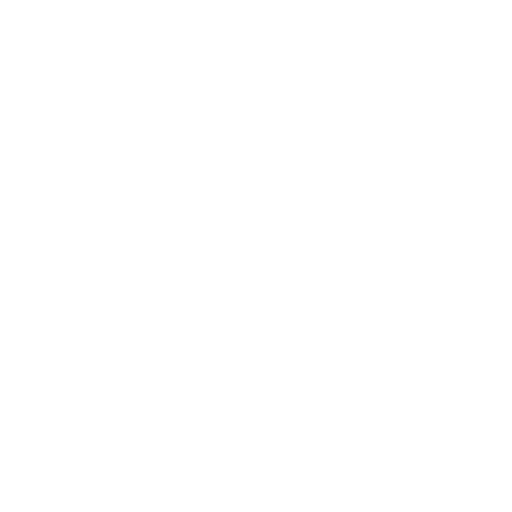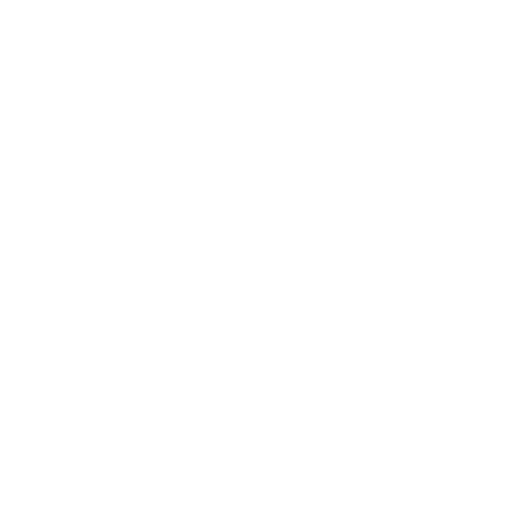الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
وسائل التعلم المستمر
المؤلف:
أ. د. عبد الكريم بكَار
المصدر:
حول التربية والتعليم
الجزء والصفحة:
ص 145 ــ 152
2025-07-22
17
إن انتشار الأمية في كثير من الشعوب الإسلامية، يحرمها من دور فاعل للأسرة في تأسيس الشغف بالمعرفة، وحب التنمية الذاتية، بل إن هناك الكثير من الأسر التي تعرف القراءة والكتابة، لكنها لا تلقى بالا لمتابعة دراسة أبنائها ورقيهم العلمي؛ لذا فلا بد من توفير أطر أخرى لذلك، إلى جانب توعية الآباء بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم في هذه المسألة المهمة.
وإليك أهم الوسائل التي يمكن أن تفيد في تعزيز التعلم الذاتي، وذلك من خلال الآتي:
1- المدرسة - بحكم التخصص والخبرة - هي التي ينبغي أن تتحمل القسط الأوفى في بذر حب المعرفة والمداومة على العلم في نفس الطفل. وتستطيع القيام بذلك من خلال أساليب التدريس ومن خلال الأنشطة (اللاصفية) والأجواء العامة السائدة فيها؛ لكن الملاحظ أن بعض المدرسين يشفق على الطلاب الصغار من بذل الجهد في التعلم، إلى جانب شيء من عدم الثقة في قدراتهم، مما قتل روح المبادرة لدى كثير من الطلاب وجعل دورهم هامشياً في عملية التعلم، كما زرع فيهم روح الاتكالية والسلبية والاعتماد على غيرهم؛ ولذا فإن هناك دعوات عديدة للمدارس كيما تنتهج أسلوباً جديداً في تعليم الأطفال، يقوم على تدعيم (التعلم الذاتي) لدى المتعلم، وتربيته على أن يربي، ويعلم نفسه بنفسه مدى الحياة، وذلك من خلال تنمية معرفته بجمع المعلومات، وتطوير قدراته (1)، وإيجاد الدافعية والاتجاهات الإيجابية لديه نحو المعرفة. وهذا كله لن يتم إلا من خلال تكثيف الواجبات المدرسية، وتعويد الطلاب إجراء التجارب وكتابة البحوث والرجوع إلى المراجع، وتشجيعهم على أن يبدوا وجهات نظرهم - ولو كانت فجة - في كل ما يقرؤونه ويسمعونه.
2- إن التعلم المستمر يعتمد اعتماداً كبيراً على الجهود الذاتية؛ إذ من العسير أن يجد المرء في كل وقت مؤسسة أو جهة، تقدم له برنامجاً، أو تدريباً، يحتاج إليه في مجال من المجالات، وإن من أهم الوسائل التي كثيراً ما يتاح استخدامها في التعليم الذاتي القراءة والملاحظة والتأمل والحوار ونجد في هذا السياق أن أكثر القراء، لا يقرؤون من أجل هدف محدد، ولا في مجال بعينه، كما أنهم لا يقرؤون قراءة مركزة، فلا يكتبون المعلومات التي يرون أنها مهمة وربما كان كثير منهم يقرؤون بهدف التسلية وملء الفراغ؛ مما يجعل أثر ما يطالعون في تنمية معارفهم، وتوسيع قاعدة الفهم لديهم محدوداً، بل ربما أدت القراءة لبعض ما ينشر إلى تشويه الرؤية، وحرف القارئ عن الوجهة الصحيحة!
إن القراءة المثمرة هي تلك التي يمارسها صاحبها بقصد الإضافة إلى المعرفة، أي التأليف أو النقد؛ ولذا فربما كان الكتّاب هم أكثر الناس استفادة مما يقرؤون.
إن هناك نقصاً آخر في عملية القراءة لدى كثير منا، هو عدم التأمل والتفكير فيما يقرؤونه، والحقيقة أن ما نسمعه ونقرؤه، لا يصبح ملكاً لنا إلا من خلال التفكير فيه؛ فبالتفكير وحده يمكن أن نصطفي مما قرأنا ما يدعم رؤيتنا المعرفية، أو يعدلها، أو يضيف إليها.
ولذا فإن على المرء إذا قرأ ساعة أن يتأمل - على الأقل - نصف ساعة فيما قرأه، إذا ما كان يريد تعزيز ذاتيته الفكرية والمعرفية.
إن الحوار هو الآخر، مصدر من أهم مصادر التثقيف الذاتي. إن الأفكار في لحظة إنتاجها أو استقبالها يكون لها وهج ورهبة، والمضي معها على نحو ساذج، سوف يحرمها من الاكتمال، وحين تتداولها حلقات المناظرة، تكون قد وضعت موضع التمحيص على محكات الجدل، وذاك هو طريق نضجها واكتمالها. آنذاك يكون المتحاورون أكثر من غيرهم استفادة منها بالحوار وحده تتمكن من رؤية القضية الواحدة من زوايا مختلفة وبذلك يتم التخلص من الرؤى النصفية والمبتسرة، وذلك باب عظيم من أبواب الفهم العميق!
إن الأشياء القابلة للحوار أكثر من أن تحصى، وإن تنشيط سوق المناظرة والمحاورة، هو من مسؤولية المدارس والجامعات والنوادي والجماعات والأحزاب وحين تقوم هذه الجهات ببعض مسؤولياتها في هذه المسألة، فإنه سوف يتشكل لدينا جو مفعم بالمثاقفة والتعلم؛ حيث يتعاظم الوعي، وتضاء الزوايا المعرفية المظلمة.
إن ضعف الحوار ضيع الكثير من الأمور، وجعل إحساس الكتاب والمفكرين بما يقولونه، ويكتبونه ضعيفاً، والأخطر من هذا أن أصحاب كل تخصص صاروا يشكلون جزيرة ثقافية منعزلة؛ مما حرم المجتمع من الاستفادة منهم، وأدى بالتالي إلى ضمور عام في المعرفة السائدة.
3- لم يعد في ظل التطور المعرفي السريع بإمكان أي جهة تعليمية أن تقدم كل ما يحتاج إليه من معارف ومهارات في أي تخصص من التخصصات. ومن الواضح أن المؤسسات التعليمية تقدم معلومات كثيرة لا يحتاجها الطالب في حياته العلمية، كما أن تلك المعلومات تفقد أهميتها مع مرور الوقت بسبب تقادمها، أو تحول الانتباه عنها.
ومن وجه آخر فإن المتعلمين - ولا سيما المراهقين - يرغبون دائماً أن يروا عائداً اجتماعياً أو اقتصادياً على ما يبذلون الجهد في تعلمه، ومن الواضح أنهم لا يشعرون بشيء من ذلك خلال فترة الدارسة الطويلة.
قد يكون التعليم المستمر هو الحل لكل هذه المشكلات، وذلك من خلال تقصير مدة الدراسة النظرية، وجعل الشباب ينخرطون في الأعمال البحثية والمهنية والحياتية المختلفة. وخلال العمل يتم إيجاد آلية لتنشيط معلوماتهم السابقة، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي يتطلبها مجال العمل الذي يعمل فيه الواحد منهم. وهذا يتطلب نوعاً من الالتحام والتنسيق الجيد بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية المختلفة. وإن بإمكان النظم والتشريعات والحوافز أن تدفع الشباب دفعاً إلى الاستمرار في التعلم والتدرب لتلبية متطلبات النجاح في العمل الذي يمارسونه. ومهما أدت هذه الطريقة إلى حرمان الشباب من بعض المعلومات النظرية، فإنها ستتيح لهم الكثير من المعلومات والخبرات العملية المنتجة.
وبإمكان وسائل التثقيف المختلفة أن تعوض عن النقص المتأتي بسبب تقصير مدة الدراسة النظرية.
إن المقصود هو تفتيت تلك الكتل الهائلة من طلاب المراحل المتوسطة والثانوية، وتوزيعها في وقت مبكر على المجالات الإنتاجية؛ لتتلقى بعد ذلك من المهارات والمعارف ما تميل إليه، وما هو ضروري لتجويد أدائها المهني، والذي سيعني تردداً دائماً على مصادر المعرفة والمعلومات.
4- إن وضع كثير من الدول والشعوب الإسلامية، يدعو إلى الدهشة والعجب؛ حيث إن لدى الناس جهلاً عريضاً في كل شيء، كما أن كثيراً من المؤسسات التعليمية لديهم، تعمل بنصف طاقتها، فهي مغلقة في النصف الثاني من النهار؛ بالإضافة إلى أعداد هائلة من المساجد، معطلة معظم الوقت. وإلى جانب كل هذا هناك أعداد كبيرة من العلماء والمثقفين ذوي الخبرات والكفاءات العالية والذي لا يجري الانتفاع بهم؛ أي: أننا مصابون بأدواء الجهل العديدة، وعندنا كل أدويته وربما كانت المشكلة في عدم إحساس المريض بمرضه، وعدم حرص الطبيب على القيام بمسؤولياته، وعدم وضع نظام للجمع بينهما!!
إن من العسير أن نوجد مجتمعاً، هو أقوى من مجموع أفراده، وإن المكانة المتدنية التي نحتلها بين الأمم، ما هي إلا انعكاس طبيعي لتدني الوضعية العامة لأكثر أفراد الأمة؛ وإن المطلوب اليوم حركة ثقافية موّارة، تنهض بكل جوانب الحياة، ولن يأتي ذلك إلا من خلال ملاحظة أوجه القصور، ثم إتاحة الفرص لتلافيها ومعالجتها من خلال المناهج والبرامج والدراسات واللقاءات التي تحسن من مستوى معرفة الناس في مجالات الحياة كافة.
وعلى سبيل المثال فحين نرى مشكلة (الطلاق) تتفاقم في مجتمع من مجتمعاتنا، فإن دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية، يتجلى في إقامة برامج عديدة حول الزواج والحياة العائلية، وإجراء بحوث ودراسات مسحية حول حجم الظاهرة، والأسباب الفاعلة في تفاقمها. وقد يقتضي الأمر سن قانون، يجعل المرور ببرنامج حول الحياة الأسرية شرطاً لإتمام عقد النكاح، كما هو الشأن الآن في (ماليزيا).
وحين نرى جهلاً لدى التجار في فقه المعاملات، فإن علينا أن نعقد لهم دورات تثقيفية في ذلك.
وإذا رأينا هدراً في استخدام الطاقة أو المياه أو الأثاث. فإن الأمر يقتضي أن تنشط الجمعيات النسائية في تثقيف النساء في الاقتصاد المنزلي، وتدبير شأن المعيشة ومسائل الأمومة والطفولة.
وإذا وجدنا مجتمعنا مبتلى بالعصبية والتحزب والإعجاب بالرأي والضيق بالمخالف، فإن علينا أن نوفر له ثقافة حية يتعاظم من خلالها وعي الناس بأصول الحوار وأدب الخلاف وأسبابه الموضوعية، وأهمية تنمية الأشياء المشتركة، وهوامش تعدد الرأي والتعاذر بين المختلفين.
إن التعلم المستمر ليس شكلاً من أشكال الرفاهية، وإنما هو آلية لمواجهة مصاعب الحياة، والتخفيف من المشكلات والتوترات التي تنجم عن اجتماع الناس بعضهم مع بعض. وهو لن يترسخ في حياتنا من خلال الحذلقة الكلامية، وإنما من خلال سن التشريعات، وإتاحة الفرص، وتنظيم الأطر، وتهيئة الأجواء التي تساعد الناس على أن يتعلموا ويرتقوا في معارج التحضر.
5- عند النظر في أحوال الناس وظروفهم ورغباتهم؛ فسوف نجد أن بينهم تبايناً كبيراً في ذلك: فمنهم من فاته قطار التعليم في الصغر، ومنهم من لم يدرس سوى المرحلة الابتدائية، ومنهم من درس تخصصاً لا يميل إليه، ولا يلائمه، ومنهم من وجد أن سوق العمل لم يعد بحاجة إلى تخصصه أو مهنته، وهناك من يعمل في النهار، وهو بحاجة إلى مؤسسة يتعلم فيها بالليل، وهناك وهناك ... مع كل هذه الظروف والأحوال؛ فإن مما يؤسف له أن ثقافة (التعلم المستمر) ما زالت هشة في مجتمعاتنا؛ مما يعني أن جهوداً استثنائية، يجب أن تبذل حتى يتغير الحال.
إن مما سيساعد كثيراً من الناس في الاستمرار بالتعلم، وجود أشكال كثيرة من الأطر التعليمية، ووجود مرونة كبيرة في شروط القبول؛ حتى يجد كل من أراد أن يتعلم المؤسسة التي تقدم له ما يرغب في تعلمه.
يقول أحد مديري الجامعات الأوروبية الشهيرة بعد أن قام بجولة لزيارة مؤسسات التعليم العالي الأمريكي عام 1960: (في أمريكا كلية لكل فرد مهما كانت خلفيته أو قدرته الأكاديمية) (2). وهذه قولة حق؛ ففي الولايات المتحدة اليوم ما يزيد على 3800 جامعة وكلية ومعهد عال. وهذا العدد الضخم لا نظير له، ولا لما يدانيه في أي مكان من العالم. وتقدم تلك الجامعات والكليات من المعارف والتخصصات ما لا يخطر في بال كثير من الناس.
إن الجمود والنمطية هما السمة الأساسية لمؤسساتنا التعليمية في كل جانب من جوانبها على مستوى شروط القبول والبرامج والمناهج والشهادات الممنوحة وأوقات الدوام، فضلاً عن أن روح التعليم فيها خامدة؛ ولذلك فإن وفاءها بحاجات الناس ضعيف جداً، وعلى الناس أن يغيروا حياتهم إذا ما أرادوا دخولها!
المصانع والمؤسسات التجارية والشركات والجماعات والأحزاب والجمعيات والنوادي ... كل أولئك يغلب عليه طابع الربحية أو الدعاية، أو تقديم خدمات اجتماعية بحتة، وقلما تجد جهة منها حريصة على تحسين المستوى المعرفي للناس أو الارتقاء بمهاراتهم (3)، مع أن كل جهة منها قادرة على تقديم نوع من التعليم أو التدريب الذي يحتاجه بعض الناس.
في الجامعات والمدارس الإسلامية ضمور شديد في المكتبات والمختبرات ووسائل البحث العلمي، كما أن المكتبات العامة في كثير من الدول محدودة، والتزويد فيها ضعيف جداً؛ مما يجعل مقتنياتها من الأوعية المعرفية متقادمة.. ومع أن أهل الثراء في بلاد المسلمين كثر إلا أن إسهاماتهم في دعم المكتبات العامة والمؤسسات والأنشطة العلمية محدودة جداً، على خلاف ما هو موجود في العالم الصناعي - ولا سيما أمريكا - حيث يقدم الأثرياء هناك هبات سخية لدعم الجامعات ومراكز الأبحاث والمكتبات (4).
في الدول المتقدمة أيضاً هناك الكثير من المؤسسات التي تدعم التعليم المستمرة ومن النماذج المضيئة في ذلك ما قام به الفرنسيون من إنشاء مؤسسة غير حكومية، من نوع جديد تسمى (جامعة الحلقة الثالثة من العمر) يدرس فيها كبار السن. ومنذ عام 1973، وخلال سبع سنوات تم إنشاء خمسين مؤسسة أخرى في ربوع فرنسا (5).
6- إن تدفق المعلومات، وإتساع دوائر النشر، وتوفر وسائل الاتصال، إن كل ذلك يمثل أدوات ممتازة لدعم التعلم المستمر والملاحظ أن الاستفادة من الوسائل الإعلامية المتاحة في عمليات التعليم المختلفة - ضعيفة جداً، فالصحف والجرائد المتخصصة قليلة جداً، كما أن أكثر الدول الإسلامية، لا تملك محطات تلفازية متخصصة ببث البرامج التعليمية، بل إنه ليس هناك - في أكثر الدول - إذاعات تعليمية مع انخفاض تكاليف البث الإذاعي نسبياً! وأكثر ما يبث وينشر يقدم ثقافة عامة، ولا يستهدف خاصة من الناس، مما يجعل الأكثرية يشعرون بضعف الاستفادة منه.
إن شبكات المعلومات الآخذة في النمو والانتشار السريع، إلى جانب الأقمار الصناعية هي من الوسائل المثلى في نشر المعرفة المركزة والممنهجة، والتي تستهدف فئات معينة من الناس مثل الطلاب والأساتذة وربات البيوت وكبار السن والعمال والفلاحين. كما أن بإمكان كل جريدة أن تخصص نصف صفحة لتقديم برنامج دراسي، أو مادة علمية معينة، أو إصدار ملحق بذلك.
لا ريب أن هناك ظروفاً ومشكلات عديدة تصرف الناس عن متابعة تثقيف أنفسهم، كما أن هناك قصوراً في أطر التثقيف ووسائله، إلا أن العقبة الكأداء، هي فقد الأغلبية من المسلمين لفضيلة (الاهتمام) بهذه المسألة الحيوية والمصيرية؛ فالأوقات والأموال موجودة، وكثير من الوسائل موجود إلا أن المفقود هو الاهتمام بتوظيفها، والمنهجية المطلوبة للاستفادة منها!
إن أكثرنا انشغالاً يستطيع أن يجد نصف ساعة لتثقيف نفسه. ونصف ساعة يومياً ليس بالشيء القليل، فهي كافية إذا ما وظفت في قراءة مادة من المواد مدة خمس سنوات لجعل القارئ أستاذاً في تلك المادة. وبإمكان الفقير أن يضغط على مصروفه لتوفير ثمن كتاب أو مجلة للارتقاء بمعرفته ... إن الممكنات كثيرة جداً، لكن المشكلة في ضعف الهمة، وفقد النفس التواقة!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بحوث مؤتمر التعليم الأساسي: 63.
2ـ أزمة العالم في التعليم من منظور الثمانينيات: 98.
3ـ بدأت الصورة تتغير في بعض البلاد الإسلامية، وإنا نأمل أن تمضي جميع المجتمعات الإسلامية في الطريق إلى آخره.
4ـ نشرت إحدى المجلات الأمريكية أن إجمالي التبرعات الخيرية الأهلية في أمريكا عام 1996 (151) بليون دولار! وقد ذهب من هذا المبلغ ما نسبته 46% للمؤسسات والأغراض الدينية، و13% للتعليم، و9% للصحة. مجلة المعرفة العدد 32، ص 187.
5ـ أزمة العالم في التعليم: 87.
 الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











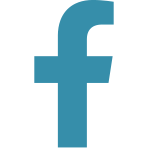
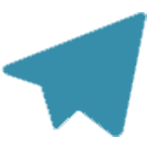
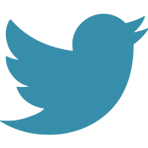

 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)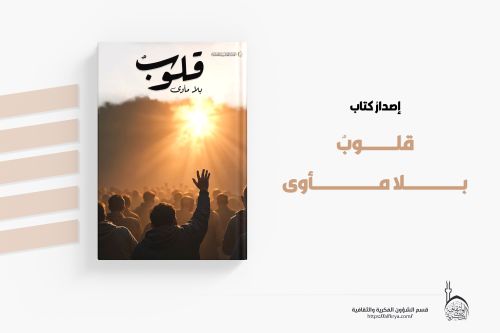 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)